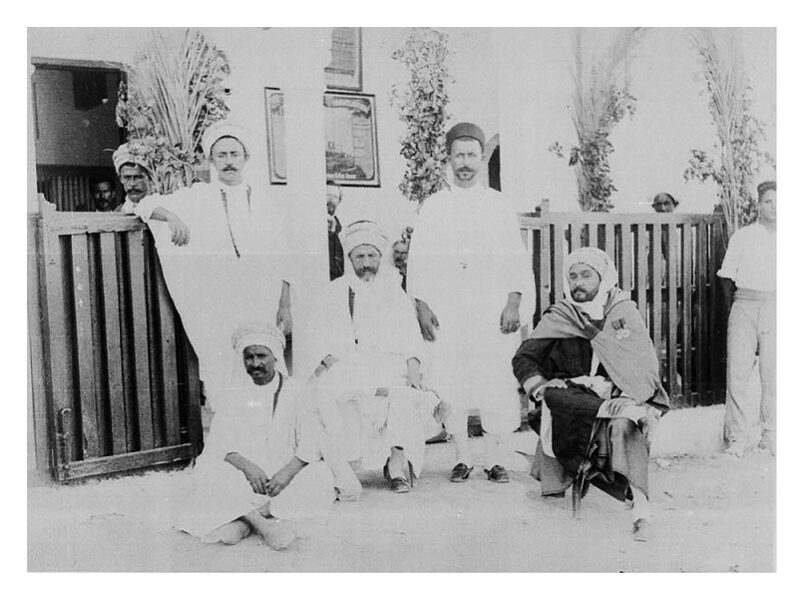تعطي أغلب التقييمات – الإيجابية منها والسلبية – للأداء الاقتصادي لنظام بن علي انطباعاً بأنّ سنوات حكمه الطويلة هي فترة واحدة متجانسة تماماً من اليوم الأوّل إلى اليوم الأخير، والحال أنّها فترات حكم تختلف ملامحها حسب السياق المحلّي والعالمي. يتّفق الجميع تقريباً – حتّى الذين يحنّون إلى الأيّام الخوالي – على أنّ الفساد والمحسوبيّة كانا من السمات الغالبة على الاقتصاد التونسي في عهد بن علي. حتّى أنّ الكثير من المحلّلين والخبراء والناشطين السياسيين يتحدّثون عن “اقتصاد رَيْعيّ” يعتبرونه السبب الرئيسي لتخلّف الاقتصاد التونسي وتدهور الأوضاع الاجتماعية. وأصبحت عبارة “الاقتصاد الريعيّ” تحظى برواج مُدهش في السنوات الأخيرة وافتكّت مكاناً بارزاً في القاموس السياسي والإعلامي في تونس. كأنّها الكلمة المفتاح لفهم أسباب تأزّم اقتصادي-اجتماعي متواصل منذ ثمانينيّات القرن الفائت. لكن هل كان الاقتصاد في عهد بن علي ريعيّاً بالأساس؟
1- من رأسماليّة الدولة إلى رأسماليّة المحاسيب
بدأ حكم بن علي على أنقاض عالم قديم – سقوط جدار برلين وانهيار الاتّحاد السوفياتي – وانتهى مع إرهاصات ولادة عالم جديد. وبين لحظة الصعود والسقوط، شهد البلد والعالم متغيّرات كبيرة جدّاً على مختلف المستويات. يمكن أن نقسم سنوات هذا الحكم إلى ثلاث فترات أساسية:
الفترة الأولى، 1988-1995: مرحلة تركيز الدعائم
لم يخترْ بن علي، الذي صعد إلى سدّة الحكم في نوفمبر 1987 – إثر الانقلاب “الطبي” على بورقيبة – بدون سند شعبي أو “ظهر” سياسي أو تاريخ نضالي، سياسة القطيعة الكاملة مع الماضي بل اختار الاستمراريّة والمهادنة والتغيير البطيء. وعلى الرغم من خلفيّته الأمنية-العسكرية كان يعرف جيّداً أنّه لن يستطيع تركيز دعائم حكمه بالعصا والقمع فقط، وأنّه يجب أن يحظى بدعم أجنبي وولاء الفئات الأكثر نفوذاً محلّياً وشراء صمت قطاعات واسعة من المجتمع. وهذا كلّه يتطلّب سياسات وتوازنات اقتصادية اجتماعية معيّنة. بدأ بن علي بالسيطرة على منظّمة أرباب العمل (الاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة)، وإغراء الرأسمال المحلّي والأجنبي بمجلّة استثمارات مرنة ومحفّزة (ديسمبر 1993)، واستمالة اتّحاد الشغل عبر حلحلة الأزمة التي بدأت في جانفي 1978 واستمرّت لعشر سنوات. وعلى المستوى الاجتماعي، سعى النظام إلى تحسين المقدرة الشرائية للطبقات الوسطى وتسهيل تحقيق “أحلامها” الاستهلاكية. كما بعث في ديسمبر 1992 “صندوق التضامن 26-26” وأطلق مشاريع أخرى كان يُفترض أن تُحسّن الظروف المعيشية والحياة الاقتصادية والبنى التحتية في المناطق المهمّشة (“مناطق الظلّ”). أمّا على المستوى الخارجي، فقد اختار نظام بن علي سياسة “التلميذ النجيب” و”الشريك” الطيّع مع المؤسّسات المالية الدولية والشركاء الاقتصاديين الأوروبيين. سار قدماً في إنجاز “برنامج الإصلاح الهيكلي” الذي فرضه “البنك الدولي” في 1986 كشرط لتمكين تونس من قروض ضخمة تُخرِجُها من أزمتها الاقتصادية. والتحق في 1990 باتّفاقية “الغات” قبل أن ينضمّ في 1994 إلى منظّمة التجارة العالمية ويوقّع في 1995 اتّفاقية شراكة وتبادل حرّ مع الاتّحاد الأوروبي. شهدت هذه الفترة الموجة الأولى من خصخصة المؤسّسات العمومية والمرحلة الثانية من تقليل تدخّل الدولة في الاقتصاد وضخّ الأموال في مشاريع استثمارية (بعد انفتاح 1972)[1].
كان النظام يعي جيّداً أنّ السير نحو اقتصاد السوق بسرعة كبيرة سيُحدث قلاقل كبيرة تهدّد عوده الطريّ. لذا لم يقلّص النفقات الاجتماعية بشكل كبير ولم يخصخص المؤسّسات الأكثر ربحيّة، بل المتعثّرة وضعيفة المردوديّة.
الفترة الثانية، 1996-2001: التأهيل
أقرّت الدولة في 1996 برنامج “التأهيل الصناعي” لتحضير المؤسّسات التونسية للمنافسة المُنتظَرة بعد انخراط البلاد في منطق “اقتصاد السوق” والتبادل الحرّ. وقد شمل البرنامج قرابة 2000 مؤسّسة صناعية خاصّة كبرى ومتوسّطة وصغرى خلال الفترة الممتدّة بين 1996 و2001، وحظي بتمويل من الاتّحاد الأوروبي. ويبدو أنّ النظام التونسي لم يرَ في هذا البرنامج فرصة لعصرنة الاقتصاد فقط، بل باباً من أبواب دعم سلطته على أصحاب الأعمال بمراقبة مؤسّساتهم “من الداخل” وإغرائهم بالمنح والتمويلات[2]. في هذه الفترة، سعتْ السلطة الحاكمة إلى “تأهيل” الاقتصاد للمرور إلى السرعة القصوى من الانفتاح والتحرير. فأطلقت موجة ثانية من الخصخصة عبر التفويت الكلّي أو الجزئي في مؤسّسات عمومية منتجة ومربحة على غرار معامل الإسمنت والبنوك، أو السماح للمستثمرين الخواصّ بالدخول إلى مجالات إنتاجية وخدماتية كانت تحتكرها الدولة. كما تمّ إقرار جملة من المراسيم والقوانين والتراتيب بهدف ضمان “مرونة” اليد العاملة كشركات المناولة وعقود العمل قصيرة المدى وغيرها من أشكال التشغيل الهشّ. وفي 2001، صدر قانون الشركات القابضة “هولدينغ” (القانون 117 لسنة 2001)، ومعه مراسيم وتنقيحات عدّة بهدف إلغاء رخص وشروط مفروضة على الاستثمار وجنسيّته وقيمته في بعض الأنشطة الاقتصادية. هذه السنوات ستسجّل بوادر ظواهر سيكون لها آثار كبيرة لاحقاً: بداية سيطرة “الطرابلسية” – عائلة زوجة الرئيس – على القصر الرئاسي وتطوّر نفوذهم في القرار السياسي والإداري والحياة الاقتصادية، ظهور طبقة من الأثرياء الجدد في وقت وجيز جدّاً، تزايد الاستثمار الأجنبي في القطاعات الخدماتية والمالية ذات الربحيّة العالية والطاقة التشغيلية الضعيفة، بداية تحوّل التهريب إلى نشاط شبه علني، تزايد نسبة المشتغلين في قطاعات الاقتصاد غير المهيكل، تنامي بطالة الشباب بشكل شمل حتّى حاملي الشهادات الجامعية، تراجع الانتداب في الوظيفة العمومية، تراجع نسبة النفقات الاجتماعية العمومية في الميزانية، انغلاق باب الهجرة النظامية بسبب السياسات الأمنية للقلعة أوروبا ممّا أوجد ظاهرة “الحرقة” (الهجرة غير النظامية)…
الفترة الثالثة، 2002-2010: تخلخل الدعائم
في المرحلة الأخيرة من الحكم الديكتاتوري، بدأ نظام بن علي يحصد ما زرعه سلفه، وسقاه ورعاه بنفسه. تراجع دور الفلاحة والصناعة الثقيلة في التشغيل بشكل كبير جدّاً وتغوّل القطاع الخدماتي نظراً إلى ربحيّته وتشجيع الدولة على الاستثمار فيه. كما تآكلت الموارد العمومية بسبب التفويت في مئات المؤسّسات العمومية وحرمان خزينة الدولة من مداخيل جبائية أسقطتها اتّفاقيات التبادل ومحفّزات الاستثمار، وتنامتْ نسب الفقر بسبب تقلّص الإنفاق العمومي وارتفاع نسب البطالة وتدنّي الأجور والغلاء المطّرد للأسعار المتأتّي عن الرفع التدريجي للدعم وإعطاء السوق حرّيّة أكبر في تحديد الأسعار. السنوات الأخيرة من عهد بن علي شهدتْ كذلك تغوّل “رأسمالية المحاسيب” وما يعنيه ذلك من تطوّر حجم الفساد والنهب وإهدار الموارد العمومية. هذا وانتهى العمل باتّفاقية “الألياف المتعدّدة” في سنة 2005، التي كانت تضمن لتونس حصّة ثابتة من صادرات النسيج في العالم ممّا أثّر تدريجياً على أحد أهمّ القطاعات الإنتاجية في تونس. بداية الألفية الثالثة عرفتْ أيضاً ارتفاعاً كبيراً في أسعار المحروقات في العالم، تزامناً مع تراجع كبير في الإنتاج المحلّي وقد نتج عنهما تطوّر كلفة العجز الطاقي ونزيف العملة الصعبة. أمّا اتّفاقيات التبادل الحرّ مع الاتّحاد الأوروبي وتركيا وتطوّر ظاهرة التهريب “المنظّم” و”العشوائي” لحاويات البضائع الصينية فستُغرق السوق التونسية تدريجياً بسلع أجنبية خنقتْ المنتجات التونسية ذات القدرة التنافسية الضعيفة. وتزامناً مع كلّ ما سلف ذكرُه، أدّت خصخصة الصناعات والأنشطة المرتبطة بالبناء إلى رفع أسعارها. كما ولّد إطلاق يد المضاربين في العقارات أزمة سكن لدى الطبقات الوسطى والشعبية، بخاصّة مع تراجع برامج الإسكان الاجتماعي. كما أنّ تطوّر حجم الاقتصاد غير المهيكل، وإن قدّم حلولاً جزئية وهشّة لمعضلة البطالة، قد ساهم في تراجع المداخيل الجبائية للدولة وشكّل منافسة لبعض القطاعات الاقتصادية المهيكلة. السنوات الأخيرة لحكم بن علي شهدتْ أيضا تفاقم ظاهرة الديون البغيضة التي تذهب لخدمة فئات قليلة من أصحاب الامتيازات مقابل تضخّم نسبة الدين العمومي وتكلفة خدمة الدين.
2- هل كان الاقتصاد زمن بن علي ريعياً؟
كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن العائلات التونسية السبع أو العشر أو العشرين التي أثّرتْ بشكل فاحش في عهد بن علي وسيطرت على مفاصل الاقتصاد التونسي. نتحدّث هنا عن أبرز المؤسّسات/المجمّعات الاقتصادية في تونس: مجموعة المبروك، مجمّع بن عيّاد (بولينا القابضة)، مجمّع حمدي المدبّ (دليس القابضة)، مجمّع اللومي، مجمّع البياحي، مجمّع البوشماوي، مجموعة الوكيل، مجمّع السلامي، مجموعة الأمان بن يدر، مجمّع المهيري (المرادي-موبلاتاكس)، مجموعة عبد الناظر، مجموعة المزابي، مجمّع إدريس السياحي، عائلة عزيز ميلاد، شركة صنع المشروبات بتونس، إلخ. تضاف إليها مجموعتا الكرامة القابضة (الأميرة هولدينغ سابقاً) التي كانت مملوكة لصخر الماطري، زوج ابنة بن علي، ومجموعة كارتاغو القابضة التي كانت مملوكة لبلحسن الطرابلسي، أخ أرملة بن علي ليلى الطرابلسي، وعشرات المجمّعات/العائلات الأصغر حجماً والتي نمتْ في ظلّ العائلات التقليدية أو أصهار الرئيس.
هذه العائلات/المجمّعات تمتلك مُجتمِعةً مئات المؤسّسات، أغلبها مصنّفة كبرى، وتُشغِّل مئات الآلاف من التونسيين وتتحكّم في أغلب البنوك وشركات التأمين ووكالات ماركات السيارات العالمية، المغازات الكبرى، المنشآت السياحية، الصناعات التحويلية، وشركات الاتّصالات والإنترنت والأدوية.
هذا التغوّل لبضع عائلات يجعل الكثير من الخبراء الاقتصاديين والناشطين السياسيين والمدنيين، وحتّى الصحافيين، يستعملون عبارة “اقتصاد ريعي” لتوصيف السياسات والسلوكيّات الاقتصادية خلال فترة حكم بن علي. ولا يُقصَد هنا بالريع المفهوم التقليدي للاقتصادات القائمة على عائدات منتج واحد أو منتجات قليلة، التي تكون أساساً من المحروقات والصناعات الاستخراجية، كما هي الحال في دول الخليج العربي وبعض دول المنطقة المغاربية، بل نظام امتيازات ورخص يتحكّم فيه النظام السياسي لتسهيل احتكار المقرّبين منه، وواجهاته، للقطاعات الاقتصادية الأكثر ربحيّة والتغلغل في مفاصل الاقتصاد. من هذا المنطلق، يمكن الجزم بأنّ الاقتصاد في عهد بن علي كان في بعض أوجهه ريعياً موجَّهاً لخدمة مصالح أقليّة. لكن يجب تنسيب الأمور فسياسات النظام وتوجّهاته كانت أكثر تعقيداً.
في سبعينيّات القرن العشرين، نشأ ما يشبه الحلف بين مجموعة رأسماليين صغار والدولة. تقدّم هذه الأخيرة الدعم والتسهيلات المالية والجبائية، وحتّى العلاقات الديبلوماسية ومفاتيح الأسواق الخارجية للرأسماليّة الناشئة مقابل أن تنسجم هذه الأخيرة مع السياسات الحكومية العامّة، أي أن تستثمر في قطاعات معيّنة حسب مخطّطات وأولويّات الدولة. تنامتْ تدريجياً ثروات هؤلاء الرأسماليين الصغار، وتنوّعت الأنشطة التي يستثمرون فيها، وتشابكتْ علاقاتهم مع كبار الإداريين والمسؤولين السياسيين. ومع المرور إلى مرحلة جديدة من الانفتاح على اقتصاد السوق أواخر الثمانينيّات/بداية التسعينيّات، كان من الطبيعي أن يكونوا هم المستفيدين الكبار من خصخصة المؤسّسات العمومية وتراجع رأسماليّة الدولة وحضورها في الاقتصاد. فمن جهة، هم يمتلكون الخبرة والعلاقات في الداخل والخارج التي تمكّنهم من السبق في الحصول على المعلومات الحسّاسة واستشراف نوايا السلطة، ومن جهة أخرى لديهم القدرة على توفير التمويل اللازم للاستحواذ على المؤسّسات المعروضة للتصفية أو إنشاء مؤسّسات خاصّة جديدة. وهناك عامل آخر كثيراً ما يتمّ تجاهله عند الحديث عن الريع: السوق التونسية صغيرة ومحدودة، القدرة الشرائية لعموم التونسيين متدنّية، وأغلب المنتجات التونسية – وهي أساساً موادّ فلاحية وصناعات خفيفة – غير تنافسيّة على المستوى العالمي. يخلق هذا الواقع وضعيّة شبه “منطقية”: مَن بادر إلى الاستثمار في قطاع معيّن وصنع اسماً لماركاته ومنتجاته، وكذلك من تحصّل مبكّراً على شراكات ونيابات مع ماركات ومؤسّسات عالمية تصعُب منافسته من المستثمرين الذين يأتون من بعده، حتّى لو كانت قوانين الاستثمار تنافسية وغير حمائية.
زرع الأقفال و”مخفّضات سرعة” في بعض قوانين الاستثمار، وإخضاع بعض الأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية لتراخيص وأدوات حمائية أخرى خلال فترة حكم بن علي، ليس مجرّد خدمة لمنظومة ريعية تستفيد منها العائلات الحاكمة والمجمّعات الاقتصادية الكبيرة – وهذا كان أمراً واقعاً يظهر في العديد من الصفقات والشراكات والاحتكارات الفاسدة – بل كذلك أداة حكم وإدارة للشأن العامّ. فمن جهة تُمكِّن هذه الأقفال و”العقبات” النظام السياسي من إحكام هيمنته على طبقة الرأسماليين بشكل لا يسمح بتطوّرهم ونموّ ثرواتهم بدون موافقة الدولة و”رضا” السلطة، ومن جهة أخرى تعطي للسلطة قدرة أكبر على التحكّم في الأسعار بشكل يخفّف الضغط على المقدرة الشرائية للمواطنين و”ينفّس” الاحتقان الاجتماعي الذي يمكن أن ينفجر في أيّ وقت. كما أنّ ثمّة خدمات متبادلة بين الرأسماليين “الروّاد” ونظام بن علي، فهذا الأخير كان بحاجة إلى أصحاب أعمال تقليديين و”محترمين” يشكّلون الواجهة الخارجية للاقتصاد التونسي، ويسهّلون التعاملات المالية والتجارية مع “الشركاء” و”المموّلين” الأجانب بخاصّة مع تواتر الفضائح “الاقتصادية” للعائلات الحاكمة وطبقة الأثرياء الجدد، ويخلقون الثروة ويشغّلون العاطلين، وينمّون احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة، ويموّلون الحزب الحاكم وماكينة البروباغندا. في المقابل، ينال أصحاب الأعمال إعفاءات جمركية ومحفّزات استثمار ومِنحاً لتطوير مؤسّساتهم ودعماً – ظاهراً وخفياً – في ولوج الأسواق الخارجية، وقوانين شغل وضمان اجتماعي “مرنة”.
الوصف الأدقّ للاقتصاد التونسي تحت حكم بن علي هو “الزبائنيّة”
“ريعيّة” الاقتصاد زمن حكم بن علي لم تشمل فقط أصحاب الأعمال -“الروّاد” منهم و”محدثو النعمة” و”المافيوزيون” – بل شملتْ طبقات وفئات أخرى من المجتمع. استفاد مثلاً الكثير من أصحاب المهن الحرّة والحرفيين من النظام الضريبي التقديري الذي مكّنها من دفع مبالغ بسيطة مقارنة بالأرباح التي تغنمها. المؤسّسات المتوسّطة والصغرى استفادتْ من قوانين المناولة وعقود التشغيل الهشّة وتكفّل الدولة بخلاص جزء من مستحقّات حاملي الشهادات العليا المُنتَدَبين. صحيح أنّ القروض والتمويلات الكبرى كانت حكراً على العائلات الثرية، لكنّ الطبقات الوسطى التي تعمل في الوظيفة العمومية أو في مناصب رفيعة في القطاع الخاصّ كانت تحصل على قروض بناء واستهلاك بحكم استقرار أوضاعها (شغل قارّ وبطاقات خلاص) في حين كانت قطاعات واسعة من المجتمع تُحرَم من هذه التمويلات لأنّها لا تمتلك مشاريعَ أو وظيفة ثابتة. هذه الطبقات حظيتْ كذلك بفرصة اقتناء سيّارات “شعبية” بأثمان مُخفَّضة. التونسيون في الخارج تمتّعوا وما زالوا بإجراءات تمنحهم إعفاءات جمركية – لا يتمتّع بها تونسيو الداخل – عند توريد السيّارات والعديد من السلع، فضلاً عن العروض الاستثمارية والتمويلية التي توفّرها لهم مؤسّسات عمومية وبنوك عدّة. حتّى الطبقات الأكثر فقراً، بخاصّة في المناطق الداخلية، كان يصلها النزر القليل من هذا “الريع” عن طريق مشاريع “مناطق الظل” و”صندوق 26-26″ إمّا كبنى تحتية في المنطقة، أو جمعيّات مائية، أو وظائف أو مساعدات عينية مباشرة، وطبعاً كل هذا تحت إشراف “شُعَب” ولجان تنسيق “التجمّع الدستوري الديمقراطي”.
معادلة الانغلاق السياسي والانفتاح الاقتصادي لا تنتج إلّا رأسمالية محاسيب وزبائن
ربّما يكون الوصف الأدقّ للاقتصاد التونسي تحت حكم بن علي هو “الزبائنيّة”: منافع قليلة أو كثيرة مقابل الولاء أو على الأقلّ الصمت. قطاعات كثيرة من التونسيين انتفعت بامتيازات مختلفة الشكل والقيمة، بخاصّة خلال تسعينيّات القرن الماضي، وهذا ما سهّل على النظام حينها ضمان “هدوء” وحتّى “خنوع” غالبيّة المجتمع رغم القمع وتكميم الأفواه واستشراء الفساد. فالعصا الأمنية لا يمكنها منفردةً أن تخضع الجميع لفترة طويلة، إذ يجب ملء البطون – ولو قليلاً – ولا بأس ببعض الترفيه. “خبز وألعاب”، كما كان يُقال في روما. لم يخترع نظام بن علي العجلة، بل استعان بوصفات قديمة وبعض التوابل الجديدة، ليُراوح بين الترغيب والترهيب، ويحاول توريط أكبر عدد ممكن من المواطنين في شبكاته الزبائنية مع التركيز على الفئات الأكثر نفوذاً مالياً ومعنوياً.
معادلة الانغلاق السياسي والانفتاح الاقتصادي لا تنتج، آجلاً أم عاجلاً، إلّا رأسماليّة محاسيب وزبائن للنظام السياسي. لكن، مع استمرار سير النظام في “إصلاحاته” النيوليبرالية التي يفرضها عليه “المموّلون” و”الشركاء” الأجانب في الخارج، ويضغط من أجلها أصحاب أعمال الداخل، تتهاوى تدريجياً موارد الدولة والنظام ويصبح إرضاء جميع “الزبائن” أمراً صعباً، فتتقلّص قائمة المستفيدين ويزداد جشع “الكبار” على حساب من تحتهم فتحتقن الأوضاع وقد تنفجر.
3- صحوة ضمير متأخّرة أم ساتر دخاني؟
“الدعائم” التي ركّزها بن علي في أولى سنوات حكمه وسندته طويلاً سقطتْ عليه بعد أن تآكلت تدريجياً ولم يفعل شيئاً لترميمها. فمصيره كان “محتوماً” تقريباً ولو أمسك شخصٌ آخر مكانه بشروط المعادلة نفسها فلم يكن مصيره ليختلف كثيراً. تبنّي سياسات اقتصاد السوق وإطلاق يد القطاع الخاصّ المحلّي والأجنبي وضرب المكتسبات الاجتماعية والقطاعات الإنتاجية الحيوية لبلد صغير غير مصنِّع ومحدود الموارد والنفوذ، في ظلّ نظام قمعي لا يسائله ولا يحاسبه أحد على الخلط بين الدولة والحزب الحاكم والمزرعة الخاصّة، فكيف يمكن مع كلّ هذا توقّع “نهايات سعيدة”؟
لكنّ سقوط الديكتاتورية والإبقاء على نفس الخيارات الاقتصادية لا يغيّر الأمور كثيراً، بل قد يبلغ منسوب الفساد و”الريعية” حدوداً خياليّة في ظلّ نظام “ديمقراطي” تسيطر عليه رؤوس الأموال المحلّية والأجنبية ويخدمها سياسيون طيّعون وإعلاميون مرتزقة و”خبراء اقتصاديون” دجّالون ونقابيون فاسدون. ولعلّ ما عاشته وتعيشه تونس منذ 2011 أبرز مثال على ذلك.
“اقتصاد الريع” وضرورة تفكيكه أصبحت من اللازمات في خطاب “المانحين” و”الشركاء” الاقتصاديين الغربيين لتونس، وعلى رأسهم البنك الدولي[3] والاتّحاد الأوروبي. لكن قبل كلّ شيء، هل يحقّ فعلاً لهؤلاء المانحين والشركاء أن يشتكوا من فساد ومحسوبيّة وريعيّة الاقتصاد التونسي في عهد بن علي؟[4] مَن الذي كان يلمّع صورة النظام الديكتاتوري التونسي في المحافل الدولية ويشيد بـ “الاستقرار” الاقتصادي والاجتماعي في تونس و”المعجزة التونسية”؟ من الذي فرض “لَبْرَلَة” الاقتصاد وخصخصة المؤسّسات العمومية على بلد فقير؟ ما هي الجنسيّات التي استفادت أكثر من تحفيزات الاستثمار الأجنبي وتسهيل الاستحواذ على المؤسّسات العمومية؟ مَن كان يوقّع شراكات وعقود ووكالات مع هذه العائلات نفسها التي تُتّهم اليوم بأنّها تتحكّم في الاقتصاد التونسي وتُغلق باب المنافسة أمام الوافدين الجدد؟ مَن كان يصيغ تقارير إيجابية حول مناخ الأعمال في تونس ويشيد بتنافسيّة اقتصادها؟ مَن الذي كان يمنح قروضاً لنظام يعلم الجميع أنّه فاسد وناهب لثروات بلاده؟
“صحوة الضمير” المتأخّرة هذه، أقلّ ما يقال عنها أنّها مريبة بخاصّة أنّها تتزامن مع ضغوط كبيرة يسلّطها البنك الدولي لتحرير الاقتصاد أكثر في تونس، وتعثُّر المفاوضات حول “اتّفاقية التبادل الحرّ الشامل والمعمّق” بين الاتّحاد الأوروبي وتونس بسبب ضغط المجتمع المدني وبعض القوى السياسية، إضافة إلى الكثير من أصحاب الأعمال (بعضهم من أبناء العائلات الاقتصادية الأكبر والأكثر نفوذاً). هل هي حرب على “الريع” أم ابتزاز للعائلات الاقتصادية النافذة وللبيروقراطية التونسية؟ قد تكون أيضاً مناورة جديدة لقطع يد الدولة وتصفية ما تبقّى لها من تأثير في الاقتصاد كقوّة ضبط وتعديل، وعلى الأرجح ساتر دخاني يحجب الرؤية عن الأسباب العميقة للأزمة الاقتصادية في تونس: سياسات نيوليبرالية، استقالة الدولة، تفاوت جهوي، دعائم هشّة لاقتصاد خدماتي، تآكل السيادة الوطنية واحتكار الثروة.
نشرت هذه المقالة في العدد 24 من مجلة المفكرة القانونية – تونس: الريع المُخضرم
1 Chamkhi Fathi, “Tunisie: La politique de privatisation”. CONFLUENCES Méditerranée – N° 35 AUTOMNE 2000
2 لفهم أعمق لطبيعة العلاقات بين رؤوس الأموال والسلطة السياسية خلال فترة حكم بن علي ننصح بقراءة الدراستَيْن التاليتَيْن للباحثة الفرنسية بياتريس هيبو:
Hibou Béatrice, La force de l’obéissance. Économie politique de la répression en Tunisie. La Découverte, « TAP / Hors Série », 2006
Hibou Béatrice, « Nous ne prendrons jamais le maquis ». Entrepreneurs et politique en Tunisie », Politix, 2008/4 (n° 84)
3 تحليل للمغالطات التي يروّجها البنك الدولي: Ben rouine Chafik « All in world bank », Manipulations au nom de la dérégulation”. L’Observatoire Tunisien de l’Economie (OTE), 2015.
4 عن تأثير سياسات المؤسّسات الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: Alriza Fadil, “L’impact et l’influence des institutions financières internationales sur le moyen-orient et l’afrique du nord”. Etude éditée par la Friedrich Ebert Stiftung en 2013