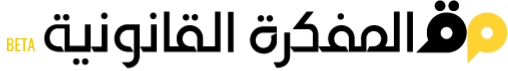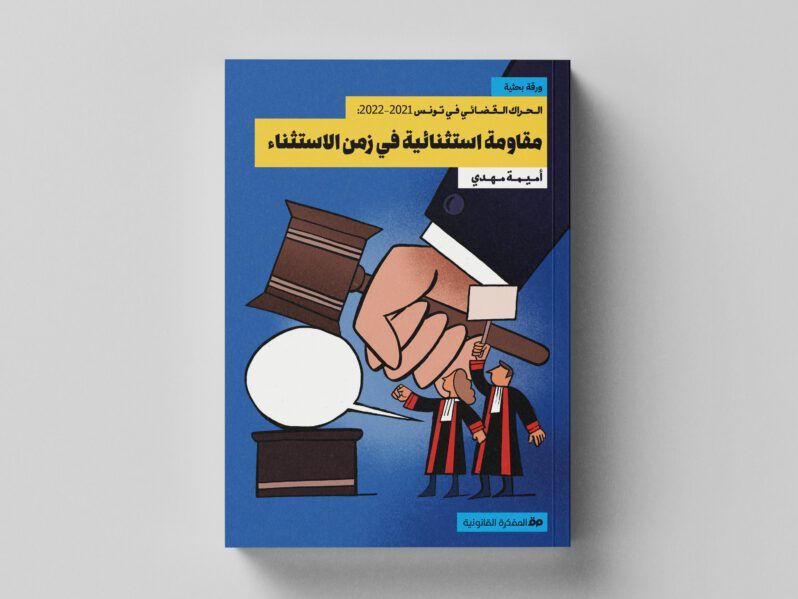أصدرت المفكرة القانونية في جوان/حزيران 2024 ورقة بحثية بعنوان “الحراك القضائي في تونس 2021-2022: مقاومة استثنائية في زمن “الاستثناء”، من إنجاز الباحثة أميمة مهدي. تهدف الورقة إلى المساهمة في توثيق وتحليل الحراك الذي خاضه القضاة دفاعا عن استقلالية السلطة القضائيّة، إزاء هجمات السلطة التنفيذية منذ 25 جويلية 2021، من خلال الوقوف على أهمّ فاعليه وتسلسل أحداثه ودينامياته الداخلية وتفاعلاته مع مختلف المتدخّلين والسياق. وقد ارتأينا نشرها بطريقة مجزّئة على الموقع لتسهيل الاطلاع على فحواها من قبل المتابعين والقرّاء. يتضمّن هذا الجزء الأول التمهيد الذي يذكّر بأهميّة الحراك القضائي 2021-2022 وسياقه ودوافع تناوله بالتحليل والمنهجيّة المعتمدة، متبوعًا بالقسم الأوّل الذي قدّم إضاءة تاريخية حول الحراكات القضائيّة في تونس منذ الفترة الاستعمارية. (المحرّر)
تمهيد
“أتوجه إليكم بهذه الرسالة لأعبر لكم عن سخطي ورفضي للأوضاع المريعة التي آل إليها القضاء التونسي والتي أدّت إلى تجريد السلطة القضائية والقضاة من سلطاتهم الدستورية وتحول دونهم وتحمل مسؤوليتهم كمؤسسة جمهورية مستقلة يجب أن تكفل لهم المساهمة في تحديد مستقبل وطنهم والاضطلاع الكامل بدورهم فى حماية الحقوق والحريات.”
القاضي مختار اليحياوي في رسالته الموجهة لبن علي
تونس في 06 جويلية 2001
بعد مرور ثلاث وعشرين سنة على نشر هذه الرسالة، يبدو أنّ صدى هذه الكلمات ما زال يطاردنا وأنّ وقع أثرها ازداد عمقا. إذ أنّ العبارات التي خطّها القاضي مختار اليحياوي بكلّ شجاعة للتعبير عمّا آلت إليه أوضاع السلطة القضائية تحت حكم الاستبداد، تبدو اليوم الأنسب لوصف حال القضاة والسلطة القضائية. ثلاث وعشرون سنة، تخلّلتها ثورة شعبية لم تشهد تونس مثلها من قبل، قلبتْ موازين القوى بين السلطة والشعب في أيام معدودة وطردت المعني بهذه الرسالة من كرسي الحكم. ثورة شقّتْ منظومة الحكم وبعثرتْ سلطتها الممركزة وقلبتْ المجتمع. ثورة تمسّكت بالقطع مع الماضي عبر ضغط الشارع ففَرضت نظامها الجديد ومؤسساتها المتعدّدة ونخبتها المختلفة فيما بينها. شكّل دستور 2014 نظاما جديدًا للحكم، كرّس الفصل بين السّلط، ونصّ على استقلالية السلطة القضائية واقتضى لها ضمانات مؤسّساتية وقانونيّة، وأوكل لها حماية الحقوق والحريات وعلوية الدستور وسيادة القانون.
لم يدمْ تطبيق الدستور الجديد سوى ستّ سنوات إلى حين قلب موازين الحكم مرة أخرى ولكن ممن كان على رأسها هذه المرة. مسار الانتقال الديمقراطيّ كما وقعت تسميّته، تخلّلته مطبّات عدّة أرهقت التونسيين. فقد عاشت تونس خلال العشر سنوات الماضية على وقع أزمات متعددة الأبعاد. أزمة أمنية ضربت البلاد والمنطقة ككلّ، فشهدت البلاد عمليات إرهابية متعددة واغتيال شخصيات سياسية. أزمة اقتصادية واجتماعية، تواصل تضخّمها في ظلّ سياسة التقشّف التي دمّرت المرفق العمومي وجسّدت استقالة الدولة من تقديم الخدمات الاجتماعية. أزمة صحية عالمية عمّقت ما سبقتها، ضيّقت الخناق على المواطنين وأدخلت الموت والفقدان على بيوتهم بعد أن أودت بحياة أكثر من 29 ألف ساكن. وأزمة سياسية متجدّدة بلغت أوجّها بعد انتخابات 2019. إذ أنّ هذه الانتخابات الاستثنائية أفرزتْ مجلسا نيابيّا فسيفسائيا غير قادر على تقديم حلول للأزمات المذكورة. كما أدخلت لاعبا جديدا صداميّا ومتمرّدا ليتصدّر المشهد السياسي التونسي وليتربّع منفردا على عرشه بعد عامين من انقضائها.
مع بلوغ الأزمات ذروتها خصوصا بعد أحداث جانفي 2021، والانسياق في حلقة مفرغة من الصّدام والفشل السياسيّ وسط صيحات الضحايا والمهمّشين، فُتح الباب شيئا فشيئا للتغييرات الراديكالية التي تعصف بالجميع. لم تحلّ إجراءات 25 جويلية أيّا من الأزمات، بل توّجت استثمارا متواصلا فيها، لتحويل وجهة تجربة ديمقراطيّة هشّة نحو مشروع فرديّ للرئيس، وغلق قوس الحريات الذي سئم منه الكثيرون، في الداخل والخارج. لم ينقلب الرئيس فقط على طبقة سياسيّة شغلتها صراعاتها الفردية عن دورها في فهم الواقع وتعقيداته وصياغة سياسات وبرامج لتغييره. بل انقلب على الدستور الذي أقسم على احترامه، وعلى فكرة الفصل بين السلط، ليَحتكر السّلطة تمهيدا لاحتكار السياسة.
إنّ 25 جويلية، وإن اختزلها الكثيرون في البداية في قرارات موجّهة ضدّ السلطات السياسية المتمثلة في الحكومة والبرلمان فقط، كعقاب لما لم يتحمّلوه من مسؤولية في حلّ الأزمات المذكورة، كانت تعني السطوة على كلّ السلطات من دون استثناء وتجميعها، بما في ذلك السلطة القضائية. وما كان قرار سعيّد المعلن ليلتها أمام مجلس الأمن القومي في ترؤّس النيابة العمومية إلاّ نبذة عمّا كان يترقّب السلطة القضائية من إرادة وضع اليد والتطويع في اتجاه الاستحواذ على السلطة كاملة من دون نقصان ولضمان استقرارها بالقبضة الواحدة. فلا سلطة تنافس السلطة المركزية المجمّعة بين يديْ قيس سعيّد، ولا وجود لسلطة مستقلّة تمارس صلاحياتها خارج نفوذ الرئاسة. وليس لمسار 25 جويلية أن يكتمل من دون تطويع القضاء تمهيدا لتطويع المجتمع والمعارضين خصوصا ووضع قرارات السلطة الجديدة خارج أي رقابة بما فيها القضائية.
إلا أنّ سعيّد أدرك سريعا أن وضع اليد على القضاء ومؤسّساته لا يتمّ بصورة آنيّة. فطبيعة السلطة القضائية وخصوصياتها ومؤسساتها المتعددة تجعل الأمر أكثر تعقيدا بالمقارنة مع السلطة التشريعية. فعلى المستوى اللوجستي على الأقلّ، لم يكن من الممكن تطويع السلطة القضائية عبر غلق مؤسساتها ومحاكمها المتعدّدة وتطويقها بالأجهزة العسكرية كما كان هو الحال بالنسبة للبرلمان أو الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد. كما أنّ طبيعة السلطة القضائية المتمثلة في جمهور قضاتها وتوزيع مؤسساتها وخصوصية نشاطها المرتبط مباشرة بالمواطن، جعل من مهمة تطويعها أمرا صعبا وطويل المدى. وهو ما اقتضى امتداد الصراع بين القضاة وسعيّد على مراحل متعددة طيلة الأشهر التي أعقبتْ قرارات 25 جويلية. ولم يكن تراجع قصر قرطاج عن ترؤّس النيابة العمومية إلا خطوة تكتيكية إلى الوراء، أعقبتها خطوات تدريجية واستراتيجية عدّة بهدف وضع اليد على القضاء وتسخيره لتحقيق غايات سياسية. تحقيق الهدفين المذكورين يمرّ أساسا عبر تجريد القضاء من استقلاليته والحطّ من سلطته وتضييقها. وهو ما اجتهدت السلطة القائمة لتحقيقه منذ 25 جويلية 2021. فمارست الرئاسة سياسات الشيطنة والتشويه لإضعاف السلطة القضائية وتقبيح صورة القضاة لدى الرأي العام. كما حاولت إرغام النيابة العمومية على تنفيذ التعليمات واستنجدت بالقضاء العسكري[1] عند استحالة تحقيق المطلوب. هذا بالإضافة إلى أنّها لم تتردّد في ضرب المجلس الأعلى للقضاء[2]، المؤسسة المستقلة الضامنة لاستقلالية القضاة. كما مارست الرئاسة أيضا سياسة التخويف والترهيب عبر إعفاء 57 قاضيا[3] من دون محاكمة أو تحقيق ومن ثمّ عدم الانصياع لقرار المحكمة الإدارية[4] التي قضت بارجاعهم لمناصبهم. وانتهت هذه المساعي إلى تعديلات على مستوى النصوص القانونية وعلى رأسها الدستور الجديد[5] الذي كرّس تحويل السلطة القضائية إلى وظيفة مجرّدة من ضمانات الاستقلالية.
لم يمرّ السعي لوضع اليد على السلطة القضائية من دون مقاومة. بل تمّت مواجهته بآليات وأشكال مختلفة حسب مراحله وفاعليه. على المستوى الوطني، عارضتْ أطراف سياسية ومدنية عدّة قرارات سعيّد حول القضاء، ولكنّ المواجهة الحقيقية خاضها الحراك القضائي بقيادة هياكل قضائية ممثلة للقضاة بمختلف أسلاكهم. لقد تحوّل القضاء إلى جبهة مهمّة وحاسمة في معركة حماية المكتسبات الديمقراطية، لعب فيها الحراك القضائي دورا طلائعيّا في سياق تراجع رهيب وحملات تخوين وشيطنة للأصوات المعارضة واستقالة واسعة من جزء لا يستهان به من القوى الديمقراطية.
حرصت السلطة على نزع وزعزعة ثقافة الاستقلالية التي تمّ العمل على ترسيخها لمدة عشر سنوات، بالتوازي مع تفكيك المكاسب المؤسساتية والقانونية الضامنة لاستقلالية القضاء. لم يكن سهلا على سلطة 25 جويلية تطويع القضاء لخدمة أهدافها، إذ فرض توجّه الرئيس مواجهة عسيرة مع الحراك القضائي.. ولئن اختلفت المواجهات بين القضاة والسلطة وتعدّدت على مرّ تاريخ القضاء، إلاّ أنّ الحراك القضائي لسنة 2022 يعدّ استثنائيا لأسباب متعددة.
أوّلا، نشأ هذا الحراك في سياق تعطيل انتقال ديمقراطي أعقب ثورة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وفي إطار مقاومة لهيمنة الرئيس قيس سعيّد على السلط الثلاث. كما نشأ هذا الحراك في ظلّ مخاض عسير كان يعيشه القضاء عبر الانطلاق في مسارات تأديب ومساءلة لقضاة برتب متقدمة تعلّقت بهم تهم فساد وتواطِؤ في علاقة بقضايا فساد واغتيالات. وخلافا للمواجهات القضائية السابقة، نشأ هذا الحراك القضائي في ظلّ أزمة متعدّدة الأبعاد ألقت ظلالها على المؤسسات القضائية وفي ظلّ رأي عام وديناميّة مدنية نشيطة.
ثانيا، تمّ جرّ القضاة لخوض هذا الحراك تحت سياسة الضغط التي قادها سعيّد عبر الشيطنة غير المسبوقة للقضاة وعبر تشويه السلطة القضائية خلافا لما تمّ العمل به من قبل الأنظمة السابقة التي امتهنت الخطابات الرنّانة والشعارات الكاذبة حول استقلال القضاء ورفعة مكانة القضاة في الدولة.
ثالثا، لقد شكّل هذا الحراك الرافعة الأهمّ للفعل السياسي والحراك الديمقراطي بتلك الفترة. فبعد تحييد مختلف مكوّنات الحراك الاجتماعي النشيط، وبعد إحداث ارتباك غير مسبوق في صفوف منظمات المجتمع المدني وبعد إخماد شعلة الحراك السياسي، مثّل الحراك القضائي نقطة التقاء العديد من الفرقاء السياسيين والمدنيين وقاطرة المواجهة مع النظام الشعبوي.
رابعا، وعلى غرار المعارك القضائية السابقة، تمّ خوض هذه المواجهة بأدوات وأساليب نضالية جديدة لم يعرفْها القضاة من قبل، أبرزها إضراب الجوع. كما تمّت مقارعة النظام من قبل قضاة حاملين لمبادرات فردية من جهة ومن قبل هياكل قضائية متعددة تنسّق خطواتها فيما بينها من جهة أخرى. كما عرف الحراك حملات مساندة من قبل جهات وتيارات مختلفة من المجتمع المدني والسياسي، كالاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات، ومنظمات دولية وشخصيات وأحزاب سياسية.
لقد كان في الحراك القضائي لسنة 2022 تميّزٌ واضح من حيث سياقه وتطوّره وفاعِليه وخصوصا آثاره. فلا يمكن قراءة ما يقع من ارتداداتٍ على الحقوق والحريّات ومن تضييقات على العمل السياسيّ والانخراط بالشأن العامّ من دون فهم ذلك ونتائجه. ولا يمكن تحليل ما حلّ من إيقافات لمساجين سياسيّين وملاحقات لصحفيّين وحقوقيين ومحامين ونقابيّين وجمعيّات من دون العودة إلى حراك 2022 والوقوف على أهمّ مراحله وارتِداداته.
وبالنظر إلى أهمية هذا الحراك ومختلف خصوصياته ومميّزاته ومآلاته، ارتأينا أن نقوم بتوثيق مختلف محطّاته قصد التمكّن من تقديم قراءة معمّقة لهذا الحدث التاريخي الهامّ ليس فقط في مسار السلطة القضائية ومجتمع القضاء، بل أيضا في تاريخ الحركة الديمقراطية ومقاومة الاستبداد. وهدفنا من ذلك ليس فقط الإسهام في فهم هذه التجربة واستخلاص الدروس منها، بل أيضا الإسهام في فهم أسباب انتكاسة الديمقراطية في البلاد بعد 25 جويلية 2021 والعجز عن حماية مكتسبات الثورة.
وللقيام بذلك، اعتمدنا على منهجية تقوم على طرق بحثية مختلفة. فقد استعملنا في مرحلة أولى تقنية الملاحظة بالمشاركة عبر الحضور في مختلف التحرّكات التي نظّمها القضاة ومتابعتها مباشرة. وفي مرحلة ثانية، ارتأينا القيام بالبحث البيبليوغرافي للعودة على أهمّ ما كتب عن حراك القضاة موضوع الدراسة وعن تاريخ الحرَاكات القضائية علّها تقدّم مداخل لتحليل ودراسة الحراك الجديد. كما قمنا بتنظيم مقابلات فردية مع من استجاب لطلبنا من فاعلين مركزيين داخل الحراك وخارجه[6]. فقمنا بمقابلة القاضي يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحلّ[7]، والقاضي أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين[8]، والقاضي أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين، والقاضي محمد عفيف الجعيدي وقد كان عضوا فاعلا طيلة الحراك القضائي[9]، والقاضي حمادي الرحماني وهو أحد القضاة المعفيين[10]، والقاضي المعفي “دون اسم” والذي طلب منا حجب اسمه، والمحامي عدنان العبيدي عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان آنذاك[11]، والمحامي كريم المرزوقي[12].
استنادا على كلّ هذه الأعمال البحثية، تقدّم هذه الورقة في قسم أوّل تاريخ الحراكات القضائية في تونس وأهدافها تطوّراتها وسياقاتها، علّنا نستشفّ خصائص حراك القضاة التونسيين بالاستناد على تجاربه السابقة. يهتمّ القسم الثاني بمسار الحراك عبر العودة على كلّ محطّات المواجهة بين القضاة والرّئيس. يهدف تفصيل كلّ مراحلها لتقديم قراءة معمّقة لكيفية تمكّن السلطة من إحكام قبضتها على السلطة القضائية.كما سيقدّم القسم الثالث قراءة لديناميّات الحراك، مواطن فشله ونجاحه والأسباب التي تقف خلفها، بهدف استخلاص دروس هذه التجربة التاريخية وتَقديم مفاتيح فهم تطوّر الأحداث وتَدافعها للقذف بالبلاد في هذا السياق المعقّد.
القسم الأوّل: تاريخ الحراكات القضائية: من المطالبة باستقلال البلاد إلى المطالبة باستقلال القضاء
إنّ الحراك القضائي الذي انطلق لمواجهة تدابير الرئيس سعيّد ليس الأوّل من نوعه في مواجهة هيمنة السلطة التنفيذية أو التصدّي لتطويع القضاء. فهو يندرج ضمن سيرورة وتاريخ من الحراكات والانتفاضات التي خاضتها أجيال قضائية مختلفة تعود لما قبل 2011 وتجد جذورها منذ بداية تشكّل أولى مؤسسات هذه السلطة. فقد تعلّقت تحرّكات القضاة بالأحداث التاريخية الوطنية، وتطوّرت من حيث الشكل والمضمون حسب التحوّلات الكبرى التي شهدتها البلاد.
1. فترة الاحتلال الفرنسي: “اليوم نحكم على الاستعمار بالاعدام”
وثّقت محكمة التعقيب بتقريرها السنويّ لسنة 2017[13] تاريخ القضاء التونسي ونضالات القضاة التي تعلّقت باستقلاليتهم وبنُظم عملهم من جهة، وبالشّأن الوطني والحرية من جهة أخرى. وتكمن أهمية هذا التقرير في تطرّقه للمعارك التي خاضها القضاة قبيل الاستقلال ومدى اندراجها أساسا في مقاومة الاحتلال الفرنسي حتى قبل سنة 1921. فقد كانت تلك السنة نقطة فاصلة من حيث تطوّر الحركة الوطنية ومطالبها كما تمّ خلالها إحداث وزارة العدل لأوّل مرّة في تاريخ البلاد.
وقد وثّقت تقارير الإدارة الفرنسية في المراقبات المدنية والعسكرية مقاومات قضائية عدة في مناطق مختلفة بالبلاد[14]، إذ تضمّنت اتهامات لقضاة عدة برفض تطبيق تشريعات سلطة الاحتلال، ومخالفة ما تمليه عليهم الإدارة الفرنسية ورفض التدخّل في أحكامهم. وعاقبت الإدارة الاستعمارية عدد من القضاة من أجل آرائهم السياسية واتهامهم بتحريض السكان ودعوتهم لمقاومة الاحتلال. وهو ما انجرّ عنه عزل العديد منهم كالقاضي محمد الصديق في باجة لتغييره دفتر القرعة العسكرية وإعاقة الإدارة الفرنسية على تجنيد التونسيين بجيشها. كما عُزل القاضي محمد الصالح بن عبد الجواد بقابس بعد اتهامه بالتنسيق مع أنصار الشيخ السنوسي الذين كانوا يُتّهمون بجلب وتجميع الناس لمحاربة قوات الاستعمار. وعُزل القاضي محمد زروق النفطي بأولاد سيدي عبيد لعدم موالاته لسلطة الاستعمار. وعُزل قاضي منطقة أولاد عون[15] الذي اشتكى منه العامل للوزير الأكبر، بعنوان التدخّل في النّوازل (أي القضايا) السياسية وفصلها دون تطبيق التشريع الفرنسي عبر نصب خيمته في السوق وتقبّله لشكايات الأهالي مباشرة. كما تمّت معاقبة أعضاء محكمة قفصة وسجن القاضي السنوسي بن عبد الرحمن وطلب عزله بعد اتهامه بإعاقة إدارة الاستعمار وتثوير السكّان ضدّها وتشجيعهم على المقاومة المسلّحة[16].
لم تقتصر مقاومة القضاة للاحتلال الفرنسي على بعض التحركات والانتفاضات الفردية، بل التحقوا أيضا بالحركة الوطنية وساهموا من خلال مواقعهم بمواقف رافضة للمستعمر وداعية لمقاومته. ولقد مثّل ترؤّس القاضي العروسي الحداد[17] مؤتمر ليلة القدر المنعقد بـ23 أوت 1946، والذي طالبت فيه الحركة الوطنيّة، باختلاف روافدها السياسية والاجتماعيّة، بالاستقلال التامّ، إشارة دالّة على انخراط القضاة في الكفاح الوطني. وما كان في خطاب الحداد إلا تأكيد على هذه المساهمة. فقد عبّر عن موقف المجتمعين بالمؤتمر، المُطالب بالاستقلال، باستعماله للمعجم القضائي قائلا “اليوم نحكم على الاستعمار بالإعدام”.
لم تتركّز مقاومة القضاة للاحتلال الفرنسي على الانخراط في المبادرات والتحركات الوطنية فقط، بل شملت أيضا المستوى القطاعي. فقد كان القضاة يرفضون تطبيق التشريعات الموضوعة من قبل السلطات الفرنسية، كما كانوا يطالبون بتأسيس المحاكم العدلية وتفويض الأحكام.
خلال سنة 1946، تأسّست الجمعية الودادية للحكام التونسيين التي تعلّقت مهامها الأساسية بالدفاع عن الأوضاع المادية للقضاة، عبر منح قروض للقضاة عند الانخراط والمرض ومنح إعانات فضلا عن تحقيق التضامن فيما بينهم والسعي للحصول على التحسينات التي تهمهم[18]. وإن انحصرت مهام الجمعية الودادية وفق نظامها الأساسي في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للقاضي، فقد انخرطت أيضا في مخطّطات تنطلق من الشأن القطاعي لتسهم في الشأن الوطني. ومن أهم هذه المخطّطات، سعيها إلى تحقيق المساواة بين القضاة التونسيين والفرنسيين في الحقوق، وحماية اختصاص المحاكم التونسية من توسّع اختصاص المحاكم الفرنسية بتونس واسترجاع حق القاضي التونسي في رئاسة دائرة التعقيب بعد انتقالها إلى القضاة الفرنسيين آنذاك، وهو ما تمّ تحقيقه سنة 1948، بالإضافة لسعيها إلى إسناد خطة وكالة الدولة للتونسيين. كما ساهمت بصفة مباشرة في عدة مبادرات نضالية ضدّ الاستعمار، على غرار تأييدها سنة 1951 وزارة محمد شنيق خلال سفره إلى باريس للتفاوض مع الحكومة الفرنسية بشأن المطالب الأساسية للتونسيين، أو إرسالها برقية احتجاج قانوني حازمة إلى وزارة الخارجية الفرنسية إثر جوابها عن العريضة الوزارية المؤرخة في 31 أكتوبر 1951.[19] كما انخرط رئيس الودادية أيضا محمد بن عمار الورتتاني في العمل النقابي عبر دفاعه عن عموم العملة بعد انضمامه للجنة المكونة للجامعات العامة للموظفين والتي تندرج ضمن هيكلة الاتّحاد العام التونسي للشغل[20].
في ظلّ غياب وثائق تفصيلية ودراسات معمقة لعالم القضاة آنذاك ومحاور اهتمامهم وتفكيرهم، تؤكّد مثل هذه الوثائق انخراط العديد من القضاة آنذاك بالشأن الوطني السياسي واهتمامهم به انطلاقا من موقعهم. ويشكّل انخراط هؤلاء القضاة بصفتهم في السعي لاستقلال وطنهم وتحقيق سيادته على أرضه وتحريره، مؤشّرا هامّا على اتساع رؤيتهم لدورهم كقضاة في علاقة بالمجتمع والدولة والسياسة. فعلى عكس الرؤية المحافظة لدور القاضي المتمثلة في تطبيق القانون وحفظه، يتجاوز هؤلاء القضاة فضاء المحاكم لينخرطوا ليس فقط في الدفاع عن القضاء بل في مسائل وطنية سياسيّة تهمّ المجتمع وتمسّ كيان الدولة ومؤسساتها. وهي نقطة جوهرية سترتبط بكامل مراحل تاريخ القضاء التونسي وستمثّل نقطة الخلاف الأهمّ في حراك 2021 -2022 كما سنبيّنه فيما بعد.
2. مرحلة حكم بورقيبة: القضاة الشبّان ينتفضون
لم تقتصر دائرة صراع القضاة ضدّ السلطة المهيمنة على الاستعمار فقط، بل اتّسع مفهوم الاستقلال الذي طالبوا به ليشمل وظيفتهم وسلطتهم بعد تركيز الدولة الوطنية ومؤسّساتها وتوحيد القضاء[21]. فبعد استقلال البلاد سنة 1956 وإلى حدود قيام الثورة التونسية سنة 2011، خاض القضاة معارك جديدة تحت عنوان استقلال القضاء. ولعلّ أهمّ مؤشّر على هذا التحوّل، هو ما قامت به ودادية الحكّام في سنة 1955 بتنقيح أهداف الجمعية المضمّنة بنظامها الأساسي لتفيد بأنّها تسهر “على تحقيق استقلال القضاء وحصانة القاضي والدفاع بكل الوسائل المشروعة على مصالح القضاة الأدبية منها والمادية” ومن ثمّ انضمامها إلى الاتحاد العالمي للقضاة سنة 1961.
ومنذ الظفر بالاستقلال التامّ، بدأت بوادر عدم الاعتراف باستقلالية القضاء كسلطة من طرف نظام بورقيبة. فتمّ، خلال مناقشة الدستور في المجلس القومي التأسيسي، التخلّي عن الصياغة الأولى للفصل 65 التي تقضي بأنّ “القضاء سلطة مستقلة يباشرها قضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون”، وتعويضها بصيغة “القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون”. وهو ما تمّ تأكيده أيضا خلال المداولات في مداخلة الباهي الأدغم، كاتب الدولة للرئاسة آنذاك، الذي صرّح “بأننا (أي أعضاء المجلس) صرنا نبحث في أشياء وهمية: السلطة القضائية سلطة مستقلة تمارسها المحاكم، فأين هي (هذه السلطة) وأين وجودها؟”[22].
تمّ إذا، منذ السنوات الأولى لبناء الدولة الوطنية، استعمال عباءة “استقلال القاضي” لإخفاء رفض التسليم باستقلالية السلطة القضائية وعدم فصلها عن السلطة التنفيذية. أصرّ النظام البورقيبي على بسط نفوذه على كلّ المؤسسات حديثة العهد، وعلى تطويع القضاء لقمع السياسيين المعارضين، وهو ما تمّ تحقيقه بالخصوص عبر المحاكم الاستثنائية التي اعتمد عليها هذا النظام طيلة فترة حكمه. من جهة أخرى، تميّزت الفترة التأسيسيّة بولادة النظام القضائي الجديد على مستوى المؤسسات والتشريع، على يد السلطة التنفيذية وعلى رأسها وزارة العدل، في ظلّ إمساك حكومة بورقيبة بسلطة التشريع بين أوت 1956 إلى غاية انتخاب مجلس الأمة في نوفمبر 1959، وهو ما سهّل عملية وضع اليد عليه. فقد عرفت تلك الفترة توحيد القضاء وتوْنسته عبر إلغاء المحاكم الشرعية (للمسلمين) ومحاكم الأحبار (لليَهود) والمحاكم الفرنسية وتوريث اختصاصاتها للمحاكم العدلية التونسية. كما عرفت أيضا زخما على مستوى التشريع فتمّ إصدار العديد من النصوص القانونية في فترة قصيرة. وقد كان التحدّي الأوّل في تلك الفترة هو تكوين قضاة أكفّاء من التونسيين يواكبون النسق السريع للتشريع لتطبيقه ويحسّنون إدارة المحاكم حديثة العهد. لقد شهدتْ الخمس عشرة سنة الأولى التي أعقبت الاستقلال تكوين القضاء التونسي وبناءه شيئا فشيئا “كهيكل” (كما عبّر عنه القاضي صالح الطريفي) غير مستقلّ عن الهياكل الأخرى للدولة، عبر أوامر رئاسيّة[23]. إذ لم يتمّ إصدار القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء وتنظيمه إلاّ في سنة 1967 ليقرّ واقعا موجودا خاصة فيما يتعلّق بعمل المحاكم ورُتب القضاة وكيفية نقلتهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء الذي يقوم رئيس الجمهورية بترأّسه وينوبه في ذلك وزير العدل. لقد نجحت فترة الستينات في بناء نظام قضائيّ فعّال على المستوى التقنيّ ولكنّه تابع ومقيّد فيما يخصّ الاستقلالية وتحقيق العدالة. وهو ما تجلّى في إقامة المحاكم الاستثنائية في مناسبات عدّة لتصفيّة الخصوم والمعارضين لسلطة الحاكم المستبدّ. نظام قضائي جديد يقوم على قضاة حديثي التكوين بامتيازات مادية ضعيفة. وهو ما ساهم في تنشيط التحرّكات المطالبة بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للقضاة وظروف عملهم.
في هذا الإطار، تعزّز المشهد القضائي بهيكل تمثيلي إضافي عبر تأسيس جمعية القضاة الشبّان سنة 1971 والتي اعتمدت على أسلوب أكثر جرأة ومواقف أكثر حزما في علاقتها مع السلطة حينذاك بالمقارنة مع الجمعية الودادية للحكّام. وقد تأسّس هذا الهيكل على خلفية أسباب عدة. فقد ساهم تعويل نظام بورقيبة على كبار القضاة في بسط نفوذه وسلطته في إهمال المحاكم وبقية مجتمع القضاء. وهو ما أدّى لإحداث شرخ بين كبار القضاة الذين ينتمون للنظام (كان للقضاة الحقّ في الانتماء للحزب الحاكم إلى حدود سنة 1974) بالإضافة لانتمائهم للودادية، وبين القضاة المنتمين لفئات عمرية شابّة حديثي التخرّج. كما تأثّروا بالحراك السياسي الذي تميّز به ذلك السياق (بداية طرح المسألة الديمقراطية والتداول على السلطة) وكذلك الحراك الطلابي الذي عمّ الجامعات. وهو ما جعلهم يبحثون عن هيكل تنظيمي جديد يمثّلهم فأسّسوا جمعية القضاة الشبّان.
برزت أوجه الاختلاف أساسا في التوجهات والقضايا التي تمّ الاهتمام بها. فظهر ذلك مثلا فيما يتعلّق بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية للقضاة. فلقد أنجزت جمعية القضاة الشبان أوّل توقّف عن العمل في المجال القضائي يوم 26 ماي 1976، ودشّنوا بذلك شكلا احتجاجيّا لم تشهده البلاد من قبل في هذا المجال[24]. كما قرّرت الجمعية خلال جلستها العامة المنعقدة يوم 11 جوان 1977، إمهال السلطة عشرة أيام للاستجابة لمطالبها مع التهديد بالإضراب يوم 21 جويلية في حال لم تردّ على ذلك[25].
ورغم الاختلاف الواضح في استراتيجيات التعامل مع السلطة وفي كيفية اتخاذ المواقف منها، إلا أنّ الدفاع عن القضاة جمع الهيكليْن التمثيليّين. فقد قامت الجمعيّتان بالتنسيق فيما بينهما من أجل بلوغ الأهداف المشتركة. فأعدّتا على سبيل المثال مقترحا مشتركا للإصلاحات القضائية وقَدَّمتاه لوزير العدل سنة 1978. كما ناقش أعضاء الجمعيتين مبدأ دمجهما بجمعية واحدة منذ سنة 1983، قبل أن يتخلوا عن الفكرة نظرا لعدم فائدة التوحيد ما دامت الجمعيتان تعملان في نطاق الانسجام والتكامل، وهو اتجاه سيُعاد النظر فيه لاحقا. ففي ظلّ تواصل سياسة إخضاع السلطة القضائية لهيمنة النظام الحاكم وما انجرّ عنه من تهميش للقضاة ومطالبهم الاقتصادية والاجتماعية، وفي ظلّ تواصل انتداب القضاة المتخرّجين حديثا من الجامعات التونسية التي كانت تشهد حركية سياسية نشيطة منذ نهاية الستينات، أخذ حراك القضاة أشكالا وتعبيرات جديدة أكثر صداميّة. وفي ظلّ عدم تلبية هذه المطالب وتردّي الوضع العام بالبلاد خصوصا مع تأزّم الوضع الاقتصادي والمالي في أوّل الثمانينات نتيجة الأزمة العالمية لديون دول الجنوب، نفّذ القضاة إضرابا يوميْ 10 و11 أفريل 1985 بدعوة من جمعية القضاة الشبّان. دفع الإضراب النظام إلى معاقبة الجمعية، عبر حلّها بقرار من وزير الداخلية، وأعضائها الذين تعرّضوا لعقوبات تأديبيّة بالعزل والإيقاف عن العمل يوم 18 ماي 1985. لقد كان للتنكيل بالقضاة من أجل آرائهم ومطالبهم وقع في صفوف القضاة. ومع تغيّر الأوضاع على الساحة السياسية بعد انقلاب 7 نوفمبر 1987 وتوفير هامش من الحريات في السنوات الأولى التي أعقبته، اختار القضاة بعد إجراء استفتاء فيما بينهم إعادة هيكلة الجمعية الودادية للحكّام، وتوسيع مجالسها وتمثيليّتها بهدف إدماج التيار الثائر المنتمي سابقا لجمعية القضاة الشبّان وتوجّهاته صلب هيكل ممثل موحّد. وتمّ بذلك إطلاق تسمية جمعية القضاة التونسيين على الجمعية القديمة وتنقيح قانونها الأساسي في بداية سنة 1990.
3. مرحلة حكم بن علي: انتفاضة جمعية القضاة والانقلاب ضدّها
خلافا لنظام بورقيبة، اختار النظام الجديد التخلّي عن المحاكم الاستثنائية[26]، للإيهام باحترام كاذب للحقوق والحريات. فاعتمد على أساليب أقلّ وضوحا للتدخّل بالقضاء وانطلق في إحكام قبضته على القضاء العاديّ عبر اتباع خطوات مدروسة واستراتيجية لعلّ أهمّها إلغاء أهمّ منصب بالهيكل القضائي حينها ألا وهو منصب الوكيل العام للجمهورية. خلافا لنظام بورقيبة الذي اعتمد على بعض القضاة وأكبرهم لتشكيل المحاكم الاستثنائية وتسليطها على المعارضين، توجّه نظام بن علي لبسط نفوذه على القضاء العاديّ وهو ما تطلّب وضع مسار آخر لاستتباع القضاة. وعليه، تمّ تحسين الظروف المادية للقضاة خصوصا بعد الانتعاش الاقتصادي النسبيّ الذي شهدته سنوات التسعينات. كما تمّ تمكين إطاراته من سيارات إدارية وبناء مقرات محاكم جديدة وتجهيزها. وتمّ تأسيس المعهد الأعلى للقضاء، الذي صدر القانون المحدث له بعد أشهر من إضراب جمعية القضاة الشبان في 1986، بهدف معلن هو السعي إلى “تحسين كفاءة القضاة”، وآخر خفيّ هو التحكّم بتكوينهم والمواصفات التي تشكّل القاضي التونسي. وقد تواصل الحطّ من وضعيّة القضاء وتوريطه في منظومة الاستبداد بتونس، لينشأ نموذج جديد طاغي هو “القاضي المنسجم”[27] أي القاضي الذي يملأ المساحة العظمى ما بين القاضي الخاضع والقاضي الثائر. يتحرّك القضاة المنسجمون داخل المربّع الذي رسمتْه السلطة لهم منذ تكوينهم، فلا يُسائِلون حدوده وارتباطه بدورهم المجتمعي الذي يضطلعون به ويحظون بهامش مرن للمناورة والتفاوض مع السلطة المتحكّمة. فلا يدخلون بذلك لخانة الطاعة أو العصيان وإنّما يقفزون بين عروض السلطة بخيارات تحترم القواعد المؤسساتية وهي بذلك لا تتّسم بالحدّة وتقضي بتحصيل بعض الامتيازات المهنية.
في موازاة ذلك، تنامى في الدول الديمقراطية مفهوم استقلالية السلطة القضائية وعلاقتها ببقية السلط ومراكز النفوذ بالحكم. كما تطوّرت ممارسة القضاة لحريّتهم في التعبير وتدخّل هياكلهم التمثيلية بالشؤون “السياسية” وهو ما أثّر بطريقة غير مباشرة على تطوّر الرؤية السياسية للسلطة القضائية ومكانتها في أنظمة الحكم.
مرحلة وضع اليد على القضاء التي رافقت كامل حكم بن علي، تخلّلتها بعض المواجهات القضائية. ولعلّ أهمّها المعركة الفردية التي قادها القاضي مختار اليحياوي. ففي سنة 2001، وجّه القاضي اليحياوي رسالة مفتوحة لبن علي منتقدا فيها وضعية القضاء ومستنكرا الوصاية التي فُرضت عليه والضغوط المسلّطة من قبل النظام على القضاة لتكريس خضوعهم ومناديا برفع اليد عنه وإتاحة الحريّات الدستورية. تسبّبت انتفاضة القاضي المنفردة في إحالته على مجلس التأديب وعزله ومنعه من السفر، وهو ما حرّك حملات مساندة واسعة من الحقوقيين والمتابعين على المستوى الوطني والدولي. لم تكن انتفاضة القاضي بمعزل عما كان من دينامية في النظام القضائي ككلّ ومزاجه العام. فبعد مضي سنوات التسعينات التي اتّسمت بالتنكيل بالتيار الإسلامي وأنصاره، وسّع نظام بن علي دائرة القمع لتشمل المعارضين من التيارات اليساريّة والقوميّة عبر إخضاعهم لمحاكمات سياسيّة جائرة. أعدم النظام بذلك ليس فقط أحزاب المعارضة، بل الحياة السياسية الحزبية وما قد يتخللها من حيوية. وهو ما قد يفسّر في جانب ما، انتقال النقاش السياسي إلى المجال القضائي/الحقوقي، وحصر المعارضة للنظام في دائرة استقلال السلطة القضائية. فانتقل الصراع السياسي إلى دوائر المحامين والقضاة، وهو ما يشبه في أوجه عدّة ما حدث بخصوص الحراك القضائي لسنة 2022 وهو ما سنبيّنه في الأجزاء اللاحقة.
لقد كان في تحوّل الوجهة السياسية للشأن القضائي أوجه عدة لم تتشكّل في شكل تيارات استقلالية معادية للنظام بشكل واضح ولكنّها كانت تبدو في شكل أحداث متفرّقة لها أثر أشبه بدبيب النّمل. فقد تميّزت تلك الفترة بانتخاب المحامي البشير الصيد كعميد للمحامين في عهدته الأولى سنة 2001 (وهو محام عُرف آنذاك بانتمائه السياسي للتيار القومي وبدفاعه عن المعارضين السياسيين بشتى اختلافاتهم: إسلاميين ويساريّين وقوميين). كما عرفت تلك الفترة خروج حمّة الهمامي ورفاقه من العمل السرّي ومحاكمتهم بعد صدور أحكام ثقيلة غيابيّة ضدّهم سنة 1999[28]، وتأسيس المجلس الوطني للحريات بتونس سنة 1998 الذي لم يعترف به النظام وقام بِهرسلة مؤسسيه خصوصا في بداية الألفية الثالثة.
في ظلّ تصاعد بطش النظام ضدّ معارضيه والتحرّك اللافت للفاعلين في المجال القضائي، تمّت انتخابات جمعية القضاة لسنة 2004 لتصعد قائمة القضاة الذين عُرفوا بِعدم موالاتهم للنظام وبِمواقفهم واتجاهاتهم التي وإن لم تأخذ أشكالا بطولية قبيل الانتخابات إلاّ أنّها لم تكن منسجمة مع النظام وإدارته خصوصا[29]. وقد تزامنت انتخابات المكتب التنفيذي للجمعية مع تقديم الحكومة مشروع تنقيح للقانون المنظّم للقضاء. لم تُمكّن الجمعية من الاطّلاع عليه وعلى التقرير الخاص به ولم يتمّ تَشريكها أو الأخذ بتَوصِياتها عند صياغته. فقد تعلّقت مقترحات الجمعية أساسا بتركيز المجلس الأعلى للقضاء على أساس الانتخاب وليس التسميّة وعلى تكليفه حصريّا بنقلة القضاة وحركتهم وجعلها مقترنة برضاهم وطلبهم وهو ما رفضته وزارة العدل[30]. انطلقت المواجهة بين الجمعية والسلطة أشهرا معدودة بعد إتمام تنصيب المكتب التنفيذي الجديد للجمعية الذي رفض وزير العدل استقبال أعضائه رغم محاولاتهم المتكررة خلافا للعرف الجاري[31]. بدأت المواجهة بمناسبة المحاكمة السياسية للمحامي محمد عبو، المنتمي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والمجلس الوطني للحريات في تونس، وكذلك لمركز استقلال القضاء في تونس الذي أنشأه القاضي المعزول مختار اليحياوي، على خلفية نشره مقالا يندّد بدعوة أرييل شارون لحضور قمة مجتمع المعلومات[32]. في صورة مشابهة لمحاكمة القاضي مختار اليحياوي، حظيت محاكمة عبو بمتابعة دولية وبدعم هامّ من المحامين الذين تجمّعوا بالمحكمة وتعرّضوا لبطش البوليس المنتشر بأَرجائها. استنكرتْ جمعية القضاة آنذاك الاعتداءات البوليسيّة في بيان شديد اللهجة بالنظر إلى ذلك السياق القمعي، يقطع مع سياسة التملّق والانسجام التي تمّ تطبيقها من قبل. فعاقبت السلطة الجمعية عبر تطويع القانون لتعطيل عملها وغلق مقرّها ووقف مكتبها التنفيذي وتسليط نقل تعسّفية على أعضائه. لم يلتجئ النظام إلى حلّ الجمعية وحظر نشاطها، كما فعل مع جمعية القضاة الشبان سنة 1985. وإنّما قام بحسم المواجهة عبر إحداث شغور بمكتب الجمعية بعد نقلة أعضائه وتعطيل أعمال الجمعية ومن ثمة تطويع القانون عبر تنصيب لجنة مؤقتة لتصريف أعمال الجمعية وسحب الثقة من مكتبها المنتخب، الذي بدوره أعلن مقاومته لهذا الانقلاب وتمسّك بارساء الهيئة “الشرعية” التي استمرّت في تنظيم اجتماعاتها والإعلان عن مواقفها[33].
4. مرحلة ما بعد الثورة: تناقضات النقابة والجمعية في مخاض الانتقال الديمقراطي
بعد اندلاع الثورة واستقرار ملامحها عبر مغادرة رأس النظام للبلاد، دخلتْ تونس شعبا ومؤسسات مرحلة جديدة قلبتْ موازين الحكم فتقدّم فيها ضحايا الأمس كفاعلين جدد على الساحة وتخلّلتها بالتالي معارك ضروس مع الفاعلين القدامى الذين تمسّكوا بالدفاع عن مصالحهم ومراكزهم. على المستوى القضائي، شهدتْ أولى أيام الثورة عودة أعضاء جمعية القضاة المعاقبين، المتمسّكين بشرعيّتهم لإدارة الجمعية وصولا إلى استردادهم لمقرّها بالمحكمة عبر خلع بابها. طالب مناضلو الجمعية باستقلالية السلطة القضائية وبلعب دور داخل مؤسسات الانتقال الديمقراطي عبر المشاركة مثلا بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وقبل ذلك مجلس حماية الثورة، وحملوا شعار تطهير القضاء. إلا أنهم اصطدموا بمقاومة القضاة المنسجمين وغيرهم من القضاة “المهنيين” الصامتين الذين كانوا يخافون شعار التطهير بذريعة عدم التشهير ويرفضون ما اعتبروه ممارسة للسياسة باسم القضاة. لقد أحدثت انتفاضة الشارع ودخول البلاد في نسق جنوني من التغيير غير المرتقب، رجّة وسط المؤسسات وفاعليها وخصوصا في صفوف القضاة. فتبعا لعودة القضاة المقصيّين قبل الثورة واستِردادهم لجمعية القضاة ومطالبتهم بتطهير القضاء، اتّجه عشرات القضاة لتأسيس هيكل تمثيلي جديد هو نقابة القضاة التونسيين. وبغضّ النظر عن الفكرة السائدة حول التفاف القضاة الأكثر انسجاما مع نظام بن علي بالنقابة ومدى صحّتها، فقد اعتمدت النقابة استراتيجية مختلفة في التعامل مع السلطة خلال السنوات اللاحقة، برزت في مجمل المنعطفات القضائية، وبالأخصّ الحراك القضائي منذ سنة 2022.
بعدئذ، سيتوالى تأسيس هياكل قضائية بتسميات مختلفة: اتحاد القضاة الإداريين (في أكتوبر 2011) واتحاد قضاة محكمة المحاسبات (في ماي 2015)، وجمعية القضاة الشبان (في مارس 2015) وجمعية القاضيات التونسيات (في نوفمبر 2016). وفي حين حصل إنشاء هذه الهياكل بدوافع وغايات مختلفة، إلا أن عملية التأسيس بدت دائما بشكل من الأشكال بمثابة منافسة مباشرة لجمعية القضاة التي طالما تمسّكت بشرعيتها التاريخية (أقدم جمعية) والتمثيلية (ممثلة لكلّ الأسلاك القضائية). لكنّ المنافسة الأهمّ كانت في سلك القضاء العدلي، وهو الأكثر عددًا، بين الجمعية والنقابة. تمّ خوض هذه المنافسة تحت عناوين عدة وبالاعتِماد على اختلاف استراتيجيات الهيكلين وتوجّهاتهما. فقد تمسّكت الجمعية بأداء دور هامّ في الفترة الانتقالية، بالاستناد إلى تاريخها النضالي ضدّ النظام الاستبدادي وبالارتِكاز على رؤيتها لدور القاضي المنفتح والمساهم في الشأن العامّ وموقعه في مجتمعه. بالمقابل، تمسّكت النقابة بالتصوّر التقليدي لدور القاضي، المتحفظ والرافض للخوض في السياسة لما تفرضه الوظيفة القضائية من ضوابط لا يمكن تجاوزها حسب تصوّرها، وعدم تجاوز سقف المقاومة الناعمة للنظام الاستبدادي، أي من داخل المهمة القضائية وما تفرضه من حدود[34].
لقد ساهم تباين الرؤيتين السياسيّتين التي حملتهما كل من النقابة والجمعية للسلطة القضائية ولاستقلاليّتها في ظلّ نظام ديمقراطي، في تشكيل ملامح التجاذبات التي عاشتها السلطة القضائية طيلة سنوات الانتقال الديمقراطي. ففيما ساهمت هذه التعددية في فتح المجال للخوض في شؤون السلطة القضائية وابتعادها شيئا فشيئا عن ثقافة التحفّظ والكتمان بهدف تقريبها من الرأي العام والمجتمع، كان لهذا الاختلاف وقع في بطء ترسيخ استقلالية القضاء وفي إضعاف السلطة القضائية، خصوصا عند امتحانها بعد 25 جويلية 2021 وذلك رغم أهمية ما تمّ إنجازه بعد الثورة.
لقد تميّزت فترة الانتقال الديمقراطي في تونس بتحقيق مكتسبات عدة طالب بها القضاة منذ سبعينات القرن الماضي. فتمّ تكريس استقلالية السلطة القضائية بدستور 2014 في الفصل 102 عبر التنصيص صراحة بـ “القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات” وبالتمييز بينها وبين استقلالية القاضي التي تمّ التنصيص عليها في فقرة ثانية بـ”القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون”. وتمّ تركيز المجلس الأعلى للقضاء (بعضوية متعددة أي لا يقتصر فقط على القضاة)، غالبيّة أعضائه منتخبون، والاعتماد عليه حصريّا في ضبط الحركة القضائية من جهة وفي ترقية القضاة وإخضاعهم للمساءلة والتأديب من جهة أخرى. هذا بالاضافة إلى إصدار القانون المنظّم لمحكمة المحاسبات، وإحداث تغيير جذري على مستوى الخصوصيات الديمغرافية للقضاء. فقد تمّ، منذ 2011 إلى حدود 2022، تجديد ما يقارب 60% من الجسم القضائي[35] عبر عمليّات انتداب متتالية لشابّات وشبّان عُرفوا بـ “قضاة ما بعد الثورة” (لم يعرفوا بذلك القضاء وممارساته زمن الاستبداد ولم يعتادوها). كما ساهم ذلك في إحداث تغيير جندريّ على مستوى الجسم القضائي، إذ بلغت نسبة القاضيات قرابة 50% من مجموع عدد القضاة[36].
ولئن كانت هذه الإصلاحات على أهمية بالغة لتركيز أسس السلطة المستقلة، إلاّ أنّ غياب إصلاحات أخرى وتأخّر إنجاز تغييرات على مستوى العمل القضائي بشتّى مؤسّساته ساهم في تأزيم الوضع وتوتيره. فعلى سبيل المثال، لم يتمّ تركيز المحكمة الدستورية، كما لم تتمّ ملاءمة التشريعات مع أهمّ مكتسبات دستور 2014، خصوصا المجلّة الجزائيّة. كما لم يتمّ التطرّق على سبيل المثال للقانون الأساسي للقضاة، أو للنصوص المنظمة لعمل المحاكم (المدنية أو العسكرية)، أو للقانون المنظّم لعمل التفقدية وبالتالي فكّ ارتباطها مع وزارة العدل. بقيت حصيلة المنجز غير كافية بالمقارنة مع المأمول لما شاب هذا المسار من تعثّر وتجاذبات طغى عليها في أحيان عدة الطابع السّياسوي. فلم تسلم السنوات الماضية من نزاعات بدأت أساسا مع إرساء هيئة القضاء العدلي التي خاضت صراعات عدة مع السلطة التنفيذية. كما عرفت عدة محطات لعلّ أهمّها عند انتخاب المجلس الأعلى للقضاء وضرورة إنهاء مهام هيئة القضاء العدلي. هذا بالاضافة لأزمة 2012 حين تمّ إعفاء 82 قاضيا بقرار أحادي من وزير العدل آنذاك، نور الدين البحيري. تمّ اللجوء للمحكمة الإدارية لإبطال قرارات الإعفاء كما جوبه هذا التدخّل السافر في استقلالية القضاء برفض واسع من عموم القضاة. حدّة الرفض الذي أثارته هذه السابقة، لم تؤثر على ما يبدو على تحديد الخطوط الحمراء لتدخّل السلطة التنفيذية التي عادت بعد عشر سنوات، بعد احتكار الرئيس سعيّد للسلطة، لتعتمد الممارسة نفسها لنسف من يشكّل خطرا عليها ولتقويض استقلالية السلطة الوحيدة التي كانت قادرة على مجابهة تغوّلها واستبدادها.
[1] المفكرة القانونية (2022): تواصل المحاكمات العسكرية للمدنيين في تونس: إدانة عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، 20 ماي 2022.
[2] محمد عفيف الجعيدي، (2022): القصر في مواجهة القضاء … والديمقراطية في تونس، المفكرة القانونية تونس، 09 فيفري 2022.
[3] أميمة مهدي، عزل القضاة من قبل سعيّد: مذبحة بسكاكين الداخلية، المفكرة القانونية تونس، 28 جوان 2022.
[4] المفكرة القانونية، ملفّ القضاة المعفيين: بعد الانفراج بوادر أزمة جديدة، 16 أوت 2022.
[5] كريم المرزوقي، دستور سعيّد: القضاء من سلطةٍ إلى وظيفةٍ أو وصفةٌ في نسف استقلال القضاء، المفكرة القانونية تونس، 07 جويلية 2022.
[6] لم نتمكّن من إجراء مقابلات مع كلّ من القاضية مليكة المزاري رئيسة مجلس القضاء العدلي المنحلّ وإحدى القاضيات المعفيّات، والقاضية روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين، والمحامية إيمان قزَارة وهي عضوة بهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي، والقاضي فراس الوكيل وهو قاضي إداري.
[7] أجريت المقابلة بتاريخ 13 أكتوبر 2022.
[8] أجريت المقابلة بتاريخ 24 نوفمبر 2022.
[9] أجريت المقابلة بتاريخ 22 سبتمبر 2022.
[10] أجريت المقابلة بتاريخ 02 نوفمبر 2022.
[11] أجريت المقابلة بتاريخ 09 سبتمبر 2022.
[12] أجريت المقابلة بتاريخ 12 سبتمبر 2022.
[13] التقرير السنوي الأول في تاريخ القضاء العدلي الذي أعدّته محكمة التعقيب طبقا للفصل 115 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014.
[14] أنظر كتاب الشيباني بنبلغيث تحت عنوان “النظام القضائي في البلاد التونسية 1857 – 1921″، مكتبة علاء الدين صفاقس، 2002.
[15] لم يقع ذكر اسم القاضي بالمرجع.
[16] المصدر السابق، ص 408.
[17] القاضي العروسي الحداد: كان يشغل منصب الرئيس للدائرة الجنائية بالعدلية حينذاك
[18] الهادي سعيّد، “القضاء نضال ومسؤولية”، مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله للنشر والتوزيع، تونس 1998، ص 120.
[19] وحيد الفرشيشي، “استقلال القضاة والتكتّلات الجماعية للقضاة في تونس”، من نزار صاغية (إشراف)، حين تجمّع القضاة: دراسة مقارنة لبنان، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق، 2009.
[20] تقرير محكمة التعقيب لسنة 2017، ص 48.
[21] بعد إحراز الاستقلال، تمّ توحيد القضاء عبر دمج المحاكم الشرعية ومحاكم الأحبار في المحاكم القضائية التونسية سنة 1956 وإلغاء المحاكم الفرنسية سنة 1957 واستيعاب اختصاصاتها.
[22] وحيد الفرشيشي، “استقلال القضاة والتكتّلات الجماعية للقضاة في تونس”، سبق ذكره.
[23] شهادة القاضي صالح الطريفي المضمّنة بكتاب “مهنة القضاء والمحاماة بين الاستقلالية والتدخّل السياسي (1956 – 2010)”، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، أكتوبر 2012.
[24] صفحة محطات في تاريخ الجمعية، بالموقع الالكتروني لجمعية القضاة التونسيين.
[25]وحيد الفرشيشي، “استقلال القضاة والتكتّلات الجماعية للقضاة في تونس” من مؤلف جماعي تحت عنوان “حين تجمّع القضاة” (دراسة مقارنة لبنان، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق) بإعداد نزار صاغيّة، 2005، ص155.
[26] قانون عدد 79 لسنة 1987 تعلّق بإلغاء محكمة أمن الدولة.
[27]سامر غمرون ونزار صاغية، “القضاء العربي في زمن الاستبداد – قضاة تونس ومصر بين قواعد المهنة وضرورات السياسة”، المفكرة القانونية، 2016.
[28] محمد شريف، “محاكمة حمة الهمامي: النظام فقد رشده”، مقال في swissinfo، فيفري 2002.
[29] سامر غمرون ونزار صاغية، “القضاء العربي في زمن الاستبداد – قضاة تونس ومصر بين قواعد المهنة وضرورات السياسة”، المفكرة القانونية، 2016.
[30]المصدر السابق.
[31]المصدر السابق.
[32]هيومن رايتس ووتش، “تونس: السجن لمحام على خلفية مقال ظهر على الانترنت وانتقد الحكومة”، 29 أفريل 2005.
[33]وحيد الفرشيشي، “استقلال القضاة والتكتّلات الجماعية للقضاة في تونس” من مؤلف جماعي تحت عنوان “حين تجمّع القضاة” (دراسة مقارنة لبنان، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق) بإعداد نزار صاغيّة، 2005، ص 167.
[34] سامر غمرون، “القضاة التونسيون بين السلطة والجمعية والنقابة: ماذا تعلمنا التعددية التمثيلية داخل الجسم القضائي؟”، المفكرة القانونية، جانفي 2021.
[35] معلومات قدّمها القاضي يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق خلال محاورته من قبل المفكرة القانونية – تونس في تاريخ 13 أكتوبر 2022.
[36] المفكرة القانونية، “بطاقات قضائية من دفاتر إحصائية لم تُقرأ”، العدد 20 من مجلة المفكرة القانونية – تونس بعنوان “قضاء تونس في زمن الياسمين”، جانفي 2021.