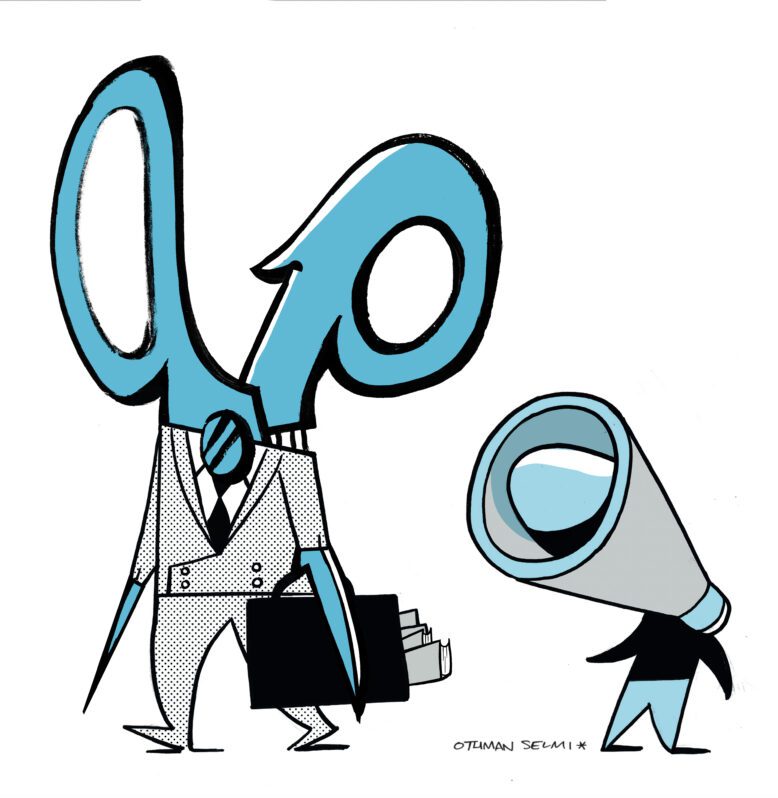بينما كان الرئيس التونسي قيس سعيدّ يهمّ بمغادرة معرض تونس الدولي للكتاب، بعد إشرافه على افتتاحه، في 29 أفريل 2023 الماضي، قامت إدارة المعرض بسحب كتاب “فرانكشتاين تونس”، للكاتب التونسي كمال الرياحي. يبدو من غلافه أنه ينتقد الرئيس، في حركة اعتبرها صاحب الكتاب وناشره “نوعاً من الرقابة”. لاحقاً عادت رئيسة لجنة التنظيم زهية جويرو لتؤكد أن اللجنة قررت إعادة الكتب التي تم سحبها والمصادق عليها من قبلها إلى العرض. وقد أرجعت سبب السحب إلى “الإجراءات الإدارية والتنظيمية”. تركَت حادثة سحب الكتاب من العرض والإغلاق المؤقت لجناح دار النشر جدلاً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها جدّدت السّجال التاريخي حول الرقابة في تونس، لاسيما رقابة الكتب والمنشورات، خاصةً في ظل الانحراف السلطوي الذي تعيشه البلاد منذ سيطر الرئيس سعيد منفرداً على السلطة في 25 جويلية 2021. ليست هذه المرة الأولى، التي يتم فيها سحب كتب من معرض الكتاب في عهد الرئيس سعيد، فقد شهدت دورة العام 2021، منع عرض كتاب أستاذ القانون “الفساد والدولة الفاشلة: تونس نموذجاً”، بحجة أنه “يسيء إلى صورة تونس”، ثم عادت إدارة المعرض عن قرارها بدعوى أن ما حصل كان: “تصرف(ا) فردي(ا) من قبل موظف تابع لإدارة الثقافة”.
شأنهم شأن جوارهم العربي، للتونسيين قصة طويلة مع الرقابة على الكتب ومنعها، في ظل أنظمة مختلفة الطبيعة حكَمتهم منذ الاستقلال، منتصف خمسينات القرن الماضي: شموليةً وسلطويةً. وهي رقابة متعددة الأوجه والأدوات ولكن هدفها واحد، وهي السيطرة على المجال العام ومنع أيّ صوت مختلف يمكن أن يكون وسيلة وعي لعموم المحكومين. تعدّ الرقابة من وسائل المراقبة التي ورثتها دولة الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي ذي الطبيعة الاستيطانية، والذي وضع عشرات القوانين ذات النزعة “التدخّلية” في حياة الأهالي، ومنها ما يتعلق بالرقابة على الكتب والصحف والمنشورات كي تتوفر له البيئة المناسبة للسيطرة على المُستعمرة، حيث كان المقيم العام الفرنسي يملك من السلطة التقديرية ما يجعله يفرض الرقابة على الصحف أو حظرها واعتقال الأفراد بشكل وقائي دون سقف، وطرد من يريد من أرض المستعمَر بما في ذلك الباي[1].
رقابة نظام الحزب الواحد: الذاتية والمباشرة
لم يتشكل نظام الحزب الواحد في تونس بعد استقلالها (1956) دفعةً واحدةً. وضعَ الرئيس الحبيب بورقيبة ورفاقه في حزب الدستور، بوصفه قائداً للحركة الوطنية التحريرية، أسس هذا النظام، الذي سيحكم البلاد نحو ثلاثة عقود من الزمن، خطوةً خطوةً. أولاً من خلال بناء الجبهة القومية مع الاتحاد العام التونسي للشغل والسيطرة على المجلس التأسيسي، كجهاز تشريعي. ثم إلغاء النظام الملكي، حيث لا يمكن بناء نظام الحزب الواحد في الملَكيات الدستورية. لاحقاً جاءت المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 1962، باعتبارها اللحظة التي أنهَت وجود أي تعددية سياسية في البلاد. كان بورقيبة يبحث على هذا الصفاء السياسي الذي لا تكدرّه أصوات المعارضة، كي يؤسس دولته. وفي سياق هذا الهوس بالوحدة الصماء للدولة والمجتمع، فرض نموذج الحزب الواحد-القائد الواحد، ضرورةً، فكرة الصوت الواحد. وهنَا وُلدَت الرقابة بوصفها أداةً من أدوات الدولة القمعية. فقد غمرت الدولة الجديدة الكل الاجتماعي باسم “وصاية مؤقتة وحتمية لجهاز الدولة”. لقد وسّعت سيطرتها على الأفراد والجماعات إلى أقصى حدّ بغرض تحييد الولاءات “الهامشية” والاستيلاء على الإمكانات الوحدوية للدين والثقافة، في إطار برنامج يرتكز على التحديث والعلمنة والتوّنَسَة[2]. وقد أدّى ذلك إلى تأميم المجتمع، والذي، خلافًا للمتخيل عنه في أجهزة الدعاية، لم يكن موحّداً في الولاء لهذه الدولة الجديدة، وهو ما ستكشف عنه العقود اللاحقة.
يقرّر دستور الدولة الوليدة في مادته الثامنة أنّ “حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتُمارَس حسبما يضبطه القانون”. لكن السلطة، وتحت دواعي ما “يضبطه القانون” حاصَرت هذه الحرية الدستورية بعدد وافر من القوانين والسياسات القمعية، التي أفرَغتها من مضمونها، حالها حال بقية الحريات. خاصةً الخضوع لإجراءات “الإيداع القانوني”، والذي بالرغم من أنه في الظاهر مجرد إجراء روتيني وشكلي، إلا أنه كان يمثل أداة رقابية أساسية للدولة على المصنفات المطبوعة بجميع أنواعها من كتب ونشرات دورية[3]. مع أنها لم تكن خلال عقد الستينات في حاجة لأي نوع من الرقابة، في ظل الرقابة الذاتية التي فرضَتها النخبة التونسية على نفسها، حيث كانت الكتب المنشورة منضبطة لمحاذير نقد النظام السياسي أو قائده، باستثناء المنشورات السرية التي كانت تُصدرها تنظيمات اليسار الجديد، والتي لم تكن تسلك المسالك النظامية، بل تأخذ مساراً موازياً عبر حملات التوزيع، وهي في أغلبها مجلات أو صحف، فيما تُطبع الكتب في الخارج وتُهرّب إلى الدّاخل بطريقة سرية ومحدودة.
خلال هذه المرحلة، التي يمكن وصفها بـــ “الشمولية”، حيث كان نظام الحزب الواحد – القائد الواحد، يسيطر على نحو شامل على السلطة والثروة والمجتمع، لم تكن الرقابة رقابةً كتلك المعروفة في النظم السلطوية، بل تُمارس من خلال سيطرة الدولة بشكل مباشر على الكلّ الاجتماعي. فتجد طرائقها في الروابط الوثيقة بين النخب السياسية الحاكمة والنخب الثقافية المُنتجة للكتاب، في سياق تمايز منخفض للمساحات الاجتماعية. وهكذا، فإن من الكتّاب من هم في الوقت نفسه جزء من النخبة الحاكمة، سواء من الإدارة أو من الحزب الحاكم أو يشغلون في نفس الوقت مناصب مهيمنة في الإدارة العليا. من ناحية أخرى، خَضعَ قطاع النشر خلال هذه المرحلة لسيطرة الدولة التي تحتكره بشكل مطلق. وبالتالي كانت الرقابة آنذاك، ليست مجرد منع كتاب من التداول، بل عملية ابتلاع للكون الثقافي: إنتاجاً وتوزيعاً وتسويقاً وفاعلين.
كان التناقض الرئيسي لنظام الحزب الواحد مع اليسار، لذلك شكّلت المطبوعات اليسارية كتباً وصحفاً ومجلات، العدو الأساسي للعقل الرقابي. في المقابل لم يكن التيار الإسلامي قد تحوّل بعد إلى عدو للدولة حتى نهاية السبعينات. لذلك كانت كتب سيد قطب وحسن البنا وأبي الأعلى المودودي، وكتب الجماعات الإسلامية، تُطبع وتباع في تونس بشكل واسع وحرّ، وكذلك الدوريات الإسلامية السياسية مثل مجلة المعرفة، لسان حال الجماعة الإسلامية، التي ستتحول لاحقاً إلى حركة النهضة.
رقابة التعددية الشكلية: المُقنّعة والمخاتلة
بعد عقد السبعينات الصاخب، وصل النظام السياسي الحاكم إلى قناعة في بداية الثمانينات باستحالة مواصلة الحكم ضمن شروط تاريخية جديدة بالطريقة نفسها التي حكم بها البلاد منذ الاستقلال. فقد تكسّرت علاقات الولاء والطاعة بين النظام وقاعدته الاجتماعية واحدةً تلو الأخرى، من خلال فك الارتباط مع جناحه الطلابي (1972) ثم ذراعه النقابي العمالي (1978) وجزء من نخبه المؤسسة (ولادة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين). من وحي هذه الأزمة، توجّه بورقيبة نحو إعادة فتح المجال السياسي تحت سقف النظام، من خلال إعادة التعددية السياسية وحرية إنشاء الصحف. في هذا السياق، بدأت تَظهر دور النشر الخاصة على نحو واضح والصحف الخاصة والحزبية، ولم تعد الدولة الجهة الوحيدة التي تُنتج الخطاب الثقافي وتوزّعه، حيث كَسرَت النخب المعارضة احتكار نخب النظام للمجال العام. فقد شكّل بروز قوى مضادة للنظام السياسي بشكل علني وقانوني، بداية ظهور قضايا الرقابة في تونس، سوءاً من الناحية الإعلامية أو القضائية. ولعلّ أشهر قضية رقابة حدثت في تلك المرحلة هي منع ومحاكمة المجموعة القصصية “عباس يفقد الصواب”، للروائي حسن بن عثمان، في عام 1986. فقد حكم على الكاتب بثلاثة أشهر سجن مؤجلة التنفيذ بتهم الاعتداء على الأخلاق الحميدة وتهديد الأمن العام، بسبب قصة خيالية ضمّتها المجموعة. رغم أن الكتاب لم يقع توزيعه حينذاك، حيث لم يطّلع عليه أحد سوى عمال المطبعة، ولكن القضاء اعتبر مجرد وجود الكتاب في المطبعة يوفر ركن العلنية الموجبة للعقاب[4].
مع وصول زين العابدين بن علي إلى السلطة عام 1987، أخذَت الرقابة أشكالاً أكثر حدةً. كان الصراع الوجودي القائم بين بن علي والحركة الإسلامية يلقي بظلاله على الرقابة نفسها. لم يعد اليسار يشكل التناقض الرئيسي للنظام، بل الإسلاميون. لذلك توجّهت الرقابة أكثر نحو منشورات الجماعات الإسلامية الدعائية والسياسية وحتى الدينية. يروي أنس الشابي، مسؤول الرقابة على الكتب في تونس خلال فترة التسعينات وقائع ذلك التحول قائلاً: “بعد سنة 1987، وبعد أن ابتدأ التيار الإسلامي في الظهور واكتساح الساحات العموميّة عدت إلى ما كنت فيه سابقاً من مقاومتهم، فكتبت عشرات المقالات، وهو ما لفت انتباه السلطة خصوصا الأستاذ أحمد خالد كاتب الدولة للتربية أيامها، والذي أصبحت بصورة غير رسمية مستشاره في المادة المذكورة. ولمّا أصبح وزيرا للثقافة نقلني معه إلى ديوانه وكلّفني برقابة الكتاب فقمت بجولة في مكتبات المطالعة العمومية في كامل أرجاء الوطن وسحبت منها مئات العناوين الحركية. وشيئا فشيئا أصبحت الرقيب في وزارة الثقافة. ثم أذن الرئيس بن عليّ بنقلي ونقل لجنة الكتاب إلى وزارة الداخلية وبذلك أصبحت صاحب القرار في كل ما ينشر داخل البلاد ويستورد من خارجها باستثناء منشورات وكالة الاتصال الخارجي التي تعود بالنظر لعبد الوهاب عبد الله مسؤول ملف الإعلام والكتب التي تتعلق بالزعيم أو بالرئيس”[5].
ويَعتقد الشابي، بوصفه يسارياً ومعادياً للتيار الإسلامي، أن الرقابة بالنسبة له في تلك المرحَلة كانت: “واجبًا نضالياً قمت به على أتم الوجوه لأني حاصرت المنشورات الإخوانية والكتب الدعائية التي تُفسد العقول وتمنعها من الانفتاح على الآخر المختلف، وقد انحصر اهتمامي في متابعة المنشورات التي تمتلك قدراً كبيراً من طلاوة المبنى وفساداً في المعنى ككتابات محمد الغزالي والمودودي وسيد قطب والقرضاوي وغيرهم. وحتى بالنسبة لهؤلاء كان المنع منحصراً فيما هو إسلامي دعائي تحريضي، لسيّد قطب كتاب جمع فيه مقالاته التربوية سمحت برواجه وكذا كتب حسن حنفي باستثناء كتابه عن الدين والثورة في مصر لأنه أشاد فيه بالجهاديين وبقتلة السادات بحيث لم يتناول منعي اسم صاحب الكتاب بل المضمون بالدرجة الأولى” مشيراً بالقول إلى أن : “الرقابة ليست فعلاً أخلاقياً حتى توصف بالسمعة السيئة أو الحسنة بل هي في حالتي واجب نضالي مساهمة مني من موقع القرار حماية للمجتمع. هذه الأولى والثانية اللجوء إلى المنع هو السبيل الذي تلجأ إليه الأنظمة العاجزة عن مواجهة تتار العصر وهُمّجه لأن عوامل التحصين الذاتي ممثلة في انخراط النخبة للدفاع عن مكتسبات المجتمع نشراً للمعارف الحديثة مفقودة كما أن ضعف التكوين المعرفي والسياسي لمن يعيَّنون في المسؤوليات الأولى يدفع إلى اختيارهم أيسر السبل وأسهل الطرق لمواجهة المشكلات. ففي تونس مثلاً لم يكن أمام الهوان الذي عليه النخبة سوى الرقابة لمنع الأذى (…). في عهد بن عليّ كانت الدولة نفسها عاجزة عن أن يكون لها جناحها الثقافي إلا من بعض المرتزقة والانتهازيين وهو ما يفسّر عجزها عن المواجهة الفكرية للإسلاميين والغريب حقاً أن يجد هؤلاء من يدافع عنهم داخل المنظومة الحاكمة. ولهذا السبب لم يطلْ مقامي في الرقابة. فحالما انتهت المحاكمات ووقع الاتجاه إلى الإعداد لدورة رئاسية جديدة حتى أنهيَ إلحاقي بوزارة الداخلية وانقطعت صلتي برقابة الكتاب سنة 1999.”
الرقيب معارضاً
لم تكن الرقابة في تونس المستقلة حكراً على السلطة، بل كان للمعارضة نصيبها من ممارسة هذه الرقابة على نفسها. شكّلت بيئة التنظيمات السرية ذي الطبيعة الحديدية المغلقة الفضاء المناسب كي يمارس الأمين العام أو الرئيس أو أمير الجماعة نوعاً من القمع على أعضاء التنظيم، من خلال غياب الديمقراطية الداخلية وحتى ممارسة الرقابة في شكلها غير المباشر كتحديد نوعية القراءات التي يجب على العضو أو المناضل أن يقبل عليها أو يُحجم عنها. وكذلك الرقابة المباشرة على ما ينشر في الدوريات التي يصدرها التنظيم. وهذا صنيع لا يختلف فيه اليسار عن اليمين. بالرغم من غياب نماذج موثقة لما حصل داخل تنظيمات اليسار، فإن بعض الأمثلة الرقابية داخل الحركة الإسلامية تكشف عن طبيعة العلاقات التي كانت قائمةً داخل الأحزاب المعارضة، وهي علاقات تستبطن قمع النظام لتعيد إنتاجه داخل التنظيمات.
في نهاية سبعينات القرن الماضي، بدأت بوادر الأزمة التنظيمية داخل الجماعة الإسلامية في الظهور إلى العلن بين تيار متشبث بالنموذج الإخواني، فكراً وتنظيماً يقوده أمير الجماعة راشد الغنوشي، وتيار أكثر تقدمية يطرح أسئلةً نقدية تجاه الإخوان وفكرهم بقيادة أحميدة النيفر. لكن قوة حجة التيار التقدمي، خلفَت ذعراً داخل قيادة التنظيم وخشيةً من تفكك الجماعة، فاستعملت جميع وسائلها لعزل العناصر النقدية اجتماعياً وسياسياً وأخلاقياً. وكذلك اعتمدت على سلطتها التنظيمية لممارسة الرقابة. يقول احميدة النيفر مسترجعاً وقائع ذلك الصراع: “انتقل النقاش من الحوارات الداخلية إلى أعمدة مجلة المعرفــة وكنت بحكم رئاستي لهيئة التحرير قد كتبت مجموعة من المقالات تحت عنوان من أين نبدأ؟ وبعض الافتتاحيات تساءلت فيها عن جدوى اعتماد الفكر الإخواني في عملية البناء الفكري لمناضلي الحركة. كان واضحاً أن خطّ تحرير المجلة في ذلك الوقت غير مقبول لبعض العناصر داخل الحركة وقد تطوّر الخلاف إلى درجة أنني فوجئت بحذف جزء من إحدى افتتاحيات المجلة قبل نشرها دون علمي (فقرة حول فكر حسن البنا). فقد ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ بعض كتاباتي في مجلة المعرفة خروجاً عن الخط الرسمي للتنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتقييم الحركات الإسلامية بالمشرق، وبالخصوص حركة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية بباكستان. كما ﺍﻋﺘُﺒﺭﺕ مقالاتي بمثابة نشر غسيل الحركات الإسلامية، وكان من المفروض ﻓﻲ نظرهم أن تتم إثارة هذه الجوانب النقدية في إطار ضيّق وليس على صفحات الجرائد”.[6]
أما النموذج الثاني لهذا الرقيب الإسلامي المعارض فهي الملابسات المريبة التي حفّت بمصير مئات النسخ من المذكرات التي أصدرها المنصف بن سالم، القياديّ في الحركة الإسلامية وقائد المجموعة الأمنية (الجهاز السري الأمني – العسكري للحركة)، والتي كشف فيها ملف المجموعة تفصيلاً منذ تكوينها وحتى لحظة الخروج من السجن، مروراً ببرنامجها وعناصرها وأهدافها وخصّص لها فصلاً بعنوان «مجموعة الإنقاذ الوطني» امتد على 17 صفحةً. هذا الكتاب الذي صدرَ في العام 2013، تحت عنوان «سنوات الجمر شهادات حية عن الاضطهاد الفكري واستهداف الإسلام في تونس»، طبع بن سالم منه مئات النسخ، في الكويت بمعرفة أحد أصدقائه الأكاديميين. لكن الكتاب اختفى تماماً من المكتبات بمجرّد وصوله إلى تونس. ويُشير بن سالم في خاتمة كتابه إلى أنه قد أجرى ثلاث مراجعات له، بين 2002 و2013، والواضح أنه لا يغطّي كثيراً من الوقائع الهامة في تاريخ الحركة الإسلامية والواضح أيضاً أن مقص الرقيب الحزبي قد لعب في بعض صفحاته. ورغم ذلك فإن جهة ما، في مكان ما، ليس لها مصلحة في أن تُذاع تفاصيل قصة المجموعة الأمنية، لم تسمح بتوزيعه في تونس وتم سحب النسخ الخمسين ألف سريعاً من أسواق تونس ومكتباتها. ويبدو أن بن سالم لم يستشر قيادة الحركة وبادَر من نفسه لطبع الكتاب عندما كان وزيراً للتعليم العالي. فبحسب الصحبي العمري، الذي كان رفيقاً للكاتب في المجموعة الأمنية، فإن الدائرة الضيقة لبن سالم قد خانته وسرّبت خبر وصول نسخ كتابه لقيادة التنظيم الحزبي. وهكذا إذاً تلاشتْ مئات من نسخ الكتاب فجأة من الوجود. فلا أحد يعلم لماذا تم ذلك؟ أو أين تبخرت النسخ وكيف؟ لكن من حسن حظّ الكاتب وحظّنا أن أحدهم قد قام بتصوير نسخةٍ ووضعها على الإنترنت قبل أن يطوف عليها طائف من “جهاز الرقابة” في حركة النهضة، لتتحول إلى وثيقة شاهدةٍ على جزء مهم وجدلي في تاريخ الحركة الإسلامية وهو عملها العسكري السري.[7]
الغباء رقيباً
خوف النظام السياسي من أي صوت مخالف أو كلمة شاذةٍ عن السردية العامة للدولة، جعل منه أسيراً لهوس مرضي تجاه الكلمة المطبوعة. الشك والريبة كانا هما الأصل في التعامل مع أيّ وثيقة منشورة. لذلك أصبح تعامل السلطة مع الكتاب مفارقاً أحياناً لحدود العقل، إلى جانب تكليف أطراف لا تملك الحدّ الأدنى من الثقافة لتقييم الكتاب، كالجهاز الأمني. خلّف ذلك سردية طويلةً وساخرةً من قصص كثيرة تكشف عن غباء تعامل السلطة مع الكتب في إطار ممارسة دورها الرقابي.
من ذلك ما يرويه الكاتب حسن بن عثمان حول وقائع محاكمة كتابه “عباس يفقد الصواب” عام 1986. حيث كانت المرافعات القضائية تدُور حول قصة خيالية عنوانها “السلطان”، وهو الاسم الذي يطلق على العروس في تونس خلال فترة الزفاف، فيما كانت السلطة تعتقد أن الكاتب يقصد السلطان بوصفه الحاكم. يقول بن عثمان :”لم أصمت وطالبت بتسريح الكتاب وحاصرت وزير الثقافة آنذاك أينما ذهب وجدني أمامه بشعار “أفرجوا عن عباس” – وعباس هو بطل الكتاب- فدعاني الوزير الحبيب بولعراس واستمع إلى تفاصيل القضية، ووعدني برفع الحظر عن الكتاب. بعد أيام اتصل بي مصطفى عطية وقال لي إن الوزير أرسل في طلبي وقال لي إنني أشتم بن علي في الكتاب، بوصفه وزير الأمن وأنا في الكتاب أتحدث عن زفاف في بلدتي وفي تقاليدنا نطلق على العروس صفة “السلطان” ونعين له “وزيراً” ولكن استوجب الأمر مع بطلي تعيين وزير للأمن وقع اختياره في ضوء المواصفات التالية “غليظ، أحمق، متبلّد الحس وليس له من رهافة سوى في أذنيه” واعتبرت هذه الكلمات وصفاً دقيقا لبن علي. وبعد لقاءات ومباحثات اشترطوا نشر الكتاب بحذف هذه العبارات وهو ما تم”.[8] ومن طرائف غباء الرقيب أيضاً ما حدث في عام 2011 عندما منعت السلطات الأمنية عرض كتاب “نهاية الداعية” للكاتب المغربي عبد الإله بلقزيز، في معرض الكتاب. لاعتقاد راسخ عندها بأنه يتحدث عن “الداعية الإسلامي”، مع أن عنوانه الفرعي كان: “الممكن والممتنع في أدوار المثقفين”، وحين أصبحت القصة محرجةً سمحتّ بترويجه في الدورة الموالية من دون تعليل أو اعتذار. فيما ينقل أنس الشابي في ذكرياته عن الرقابة أن مخبراً سرياً كتبَ تقريراً في منتصف التسعينات بعد جولة في معرض الكتاب حول كتاب “ينتقد السلطات العربية”، ليكتشف الشابي عندما وصلته النسخة أن الكتاب فيه وصفات مختلفة للسلَطَة (Salade) من كل الدول العربية. أو ما حاولت أن تقوم به وزارة الثقافة، في أوّل حكومة منتخبة بعد الثورة، باسم “تحصين الثورة” من منع توزيع كتاب “الوجه الخفي لثورة تونس” للكاتب المازري الحداد، في معرض الكتاب، لو لا تدخل اتحاد الناشرين.
يفتقد الرقيب أحياناً منطقاً عقلانياً في ممارسة دوره. لكن الرقابة كانت دائماً فعلاً واعياً تقوم به السلطة للسيطرة على المجال العام فعلاً وقولاً. لكن هذه السيطرة بدأت منذ سنوات تفقد شروطها التاريخية. فلئن كانت الدولة قادرة على إدارة السيطرة في المجال العام الواقعي، إلا أنها غير قادرة على إدارتها على نحو شامل في المجال العام الافتراضي. لذلك يصبح الحديث عن الرقابة نوعاً من العبث، إذا كانت السلطة ستمنع كتباً من باب الواقع فيعود إليها من نافذة الإنترنت، أكثر عدداً وأوسع انتشاراً.
[1] – Samia El Mechat -Les libertés publiques à l’épreuve du Protectorat en Tunisie (1884-1940) -Dans: les administrations coloniales، XIXe-XXe siècles: Esquisse d’une histoire comparée-Presses universitaires de Rennes – 2009 -p. 213-227.
[2] – Michel Camau – Tunisie au présent : Une modernité au-dessus de tout soupçon ? p. 9-49 – Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans, Éditions du CNRS – 1987.
[3] – Abir Kréfa – Écrits, genre et autorités : Enquête en Tunisie – ENS Éditions- 2019.
[4] مقابلة مع الكاتب حسن بن عثمان – جريدة الصريح التونسية 13 فيفري 2011.مقابلة خاصة مع أنس الشابي 22 أفريل 2022
[5] مقابلة خاصة مع أنس الشابي 22 أفريل 2022
[6] – حميد النيفر في حوار شامل مع مجلة الإصلاح: من الجماعة الإسلامية إلى الإسلاميين التقدميين -مجلة الإصلاح، ص 6، العدد 56 -السنة 3 -/29 ماي 2014.
[7] أحمد نظيف -المجموعة الامنية: الجهاز الخاص للحركة الاسلامية في تونس وانقلاب 1987 – ص 36 -ديار للنشر والتوزيع 201.
[8] مقابلة مع الكاتب حسن بن عثمان – جريدة الصريح التونسية 13 فيفري 2011