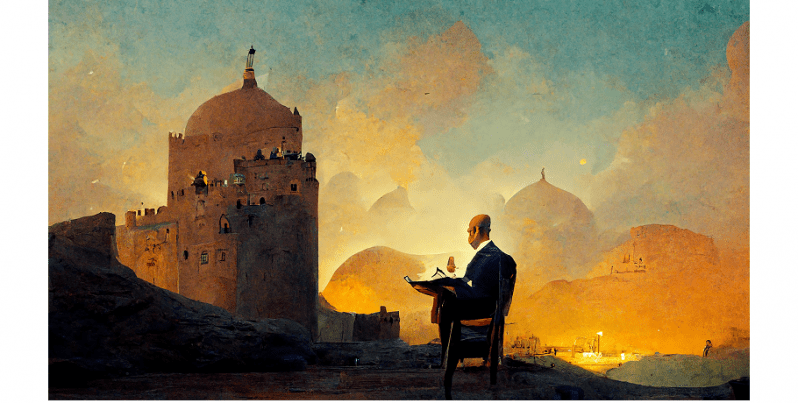أحيانا تكون الصورة أبلغَ من أيّ كلام. في ليلة 17 أوت المُظلمة، من “القاعة الزرقاء” في قصر قرطاج، ختمَ قيس سعيّد دستورهُ، وحيدًا أمام الكاميرا باستثناء حارسيْنِ يظهران على الشاشة من حين لآخر. “موكبُ” ختمِ الدستور كان وفيّا لمسار صياغته كما لخياراته، التي خضعتْ جميعها لإرادة الرئيس المنفرد. فكان بامتياز، دستور “الغُرَف المظلمة” الذي “قدّ على المقاس”، على عكس النصوص التي لا ينفكّ الرئيس عن نعتها بذلك، وعلى رأسها دستور 2014. فكيف مررْنا، بعد عشر سنوات من الثورة والانتقال الديمقراطي، من عقدٍ اجتماعي أثمرهُ صراعٌٍ مجتمعيّ مُضنٍ ونقاشٌ ديمقراطيّ صاخب وتوافقٌ سياسيّ نادر، إلى دستورِ الفرد، بكلّ ما للعبارة من معنى؟
هل كانت الدّودة، كما في المثل الفرنسي، تنخُر الثمرة التي كانت تبدو لنا في المراحل الأولى من نموّها، فسقطت بسهولةٍ لافتة أمام أوّل رئيسٍ نهم للسلطة المطلقة؟ هل كانت البناية بطبعها آيلةً للسقوط، فانهارتْ أمام مُقاولٍ مغمور حالمٍ ببناءٍ جديد يدخل به التاريخ؟ وهل ما نشهده هو نهايةٌ ضروريّة لمرحلةٍ لم تكن قابلةً للاستمرار؟ هل هيَ حلقةٌ في مسارٍ ثوريّ لا يزال مشتعلًا، بل وكما يسوّق له البعض، هزّةً ارتداديّة للزلزال الثوري الذي حدث ذات ديسمبر من سنة 2010، أتتْ لتُجهزَ على “الانتقال الديمقراطي المغشوش” الذي حاول احتواءه؟ أم أنّها ببساطةٍ وأدٌ للثورة وعودةٌ لما قبلها من حكمٍ فرديّ وقبرٌ للحلم الديمقراطي؟
هذا المقال هو قبل كلّ شيء محاولةٌ لفهمِ ما جرى، عبر إعادة ترتيب قِطع “البازل” كي تتّضح الصورة التي لا تزالُ مبهمةً أمام الكثيرين. محاولةٌ تُراوحُ بين السّرد التاريخي، والبحثِ عن المعنى وسط فوضى الأحداث، ومساءلةِ السرديّات المهيمنة حولها. فهي بالضرورة انتقائيّة -وهل يمكنُ أصلا ألاّ تكون كذلك؟-، وهي في الآن ذاته، تحملُ موقفًا لسنا نحاول إخفاءه وراء حيادٍ زائف. فكلّ قراءة هي بالضرورة متحيّزة، ونحن متحيّزون للقيَمِ التي نؤمن بها وندافع عنها، ومن أهمّها الديمقراطية.
إزاء من أجّل استحقاق الفهمِ والتحليلِ أمام إلحاح المواجهة السياسيّة، ومن، في الضفّة المقابلة، اختبأ وراء التحليل كي يتهرّب منها، نحن نسعى إلى أن يكون الفهمُ جزءًا من المقاومة. فإذا كانت المواجهة من دون التفكير في ما أوصلنا إلى هذه الحالة تؤدّي إلى حالةٍ من النكران وإلى تكرار الأخطاء بما يخدم مصلحة السلطة التي يُراد مواجهتها، فإنّ الاكتفاء بالتفسير والتنسيب قد يتحوّل بسهولةٍ إلى تبريرٍ واصطفاف، عن وعيٍ أو من دونه، وراء دكتاتوريّةٍ ناشئة.
تحوّل دستور 2014 من مكسبٍ ديمقراطيّ إلى عُملةٍ وجهها الأوّل “النهضة”، ووجهُها الآخر “الأزمة”
من أين نبدأ الحكاية؟
للرئيس سرديّتُه التي لم يتردّد في دسترتها في التوطئة. ثمّ جاءتْ “المذكّرة التفسيريّة” لتفصّلها وتشرحها. سرديّةٌ لا تُضاهي بساطتَها سوى خطورتُها: حدثَ “انفجار ثوريّ” في 17 ديسمبر 2010، صادرتهُ نُخَبٌ سياسيّةٌ لصالحها بواسطة “انتقالٍ ديمقراطيّ” مغشوشٍ يرمزُ له تاريخ 14 جانفي، ليعُمَّ “الفسادُ والتفقير والتنكيل”، حتى جاء “تصحيح” المسار في 25 جويلية 2021، ليُنقذَ الدولة من “الانهيار”، ويفرضَ في إثر ذلك “التفكير في وضع دستورٍ جديد” يحملُ “روح الثورة” ويعبّر على “إرادة الشعب”. هكذا، كان الرئيس مضطرّا لإعلان الحالة الاستثنائيّة أمام انسداد كلّ الحلول، ثمّ مضطرًّا لكتابةِ دستورٍ جديد، محكومًا في ذلك بإرادةٍ تتجاوزه، بل تكادُ تكون إلهيّة. كان قيس سعيّد وفق سرديّته هو نفسه، في الآن ذاته، مُكرهًا وبطلاً.
قد تبدو هذه السرديّة، كما قناعةُ صاحبها بأنّه بصددِ “تصحيح مسارِ الثورة بل ومسارِ التاريخ”، مثيرةً للاستهزاء. لكنّها ليست مجرّد بروباغندا لجأتْ إليها سلطةٌ ذات مشروعيّة مهتزّة. تكمنُ خُطورة هذه السرديّة، قبل كلّ شيء، في تعبيرِها عن شعورٍ عميقٍ يسكنُ صانعها. فهو مؤمنٌ برسالتِه المقدّسة، مما يدفعُه للمضيّ إلى الأقصى في مشروعه، داهِسًا في طريقه كلّ ما يعترضُه. وهي في الآن ذاته، تسعى لإخفاء جوهر العمليّة، وهو فرضُ مشروعٍ شخصيّ لنظام الحُكم، لم يكن ممكتًا تمريره بالآليّات الديمقراطيّة.
كما تتأتى خطورة سرديّة سعيّد من أنّها، بغضّ النظر عن مدى انخراط الناسِ فيها، تتقاطع جزئيّا مع سرديّةٍ أصبحتْ مهيمنةً في السنوات القليلة الأخيرة، تعتبرُ عشريّة الانتقال الديمقراطي كتلةً واحدةً غير قابلة للتجزئة، تُختزل في “حُكم النهضة وحلفائها” وفي حالة التأزّم والشلل السياسي. هكذا يتحوّل دستور 2014، من مكسبٍ ديمقراطيّ إلى عُملةٍ وجهها الأوّل “النهضة”، ووجهُها الآخر “الأزمة”، ويصبحُ التوافق الدستوريّ جزءًا من “منظومة التوافق” التي حكمتْ بعد انتخابات 2014، بعد تحالفِ نداء تونس، ثمّ تحيا تونس المنشقّ عنه، مع حركة النهضة، ويُحمّل النصّ التأسيسي كل أوزار الممارسة السياسيّة[1]. هيمنةُ هذه السرديّة جعلتْ دستور 2014 فريسةً سهلةً، سقطتْ من دون مقاومةٍ تُذكر.
لا شكّ أنّ عوامل فشلِ الانتقال الديمقراطي كثيرةٌ ومتنوّعةٌ، ليس أقلّها افتقاره لعمقٍ اجتماعيّ وعدم اقترانه بأيّ تغييرٍ إيجابي ملموس في السياسات العموميّة. لكن إذا ضيّقنا زاوية النظر، برز لنا مساران متوازيان يفسّران إلى حدٍّ كبيرٍ سهولة انهيار البناية الدستوريّة. مسارُ رئيسٍ حاملٍ لمشروع، مستعدٍّ لهدمِ كلّ شيء في سبيل تأسيسه الجديد، ومسارُ ممارسةٍ سياسيّةٍ تسارعت وتيرتها بعد انتخابات 2019، أنهكتْ البناء وشوّهت صورته وغذّت خطابًا عامّا مشيطنًا له، فعبّدت طريق الهدمِ.
متلازمة 23 أكتوبر
أصرّ الرئيس المهووسُ بالتاريخ والتواريخ، على أن لا يحمل دستوره تاريخ ختمه، وإنما تاريخ 25 جويلية، يوم “تصحيح مسار الثورة والتاريخ”. لا تقتصرُ رمزيّة 25 جويلية على المسار الذي بدأ بالاستفراد بجميع السّلط بتعلّة “الحالة الاستثنائيّة” وانتهى بالاستفتاء على دستورٍ جديد. فهو أوّلاً تاريخ إعلان الجمهورية الأولى، سنة 1957. وثانيًا تاريخ اغتيال الشهيد محمد البراهمي في 2013، الذي استغلّ مع بقيّة الاغتيالات السياسيّة والحوادث الإرهابيّة، لتبرير وصم عِقدِ الانتقال الديمقراطي بعبارة “العشريّة السوداء” المستوحاة من الحرب الأهلية الجزائريّة في التسعينات. وثالثًا، تاريخ وفاة الباجي قائد السبسي، أوّل رئيسٍ منتخبٍ مباشرةً وديمقراطيّا، وصاحب دور البطولة في مسار الانتقال الديمقراطي بمختلف مراحله، بغثّه وسمينه.
لكنّنا سننطلق من تاريخٍ آخر، قدْ لا يقلّ أهمّية في التاريخ السياسي التونسي، وهو 23 اكتوبر.
23 أكتوبر 2011 هو موعدُ أوّل انتخابات ديمقراطيّة في تاريخ البلاد، أفرزتْ مجلسًا تأسيسيًّا متنوّعًا مع أغلبيةٍ نسبيّةٍ لحركة النهضة (41% من المقاعد). انتهى المسار التأسيسيّ، بعد مخاضٍ عسير دام أكثر من سنتيْن، وصراعٍ محتدم شاركتْ فيه معظمُ القوى الحيّة للمجتمع، إلى توافقٍ واسع حول مجمل النقاط الخلافيّة بالدستور وحول طريقة الخروج من المرحلة الانتقاليّة. لكنّ نفس التاريخ هو، في رواية أخرى عادتْ لتهيمَنَ بعد 2019، تاريخُ إمساك الإسلام السياسي السلطة من دون استعدادٍ لمغادرتها.
أمّا في رواية قيس سعيّد، الذي دخل السياسةَ في 2011 كمعارضٍ لخيارات المرحلة الأولى من الانتقال الديمقراطي، فهو تاريخُ الانقلاب على الثورة عبر انتخاباتٍ “زوّرتْ العقول” لأنّها لم تعتمدْ المقترح الذي دافع عليه صُحبَة الصادق بلعيد حينها، وهو الاقتراع على الأفراد، قبل أن يتطوّر المشروع مع رفاقٍ جُددٍ من “قوى تونس الحرّة”، ليشكّل “البناء القاعدي”. مشروعٌ يرى فيه أصحابه ليس فقط ترجمةً للثورة، التي تجاوزتْ الأحزاب السياسيّة وانطلقتْ تلقائيّا من الجهات الداخليّة، وإنما السبيل الوحيد لتحقيق الديمقراطيّة، ليس في تونس فقط بل في العالم بأسره[2].
في الذكرى الثامنة للانتخابات التأسيسيّة، يوم 23 أكتوبر 2019، أدّى قيس سعيّد اليمين ليصبحَ رئيسًا للجمهوريّة، أمام نوّاب البرلمان المغادِر، المجتمعين لآخر مرّة في قصر باردو. كان معلومًا أنّ المشروع الوحيد لقيس سعيّد هو البناء القاعدي، الذي يحتاج تنزيله قبل كلّ شيءٍ إلى تعديلات دستوريّة تحتاج هي الأخرى إلى أغلبيّة الثلثيْن في البرلمان. لكنّ أحدًا لم يكنْ يتوقّعُ حينها أنّ الجمهورية الثانية قد أوشكتْ على السقوط، أو أنّ قصرَ باردو سيُغلقُ بعد أقلّ من سنتينِ بالمدرّعات العسكريّة. لم يكن أحدٌ يتوقّعُ أنّ رصاصة الرحمة ستأتي من ذلك الرئيس الذي بصدد أداء اليمين على احترام الدستور، والذي عرِفهُ التونسيون كمدرّسٍ للقانون الدستوري وانتخبوهُ بناءً على صدقه ونزاهته.
بعد ذلك بثلاثة أسابيع، افتتح البرلمان المُنتخب حديثًا جلساتِه، بانتخابِ زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، رئيسًا لهُ، بفضلِ تحالفِه مع حزب قلب تونس، على عكس وعود كليْهما إبّان الحملة الانتخابيّة. شهدتْ الجلسة ذاتها رفضَ زعيمة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي أداء كتلتها اليمين بطريقة جماعيّة وراء الغنوشي، معطيةً لمحةً أوّليةً عن مشهدٍ تكرّر عشرات المرًات طيلة الأشهر الموالية. لم تكنْ رئاسة الغنوشي تفصيلًا بسيطًا في هذا المشهد. فقد أصبحتْ، بالنظر إلى ما يمثّله من رمزيّةٍ سياسيّةٍ مستفزّةٍ للكثيرين، كلّ وسائل مواجهتهِ مُربحة شعبيًّا، وهو ما استفادتْ منه موسي وحزبها كثيرًا. كما أضعفتْ هذه الرمزيّة قُدرتَه على فرض النظام داخل البرلمان. وزادتْ طريقة تسييره للبرلمان الأمور تعكيرًا، بانحيازهِ إلى الأغلبيّة التي يتزعّمها وبحثهِ المستمرّ على منافسة رئيس الجمهوريّة في صلاحياته[3]. أصبحَ الغنوشي، عبر رئاسته البرلمان بالإضافة إلى الدور الذي لعبه في إسقاط حكومة الفخفاخ ثمّ حماية حكومة المشيشي، يُجسّد في شخصه النظام السياسيّ، فجرَّه معهُ في مُنحدرِ اللاشعبيّة.
بين قرطاج وباردو، عادَ مخيالُ 2011 ليُسيطرَ على المشهد. مشهدُ رئيسٍ حالم بنظامٍ سياسيّ بديل يُترجم في تصوّره روحَ الثورة ويحملُ خلاصًا للإنسانيّة جمعاء ووريثةٍ للنظام القديم أدركتْ أنّ أفضل طريقة ليس فقط للوصول إلى السلطة، وإنما أيضا للثأر من الثورة والانتقال الديمقراطي، هي اختزالهما في “حُكم الإخوان”، وجُمهورٍ معادٍ للإسلام السياسي، استعادَ شبحَ 2011 حينَ كانت حركة النهضة في أوجّ قوّتها بأكثر من 1،5 مليون صوت، فقرّرَ أنّ المشكل ليس في ضعفِ اللاعبين السياسيّين الذين يفترضُ أن يمثّلوه، وإنما في قواعد اللعبة في حدّ ذاتها.
التأزيم المُمنهج، تمهيدًا للتفجير
تحوّلت الفكرة إلى مسلّمةٍ في الخطاب العامّ: دستور 2014 حاملٌ بطبعه لعوامل التأزّم، بسبب ثنائيّة السلطة التنفيذيّة، وعدم إعطاء رئيس الجمهورية الصلاحيّات المناسبة لمشروعيّته الانتخابيّة، وتغوّل البرلمان على بقيّة السلطات. اجتمع قِصرُ الذاكرة مع قصور الثقافة السياسيّة، لتُختزلَ الأزمة في النصّ وتُختزل الممارسة الدستوريّة في الفترة التي أعقبتْ انتخابات 2019. نسيَ الكثيرون أنّنا جرّبْنا خلال الخماسيّة الأولى لتطبيق الدستور (2014-2019)، الفرضيتين الأساسيّتين اللتيْن يقوم عليهما النظام السياسي التونسي، أسوةً بالنظام شبه الرئاسي في فرنسا، وهما توافق رئيس الجمهورية مع الأغلبية البرلمانيّة، أو التعارض بينهما، من دون أن تعرف البلاد أزمةً دستوريّةً تُذكر. قَبِل رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصّيد بدور ثانويّ بالمقارنة مع رئيس الجمهوريّة الراحل الباجي قائد السبسي، ثم اكتفى هذا الأخير، عندما فقد الأغلبية داخل البرلمان لصالح تحالف يوسف الشاهد والنهضة، بصلاحياته الدستورية. فلم يكن فشلُ الخماسيّة الأولى ناتجًا عن معوقاتٍ دستورية، وإنما عن بؤس المنظومة السياسيّة، حيثُ لم يكن الحكم وسيلة لتطبيق مشروع سياسي بل كعكةً تقتسم. أمّا مسؤولية القوى السياسيّة عن عدم إرساء المؤسسات الدستورية، التي ساهمتْ في هشاشة بنيان الجمهورية الثانية، فهي لا تنفي أنّها، على الأقلّ في مجال النظام السياسي، أبدتْ حدًّا أدنى من الالتزام بالقاعدة الدستورية، وهو ما غاب تمامًا بعد 2019.
أفرزتْ انتخابات 2019 مشهدا غير تقليديّ: رئيسٌ منتخب من خارج الطبقة السياسيّة، بعد دور ثانٍ نافس فيهِ نبيل القروي فكان بمثابة الاستفتاء على الأخلاق، وبرلمانٍ مشتّت يحكُمه تحالفٌ يتفادى إعلان نفسه لكي لا تُحرج أحزابهُ أمام أنصارها.
أضاعتْ حركة النهضة الفرصة الدستوريّة لتشكيل حكومةٍ تختار رئيسها، بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي في اختبار الثقة، في سيناريو لعبتْ فيه الحسابات الداخلية للحركة دورًا هامّا. انتقلت الكرةُ إلى ملعب رئيس الجمهورية، الذي لم يلتزِم بدوره الدستوري في إقامة مشاوراتٍ مع الكتل النيابيّة واختيار الشخصيّة الأقدر، وبدأ من حينها يلتهمُ السلطة ويعبث بالدستور عبثًا. اختار سعيّد الياس الفخفاخ رئيسًا للحكومة، ففرضَ على النهضة تحالفًا لم يكنْ زعيمها يسعى إليه، فلم يتأخّر في إسقاطه في أوّل فرصة. عادتْ الكرةُ إلى ملعبِ الرئيس، بعد أن فرض على الفخفاخ الاستقالة قبل مواجهةِ لائحة اللوم. اختار سعيّد هشام المشيشي رئيسًا لحكومة أرادها خاضعةً له، فتحالفَ الأخير مع الأغلبية النيابية المناوئة للرئيس، الذي ردّ على إقالة الوزراء المحسوبين عليهِ، وأبرزهم وزيريْ الداخليّة والعدل، بإدخال البلاد في أزمة دستوريّة حادّة. تعلّل الرئيس بقدسيّة اليمين الدستوريّة، كي يرفض أداء الوزراء الجدد الذين نالوا الثقة اليمين أمامه، نظرًا لشبهات الفساد التي قال أنّها تحيط ببعضهم. استمرّت الأزمة من دون حلّ، لتُضاف إليها أزمةٌ ثانية، بعد رفض الرئيس ختم تنقيحات قانون المحكمة الدستوريّة التي كانت تهدف لتسهيلِ إرسائها، وتعليلِ ذلك بفوات الأجل الدستوريّ لذلك. ثمّ أزمةٌ ثالثة، بعد إصرارِ الرئيس على أنّ صلاحيّة القيادة العليا للقوات المسلّحة تشمل كذلك القوات الأمنيّة.
لم تكن هذه الأزمات ناتجةً عن غموضٍ في النصّ الدستوري أو توزيعٍ غير عادلٍ للصلاحيات، وإنما عن عبثٍ سياسيّ وسوء نيّة واضحة لا يمكن لأيّ نصٍّ أن يمنعها. فبوجود رئيس جمهورية يريد أن يحكم من دون أن يُنافس في الانتخابات التشريعيّة، مقابل زعيم حزبٍ يسْعى للمسْك بكلّ خيوط السلطة انطلاقًا من رئاسة البرلمان، تصبحُ الأزمة حتميّة. بل أنّ رئيس الجمهورية لم يحاولْ أصلا استعمال الآليات الدستورية لفضّ صراعه مع المشيشي الذي اختاره بنفسه، عبر طرح تجديد الثقة أمام البرلمان، وفضّل اللجوء إلى تأويلات خطيرة ولادستوريّة لتأزيم الوضع أكثر فأكثر.
يبقى أنّ غياب إمكانيّة حلّ البرلمان من دون انخراطه في العملّية، عبر عدم منح الثقة للحكومة، ساهم، بالإضافة إلى طريقة تعامل الفاعلين السياسيّين، في انسداد أفق الحلّ. لكن، حتى إن افترضنا وجودها واستعمالها من طرف رئيس الجمهورية، هل كانت الأزمة ستحلّ إذا ما أصرّ هذا الأخير على خيار عدم دعم قائماتٍ في الانتخابات التشريعيّة السابقة لأوانها؟ الجواب هو طبعًا بالنفي.
ظلّت الأزمة الدستوريّة من دون أفقٍ للحلّ، مع رفض الرئيس دعوات الحوار، لتُضاف إلى ذلك صعوباتٌ اقتصاديّة كبيرة وموجةٌ وبائيّة عجزت الحكومة عن مواجهتها حتّى أصبح الموتى بالمئات أسبوعيًّا. شرع الرئيس في توجيه سهامه نحو دستور 2014، فدعا في منتصف جوان 2021 إلى إجراء حوارٍ وطنيّ يقود إلى نظامٍ سياسيّ جديد، ثمّ اقترح بعد ذلك بأيّام على الأمين العامّ للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، العودة إلى دستور 1959 مع إدخال بضعة تعديلات. أخيرًا، استقبل الرئيس يوم 22 جوان رضا شهاب المكي، أحد أبرز رفاق مشروع البناء القاعدي، وتناول لقاؤهما حسب بيان الرئاسة، “التصوّرات التي تمّ تداولها منذ أكثر من 10 سنوات والتي أثبتتْ الأحداث المتلاحقة على المستويين السياسي والاقتصادي ملاءمتها للوضع لا في تونس فحسب بل في العالم بأسره”. هكذا، قرّر سعيّد المرور إلى السرعة القصوى في تطبيق مشروعه، من دون أن تثير أيٌّ من تصريحاته ردّة فعل بحجم خطورتها. في الأثناء، تكثّفت الزيارات الرئاسيّة للثكنات العسكريّة والأمنيّة في إطار الصراع على ولاء الأجهزة الأمنيّة. صراعٌ حسمهُ سعيّد لصالحه في 25 جويلية 2021 عند إعلانه الحالة الاستثنائيّة استنادًا إلى الفصل 80 من الدستور، واستعماله على نقيض نصّه وفلسفته، لإقالة الحكومة و”تجميد” البرلمان تمهيدًا لتغيير نظام الحكم بصفةٍ دائمة.
الانحراف بسلطة الاستثناء
كان سيناريو استعمال الفصل 80 قد تسرّب منذ شهر ماي 2021، في شكل رسالةٍ سرّيةٍ موجّهة إلى مديرة الديوان الرئاسي[4]. لكنّ ذلك لم يحدّ من حجمِ المفاجأة. حتّى دعوات التظاهر في 25 جويلية التي بدأت قبل أسابيع عديدة، رغم ما أثارته من أسئلة حول هوية الداعين لها[5]، لم تؤْخذْ كثيرًا على محمل الجدّ. تظاهر بضعة آلاف نهارًا، استهدفوا بالأخصّ مقرّات حركة النهضة وقصر البرلمان، ليخرج الرئيس ليلاً ويعلن الحالة الاستثنائيّة، في كلمة موجّهة إلى الشعب، محاطًا بقيادات عسكريّة وأمنيّة.
أصرّ رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية 2021 على أنّه بصدد تطبيق الدستور، وتحديدا الفصل 80 منه. لم يوضّح الرئيس ماهيّة الخطر الداهم الذي دفعه لذلك، واكتفى بالإشارة تلميحًا إلى الأزمة الوبائيّة، قبل أن يطفو على السطح تأويلٌ يعتبر البرلمان نفسه خطرًا داهمًا أو، كما يحلو للرئيس أن يسميّه، “خطر جاثم”. لا نحتاج هنا إلى التذكير بعدم احترام الرئيس في 25 جويلية 2021 الشروط الدستوريّة لتفعيل الفصل 80[6]، ولا إلى عدم دستوريّة كلّ ما أعقب ذلك من تدابير، وأبرزها حلّ البرلمان في 30 مارس 2022، بعد عقده جلسةً افتراضيّة. ما هو أخطر من كلّ ذلك، هو استعمال الاستثناء لتغيير القاعدة، وتحويل الاستئثار المؤقت بالسلط إلى وضعٍ دستوريٍّ دائم. إذ لا يتعلّق الأمر باستفرادٍ مؤقّتٍ بالسلطة، بغضّ النظر عن شرعيّته ومشروعيّته، وإنما باستغلال ذلك لإحداث تغييرٍ دستوريٍّ دائم بإرادةٍ منفردة، خدمةً لمشروع شخصي.
حرصَ الرئيس خلال السنة التي أعقبتْ استفراده بالسّلط، على تصدير النصوص التي يختمها، والتي نسفتْ القواعد والمؤسسات الدستوريّة نسفًا، بـ”الاطلاع على الفصل 80 من الدستور”. بلغ الاستخفاف بالعقول درجة الاستناد إلى دستور 2014 في الأمر الرئاسي الذي نشرَ مشروع الدستور الجديد. في الأثناء، ظلّ بعض أساتذة القانون من مناصري الرئيس يبرّرون جميع التدابير “الاستثنائية” التي يأخذها، بأنّنا في “دكتاتورية دستورية”، متناسين أنّ فلسفتها تقوم على حماية النظام الدستوري وليس تغييره.
أمّا محاولات تأصيل انقلاب سعيّد بنظرية كارل شميت للسيادة، التي يختزلها البعض في مقولة “صاحب السيادة هو ذاك الذي يقرّر الحالة الاستثنائيّة”، فهي لا تصمد بدورها أمام تمييز شميت نفسه بين الدكتاتورية السيادية، غير المنظمة دستوريّا، والدكتاتورية المنتدبة أو الموكلة، وهي حالة الفصل 80[7]. فإذا كانت الدكتاتورية السياديّة بطبعها سلطة تأسيسيّة، فإنّ ذلك لا يشمل أبدًا الحالة الاستثنائيّة المقيّدة بالدستور. فالهدف من الحالة الاستثنائيّة، سواءً في الدستور التونسي أو في الدساتير المقارنة كما في مؤسسة الدكتاتور الرومانيّة المستوحاة منها، ليس سوى “عودة السير العادي لدواليب الدولة”. فهي إجابةٌ دستوريةٌ على وضعيةٍ يصبح فيها السير العاديّ للسّلط غير ممكن، كي لا يسقط النظام الدستوري برمّته أمام الخطر الداهم. بقي أنّه، في روما نفسها، هنالك من لم يحترم الوكالة وفلسفة مؤسسة الدكتاتور وانقلب على الجمهورية ليؤبّد حكمه، وأبرزهم يوليوس قيصر. لذلك تسعى الدساتير عامّة إلى وضع ضماناتٍ أمام هذه الصلاحية، ممثلة أساسًا بوجود سلطتيْن مضادتيْن وهما البرلمان والقضاء الدستوري[8]. غياب المحكمة الدستورية سهّل بلا شكّ هذا الانحراف، لكنّ العامل الحاسم يبقى دائما، في روما القرن الأول قبل الميلاد كما في تونس القرن 21، موازين القوى على الميدان، ليس فقط شعبيّا، وإنما بالأخصّ في علاقة بولاء الأجهزة المسلّحة. يكفي أنّ جميع القرارات الهامّة، بدءًا ب 25 جويلية، وصولًا إلى حلّ البرلمان، ومرورا بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، جاءتْ في اجتماعاتٍ مع قياداتٍ أمنيّة و/أو عسكريّة. فمهما حاول الرئيس تحصين أفعاله بتأويلاتٍ دستوريّة، فنحن بوضوح أمام قانون القوة، لا قوّة القانون.
لا سلطة إلاّ للرئيس، وحدهُ لا شريك له
لم يُفصح الرئيس في 25 جويلية عن نيّته تغيير الدستور. كان هاجسهُ الأوّل ضمان استفراده بالسلطة وتفادي اعتباره في الداخل والخارج انقلابًا. استقبل في اليوم الموالي ممثّلي منظّمات المجتمع المدني وأكّد لهم “تمسّكه الثابت بضمان الحقوق والحريات واحترام دولة القانون والمسار الديمقراطي”. وعودٌ لم تُلزْم بطبيعة الحال إلاّ من صدّقها. استعمل الأزمة الوبائيّة وتوفّر التلاقيح بدعمٍ خارجيّ كي يعزّز شعبيّته. مدّد تجميد البرلمان، الذي حدّده هو نفسه عند إعلان الحالة الاستثنائيّة بشهرٍ، إلى “إشعار آخر”. قبل ذلك بأيّام، أغلق البوليس هيئة مكافحة الفساد، من دون أيّ تفسيرٍ سياسيّ أو نصٍّ قانونيّ.
أمام المطالبة الداخلية والخارجيّة بخارطة طريق، اكتفى سعيّد بالتأكيد على أن “لا عودة إلى الوراء”، حتّى صدر الأمر 117 في 22 سبتمبر 2021، فعلّق واقعيّا الدستور وكان بمثابة تنظيم مؤقّت للسلط، وكرّس استئثار الرئيس بالسلطتيْن التنفيذيّة والتشريعيّة. لم يرَ أساتذة القانون العامّ المشاركون في صياغته، الصادق بلعيد ومحمد صالح بن عيسى وأمين محفوظ، أيّ إشكالٍ في تعليق الدستور بأمرٍ رئاسيّ، بل احتفوا بالإشارات المتكرّرة في النصّ إلى الحقوق والحريات، في غياب أيّ ضماناتٍ مؤسساتيّة لحمايتها. على العكس من ذلك، ألغيتْ الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، وحُصّنت مراسيم سعيّد من أيّ رقابة ممكنة. أشار الأمر 117 إلى إصلاحاتٍ سياسيّة في شكل “تعديلات” قد تطال الدستور، يعدّها الرئيس بمساعدة لجنة، ثمّ تُعرض على الاستفتاء. بذلك، لم يكتفِ الرئيس بالسلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة، وإنما نصّب نفسه كذلك سلطةً تأسيسيّة.
لم يبقَ من السلط المضادّة سوى القضاء، فبدأ مسلسل استهدافه. تحوّل القضاء إلى محورٍ قارّ في خطابات الرئيس، يحمّله مسؤوليّة تعطّل مسار المحاسبة والتطهير، ويَكيلُ له الاتّهام تلو الآخر. استغلّ الرئيس ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد ليعلن قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء، من مبنى وزارة الداخليّة. لم تكتفِ هيئة الدفاع عن الشهيدين بالتواطؤ مع الاستغلال السياسيّ للقضيّة، وإنّما ساهمتْ مباشرةً في تصوير المجلس الأعلى للقضاء، بل وكلّ هيكلٍ يدافع عن استقلال القضاء، كأداةٍ بين يديْ حركة النهضة. هكذا، لم يجد القرار، رغم خطورته، مقاومةً قادرةً على صده. وبعد أن عيّن الرئيس مجلسًا مؤقتًا كما يريده، سارع إلى تجاوزه والمرور إلى إعفاء القضاة مباشرةً بأمرٍ رئاسيّ، بناءً على وشاياتٍ أمنيّة. قرارٌ فضَحَ زيْفَ خطابِ مكافحة الفساد، بما أنّ معظم ضحاياه لا تتعلّق بهم أية شبهات فساد، وأكّد أنّ الرهان ليس سوى إخضاع سلطةٍ مضادّة لقصر قرطاج وللبناية الرمادية في شارع الحبيب بورقيبة[9].
لم يقتصر الرئيس على استعمال القضاء العسكري لملاحقة عددٍ من معارضيه، بل سعى إلى توظيف القضاء العدلي في ذلك، فلم يتردّد في مطالبته بمتابعة رئيسٍ سابقٍ من أجل تصريحاتٍ رأى فيها خيانةً للبلاد، أو نوابٍ شاركوا في جلسة عامّة افتراضيّة، بتهمٍ إرهابيّة تصلُ عقوبتها إلى الإعدام. ربّما يجادل البعض، بأنّ القمعَ لم يكن شاملاً، وأنّ حريّة التعبير لا تزال قائمةً، وأنّ الأصوات المعارضة لم يتمّ إخراسُها. لكنّ هذه الحجّة تتناسى أنّ الاستبداد مسارٌ تدريجيّ، وأنّ “الحرّية” التي لا توجد ضمانةٌ مؤسساتيّةٌ لها، فتبقى رهينة حسابات السلطة، لا يمكن اعتبارها مضمونة. ليس أدلّ على ذلك من الرقابة الذاتيّة التي بات يمارسها الكثيرون، ومن عودة آخرين إلى استعمال تطبيقاتٍ مشفّرةٍ على هواتفهم في أحاديثهم السياسيّة، فقد عاد مناخ الخوف الذي خلْناه قد ولّى من دون رجعة.
وبما أنّ كلّ مؤسسات الانتقال الديمقراطي هي بالضرورة وفق الرئيس فاسدةٌ وغير محايدة ما دام لم يعيّنها، جاء الدور على هيئة الانتخابات، فعوّض الرئيس بسلطة المراسيم الهيئة المنتخبة، بهيئةٍ معيّنة من قبله، خاضعةٍ لإرادته، لتشرف على الاستفتاء الذي قرّر الرئيس أن يتوّج به مساره التأسيسي.
مكياجٌ ديمقراطي لمسار الفرد
رغم أنّ نيّة تغيير الدستور واضحةٌ وصريحة منذ الشهر الأخير قبل إعلان الحالة الاستثنائيّة، إلاّ أنّ الرئيس تفادى بعناية التصريح بها في الأسابيع الأولى بعد ذلك، خوفًا من أن يؤكّد ذلك الطابع الانقلابي للعمليّة. كان أمرُ 22 سبتمبر 2021 أول إعلانٍ رسميّ على التوجّه إلى تغييرٍ دستوريّ، لكنّه اكتفى بالحديث عن “تعديلاتٍ” تُعرض على استفتاء. حاول سعيّد إضفاء طابعٍ شرعيّ على هذا التمشّي عبر تأويلٍ دستوريّ، يعلّي مبدأ سيادة الشعب على الإجراءات الدستوريّة لتحقيقه. لا نحتاج هنا لتِبيان تهافت هذه الحجّة “القانونيّة”، التي تُفقد الدستور وقواعد تنظيم السلطة قيمتها، طالما جاز لفاعلٍ سياسيّ أن يقفز عليها ويغيّرها باسم الشعب.
في 9 ديسمبر 2021، أيّاما قليلة قبل إعلان خارطة الطريق للفترة القادمة، صرّح سعيّد أن “المشكل في تونس دستوري”، بما أنّ “دستور 2014 لم يعد صالحًا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنّه لا مشروعيّة له”. هكذا، بكلّ سهولة، نزع الرئيس كلّ مشروعيّة عن دستورٍ صاغه مجلسٌ تأسيسيّ منتخبٌ ديمقراطيًّا، بتوافقٍ واسعٍ لم يخرج عنه سوى بضعة نوّاب كانوا يزايدون على حركة النهضة بخصوص تنازلاتها في المسائل الهوَوية، وبعد مشاركة واسعة، بالضغط والمراقبة والاقتراح، من جلّ القوى المدنيّة.
جاء المسار التأسيسي الرئاسي على نقيض ذلك تمامًا. أعلن الرئيس عن خارطة الطريق في خطاب 13 ديسمبر، بمراحل أربعة: استشارة الكترونيّة شعبيّة، تؤلّف مخرجاتها لجنةٌ يعيّنها الرئيس، لتعرض مشاريع الإصلاحات الدستورية والانتخابيّة على استفتاء في 25 جويلية، على أن تجرى انتخابات تشريعيّة جديدة على قاعدتها في 17 ديسمبر 2022.
كانت الاستشارة، التي لم يرد ذكرها في أمر 22 سبتمبر، الطريقة التي وجدها الرئيس لإظهار دعائم مشروعه كأنّها نابعة من القاعدة. جاءت أسئلتها، التي احتكر صياغتَها الرئيسُ وفريقه، موجّهةً بطريقة تؤدّي لا محالة إلى أضلاع البناء القاعدي. لم يمنعْ ضعف المشاركة فيها، رغم تسخير الوسائل العموميّة لذلك، الرئيسَ من التشبّث بنجاحها وبضرورة الالتزام بمخرجاتها… طالما كانت لصالحه. فعندما جاء خيار “وضعُ دستورٍ جديد”، في المرتبة الرابعة في السؤال حول الإصلاحات المطلوبة، وراء إصلاح القانون الانتخابي وقانون الأحزاب، وأيضا وراء الاكتفاء بتعديلات لدستور 2014، لم تعُد النتائج ملزمةً. فالرئيسُ يُريد دستورًا جديدًا يصحّح به مسار التاريخ.
ثمّ جاء حوار الرئيس، استجابةً لمطلب خارجيّ ملحّ، مفرغًا من أيّ معنى. فكان حوارًا بين المساندين للمسار، حدّد سعيّد مخرجاته سلفًا بنتائج الاستشارة، وأصرّ على طابعه الاستشاريّ، فالقرار يبقى دائما بين يديْ الرئيس وحده. حملتْ “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريةٍ جديدة” كما مختلف لجانها، صفة “الاستشاريّة”، فتكرّرت الكلمة 27 مرّة في مرسومٍ بـ 30 فصلا. قاطع اتحاد الشغل حوارًا صوريّا، على عكسِ منظماتٍ أخرى ارتضتْ لنفسها دوْرَ الدّيكور التشاركي. رفَضَ عمداءُ كليات العلوم القانونيّة المشاركة في المسرحيّة، فلم يمنعْ ذلك الرئيس من المضيّ في مشروعِه من دون احترام المرسوم الذي أصدره بنفسه ولا تعديله. أمّا الأساتذة الذين رافقوا سعيّد منذ الأشهر الأولى، لاهثين وراء دور بطولةٍ لم يكن من نصيبهم خلال الانتقال الديمقراطي، فلم يتفطّنوا إلى حجم الخديعة، إلاّ عندما صدَر مشروع دستور الرئيس، ليعبّر عن إرادته هو وحده، متجاهلا تمامًا مشروعَهم. فلم يغيّر تبرّؤهم منه شيئًا، عدا فضح ما كان واضحًا منذ البداية، وهو أنّ الدستور الجديد لا يمكن أن يكون سوى تعبيرٍ عن الإرادة المنفردة للرئيس.
حجّة “سيادة الشعب” تقوم على مغالطة تخلط بين الإرادة الشعبيّة والرأي العامّ
جاء الاستفتاء كآخر طورٍ في مسرحيّةٍ رديئة الإخراج. لم يتصوّر الرئيس، لا في خطاباته ولا في نصوصه القانونيّة، غيرَ فرضيّةٍ واحدةٍ، وهي الموافقة على المشروع. كما لم ينصّ على حدٍّ أدنى للمشاركة. فالمطلوب من الاستفتاء لم يكن تعبير الشعب عن إرادته الحرّة، وإنّما شرعنة الأمر الواقع وإضفاء طابعٍ ديمقراطيّ على مشروعٍ فرديّ. لا حاجة لنقاشٍ عامّ حول مشروع الدستور، فإرادة الشعب لا تحتاج تداولا ديمقراطيّا، بل تتحقّق حين تتماهى مع إرادة الرئيس الذي يجسّده. نظّم الرئيسُ استفتاءً على المقاس، فوضع القواعد كما يريد ولم يكلّف نفسه عناء احترامها. ليس ذلك جديدًا، بل هو حال جلّ الاستفتاءات التي تأتي بإرادة فوقيّة، وفي سياق غير ديمقراطيّ، فتكون “أداةً من أدوات الدكتاتورية المتنكّرة”، على حدّ تعبير سعيّد نفسه.
وخلافا لما تعهّد به في الأمر 117 وفي خطاب 13 ديسمبر، اقتصر الاستفتاء على الدستور. لم يعرض الرئيس معه القانون الانتخابي، الذي سيستكمل بموجبه تنزيل مشروع البناء القاعدي. تفادى الرئيسُ بعنايةٍ تبنّي مشروعه وعرضه كاملًا على الرأي العامّ، وفضّل تنزيله بانتهاج أسلوب المواربة والتقسيط، فهو يعرف جيّدا ما يمكن أن يثيره من مخاوفَ واحترازات. وبما أنّ المشروع هو في ذهن أصحابه، “الديمقراطية الحقيقيّة”، نُبل الغاية يبرّر كل الوسائل، مهما تناقضتْ مع الشعار الديمقراطي.
تفادى الرئيس إظهار نيّة تغيير الدستور مباشرة بعد 25 جويلية، خوفًا من تأكيد الطابع الانقلابي للعمليّة
ليس الشعب من أراد دستورًا جديدًا
منذ إعلان الحالة الاستثنائيّة في 25 جويلية، وقعَ وصمُ كلّ خطابٍ يدافع عن الشرعيّة الدستورية ب”الشكلانيّة”، التي تمنع أصحابها من إدراك الطابع السياسي للحظة، وتبقيهم أسرى النصّ. رأى العديد من المثقفين في 25 جويلية ثأرًا للسياسة من نزعة القوننة التي طغتْ عليها طيلة “العشريّة” التي أعقبتْ الثورة. استعملتْ جدليّة القانوني والسياسي، أو الشرعيّة والمشروعيّة، كما لو تعلّق الأمر بغرفتيْن يفصل بينهما باب، لا تدخل إحداهما إلا بالخروج من الأخرى. ما غاب عن الكثيرين، ليس فقط التشبّث بالقيم الديمقراطيّة أو بعلويّة الدستور، وإنّما أيضا التحليل السياسي لموازين القوى. فهل كان ممكنًا، إزاء رئيس يستأثر بكلّ السلطة وبشعبيّةٍ هامّة، أن يكون الدستور شيئًا آخر غيرَ ما يريده الرئيس لنفسه؟ كيف نتصوّر أنّ الرئيس، وقد أصبح سلطةً تأسيسيّة، سيتخلّى ببساطة عن مشروعه الذي ينادي به منذ السنوات الأولى للثورة، وعن النزعات الاستبداديّة التي تحضر دائمًا، بدرجة أو بأخرى، لدى من يمسك بالسلطة طالما لم يجد من يوقفه؟ ومتى كانت إعلانات النوايا والتعهّدات المطمئِنة الصادرة عن أصحاب السلطة، ضمانةً للديمقراطيّة؟
يبقى أنّ الحجّة الأبرز لاستبعاد علويّة القانون وتبرير تغيير الدستور، كانت “الشعب”. الشعب الذي خرج في 25 جويلية، وظلّ مساندًا في جزء كبير منه للرئيس، ثمّ خرج وصوّت في الاستفتاء، ولفظَ “العشريّة” بغثّها وسمينها. لكنّ هذه الحجّة تقوم على مغالطةٍ كبرى، لا تميّز بين الإرادة الشعبيّة، التي تتمظهر إمّا في ثورةٍ شعبيّة، أو في صناديق الاقتراع في إطار قواعد اللعبة الديمقراطيّة، من جهة، والرأي العامّ، من جهة أخرى. باستطاعة الشعوب أن تُسقط دساتيرها، وهذا ما حصل في تونس منذ 11 سنة، بعد ثورةٍ شعبية، وحراكٍ متواصل في ساحة القصبة وغيرها من الشوارع والساحات، أدّى بعد شهريْن من رحيل بن علي إلى تعليق دستور 1959. وهو أيضًا ما حصل في التشيلي منذ ثلاث سنوات وفرض تغيير دستور بينوشيه. فهل هذا ما حصل يوم 25 جويلية 2021؟ الإجابة هي قطعًا لا. فلا المظاهرات نهارًا، ولا مظاهر الفرح الشعبيّ ليلا، يمكن اعتبارها “ثورة” أطاحتْ بالدستور. إذ ينبغي التمييز بين ثورةٍ شعبيّة تطيح بنظامٍ أو تفرض عليه تنازلات قد تصل إلى تغيير الدستور، وبين انخراطٍ شعبيّ لاحق في إجراءات رئاسيّة، مهما بلغ حجمه[10].
لا شكّ أنّ دور الرأي العامّ في الديمقراطيّات أصبح مركزيّا، وأنّ أحد مواطن ضعف الديمقراطية التونسية كان في عدم تقديرها لهذا الجانب، ممّا سمح بأن تصدّرَ المشهدَ السياسيّ أكثر الوجوه السياسيّة رفضًا من التونسيين. لكنّ الرأي العامّ لا يعوّض الإرادة الشعبية المعبّر عنها ديمقراطيّا. تجاهل الرأي العامّ قد يُضعف الديمقراطيّة، أمّا نكران الإرادة الشعبيّة عبر تغيير الدساتير بإرادة الفرد، فيُلغيها. أمّا الإرادة الشعبيّة المُعبّر عنها في نتائج الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، فلا تعطي هي الأخرى شرعيّةً لتغيير الدستور، بغضّ النظر عن أنّ التصويت لقيس سعيّد في الدور الثاني لم يكن على مشروعٍ وإنما لما رمز إليه من نظافة يد، بخاصة بالمقارنة مع منافسه. فلئن كان معلومًا أنّ مشروع سعيّد هو البناء الديمقراطي القاعدي، فهو بمجرّد ترشّحه لرئاسة الجمهورية وفق دستور 2014 وأدائه اليمين على احترامه، كان مُلزمًا بإخضاع مشروعه للضوابط والآليات الدستورية. أمّا استغلال تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والوبائي واشتداد الأزمة السياسية التي ساهم بدوره بشكل كبير فيها، للاستفراد بكلّ السلط وتغيير الدستور، فقد ينجح كأمرٍ واقع، لكنّه ليس تعبيرًا مشروعًا عن الإرادة الشعبيّة، مهما لقى قبولًا داخل الرأي العامّ، ومهما تعدّدت محاولات إلباسه ثوبًا ديمقراطيًّا.
إذا كان تغيير الدساتير، حسب أرسطو في كتاب السياسة، يكون “تارةً بالعنف وتارةً بالخدعة”[11]، فإن تغيير دستور 2014 كان بكليْهما. لا شكّ أنّ ضعف الحصيلة الاجتماعيّة للانتقال الديمقراطي، وبؤس المنظومة السياسيّة التي ورثناها عن عقود من التصحّر السياسيّ، سهّلت سقوط البناء الدستوريّ الديمقراطي. لكنّ البناء لم يسقطْ تلقائيّا تحت وقع تناقضاته ولا تحت ضغط الشارع، وإنما بفعل فاعل. فهو نتيجة مباشرة لتضافر عنصريْ “العنف”، عن طريق القوة العسكريّة والأمنيّة، و”الخدعة”، عبر اعتماد أسلوب مخاتل يدّعي تطبيق الدستور لتسهيل الانقضاض عليه.
لم يسقط البناء الدستوري تلقائيّا تحت وقع تناقضاته ولا تحت ضغط الشارع، وإنما بفعل فاعل
نشر هذا المقال في العدد 25من مجلة المفكرة القانونية – تونس. لقراء مقالات العدد اضغطوا على الرابط ادناه
جمهوريّة الفرد أو اللاجمهوريّة
[1] مهدي العش، كي لا نحمّل الدستور وزر السياسة، نشر في موقع المفكرة القانونية، جانفي 2022.
[2] مهدي العش، الصحبي الخلفاوي، سامي بن غازي، “الرئيس يريد”، تناقضات البناء القاعدي ومخاطره، ورقة بحثيّة للمفكرة القانونيّة، جويلية 2022.
[3] أنظر مهدي العش، “أسئلة حول صلاحيات رئيس البرلمان التونسي: عندما يتجاوز الطموح السياسي الصلاحيات القانونية”، نُشر في موقع المفكرة القانونية، جوان 2020.
[4] David Hearst, Areeb Ullah, Top secret Tunisian presidential document outlines plan for ‘constitutional dictatorship’, Middle East Eye, 23 May 2021.
[5] كريم مرزوقي، “25 جويلية.. يوم استثنائي حمّال دلالات كثيرة”، نُشر في العدد 23 من مجلّة المفكرة القانونية، زلزال ديمقراطيّة فتية.
[6] أنظر وحيد فرشيشي، “إعلان 25 جويلية 2021: هل قُبر دستور 27 جانفي 2014؟” ومهدي العش، “الرئيس التونسي يعلن حالة الاستثناء: خروج مؤقت عن الدستور؟”، نشرا في موقع المفكرة القانونية، أوت 2021، وفي العدد 23 من مجلة المفكرة القانونية، زلزال ديمقراطية فتيّة.
[7] حمادي الرديسي، 25 جويلية: أي انقلاب وأي دكتاتورية، نشر في جريدة المغرب، 12 فيفري 2022.
[8] Michel Troper, “L’état d’exception n’a rien d’exceptionnel”, in Droit et culture, Mélanges offerts au Doyen Yadh Ben Achour, CPU, 2008, p. 1150.
[9] أميمة مهدي، عزل القضاة من قبل سعيّد: مذبحة بسكاكين الداخلية، نشر في موقع المفكرة القانونيّة، جوان 2022.
[10] مهدي العش، “الاستشارة الوطنية: “مكياج” ديمقراطي للانقلاب على الدستور”، نشر في موقع المفكرة القانونية، جانفي 2022.
[11] أرسطو، السياسة، ترجمة أحمد لطفي السيّد، منشورات الجمل، الكتاب الثامن، الباب الثالث.