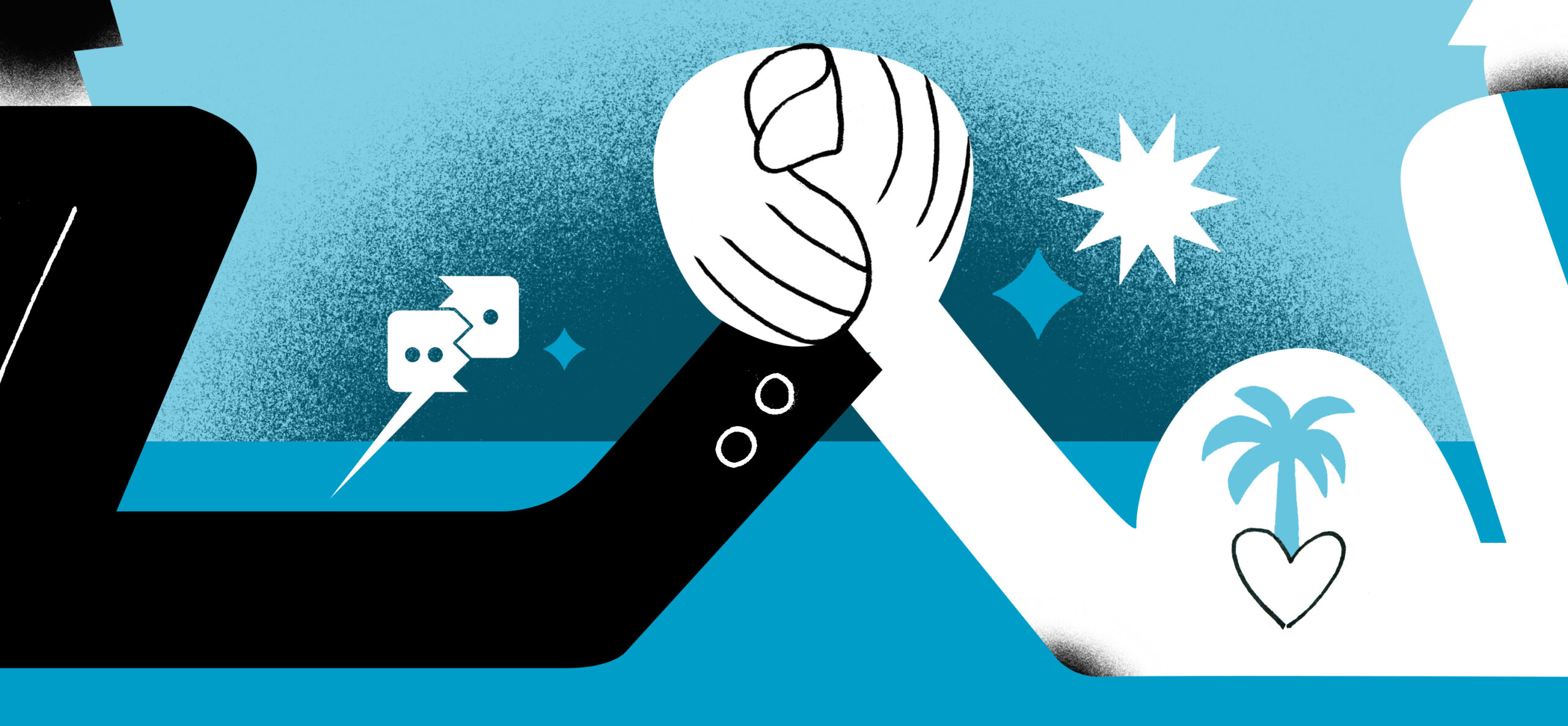بينما كانت شوارع معظم المدن التونسية تنتفض ضد حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 12 جانفي 2011، وتزامنا مع وصول المظاهرات لأول مرّة إلى قلب العاصمة التونسية في منطقة الباساج، كانت بلدة صغيرة في محافظة قبّلي في الجنوب التونسي، تضرب موعدا مع التاريخ. في تلك الليلة توجّه عشرات من أهالي جمنة ليسيطروا على هنشير المعمّر/ستيل بعد تراجع قوات الأمن وانسحاب الجيش. حركة لم يدُر بخلد من قاموا بها حينها أنها سترفع غطاء النسيان والتهميش الذي استمر لعقود عن بلدتهم، لتدير الرقاب نحو واحتهم التي ستتحوّل في السنوات اللاحقة إلى أيقونة في تجربة التسيير الذاتي والتشاركي وعاملا مُلهما في إعادة الاعتبار إلى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كبديل تنموي ممكن.
12 جانفي 2011؛ نهاية مظلمة وبداية معركة
في تلك الليلة، كان أهالي جمنة يجولون في الواحة لأوّل مرّة كملاّك حقيقيّين لأرض اغتصبتها منهم قوّات الاحتلال الفرنسية وحرمتهم منها لاحقا دولة الاستقلال. فقبل 89 سنة، وبالتحديد في سنة 1922، افتكّت السلطات الاستعمارية ضيعة واد المالح (هنشير المعمّر/ستيل) ومنحتها إلى مستوطن فرنسي يدعى «Merillon»، لتتولى تسييرها الشركة التجارية الفلاحية للجنوب التونسي “S.C.A.S.T” التي تأسست لاحقا لإدارة الأراضي المُغتصبة من التونسيين. ظلّت الأمور على هذا النحو سنوات بعد الاستقلال سنة 1956، حتى تاريخ الجلاء الزراعي في 12 ماي 1964. إلاّ أن الأرض الذي استعيدت من المحتّل، لم تعد لأهلها، بل تمّ إلحاقها بأملاك الدولة استعدادا لتركيز وحدة تعاضدية هناك. اكتتب الجمنيون في الهنشير بقيمة 40 ألف دينار بعد الاتفاق مع والي قابس حينها (جمنة وولاية قبلي كانت تتبع ولاية قابس إداريا وترابيا في ذلك الحين)، إلاّ أن الدولة اختارت تحويل المبلغ إلى مساهمات في مشاريع جهوية أشرفت عليها بنفسها حتى تاريخ تخلّي النظام آنذاك عن تجربة التعاضد وبداية حقبة اقتصادية جديدة في بداية سبعينيات القرن الماضي. ومرّة أخرى، يُنتزع هنشير المعمّر/ستيل من أيدي الأهالي بعدما فوّت فيه قسرا مجلس الوصاية إلى شركة ستيل التي تولّت إدارته إلى حدود الثاني من شهر مارس سنة 2002. فقد تمّ تسويغه للخواص تحت غطاء “شركات الإحياء والتنمية الفلاحية” وذلك بموجب عقد بين الدولة ممثلة في وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومستثمرين إثنين لمدّة 15 سنة، مقابل 14 ألف دينار تقريبا سنويا. صفقة عكست طبيعة مرحلة بأسرها كان الفساد أبرز عناوينها والخصخصة أهم ملامحها وإن على حساب المصلحة العامة. ففي الوقت الذي كانت تدرّ فيه 10800 نخلة ما يناهز المليون دينار سنويا من إنتاج التمور، كان نصيب الدولة لا يرقى إلى نسبة 1.5% من تلك الأرباح.
استمرّ الحال على ما هو عليه طيلة السنوات التسع اللاحقة، حتّى مهدّت اللحظة الثورية التي عاشتها البلاد في شتاء سنة 2011 الطريق لرفع مظلمة تاريخية عن بلدة جمنة التي ظلّت كغيرها من عشرات المدن والقرى خارج الحسابات التنموية للحكومات المتعاقبة. إلاّ أن ذلك التاريخ أيضا، وإن مثّل فجر حقبة جديدة في تلك الواحة، إلاّ أنه سيكون أيضا بداية الصراع مع دولة ما بعد 14 جانفي 2011، الراغبة في لملمة سلطتها وسلطويتها التي بعثرتها جموع المحتجّين، تحت شعار الهيبة.
معركة الرمزية: هيبة الدولة أم المشروعية الاحتجاجية؟
كان للسياق الثوري الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأربع اللاحقة إضافة إلى موجة الإغتيالات والاستحقاق الانتخابي في أكتوبر 2014 أثر في تأجيل معالجة ما حدث في جمنة ليلة 12 جانفي 2011 لدى مختلف الحكومات المتعاقبة. فسحة من الزمن أتاحت لأهالي القرية التنظّم ضمن جمعية أسسوها لغرض تقنين إدارة هنشير المعمّر/ستيل في فيفري 2011 واستغلال الأرض بأشكال جديدة ذات طابع تضامني تشاركي. لكن تغيّر المشهد السياسي بفوز حزب نداء تونس في الانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2014، وهو الذي رفع شعار “إعادة هيبة الدولة” كأحد مرتكزات برنامجه الانتخابي، سيجعل من جمنة التي استطاعت ترسيخ تجربة ناجحة، المثل الرادع الذي كان يبحث عنه النظام.
فقبل أسبوعين تقريبا من الموعد الموسمي لبيع محصول التمور لواحة جمنة في 18 سبتمبر 2016، أصدرت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بلاغا في غرّة سبتمبر لتحذّر من التعاقد بشأن هذه الضيعة أو منتوجاتها، معتبرة أن “ذلك التعاقد سيكون لاغيا” ومذكّرة أن الضيعة المذكورة راجعة لملك الدولة الخاص وأنه لا صفة لجمعية حماية واحات جمنة أو لغيرها في التصرف فيها قبل أن تلوّح بتتبع المشرفين عليها قضائيا. خطوة تلاها كاتب الدولة مبروك كرشيد لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتهديد مباشر لأعضاء الجمعية بأن السلطات الحكومية ستصادر المحصول السنوي لهنشير المعمّر/ستيل وتمنع انعقاد البتّة.
في الجهة المقابلة وعلى بعد 538 كيلومترا جنوب العاصمة، كان أهالي جمنة يعقدون اجتماعا شعبيا لمناقشة تهديدات كاتب الدولة التي بدت حينها صارمة ومنذرة بعواقب مأساوية في ظلّ إجماع آراء الأهالي على بيع المحصول ومواصلة إشراف جمعية واحات جمنة على تسيير الهنشير “بالأساليب القانونية طالما كان الباب مفتوحا للتفاهم، أو بالأساليب الثورية إن اقتضى الأمر”.
كان أهالي جمنة يجولون في الواحة لأوّل مرّة كملاّك حقيقيّين لأرض اغتصبتها منهم قوّات الاستعمار وحرمتهم منها دولة الاستقلال
لكن جمنة لم تكن تستعد لهذه المواجهة منفردة، حيث تكوّن ما يمكن تسميته بحزام المناصرة بالتزامن مع تطوّر الأحداث وتصاعد الجدل حول هذه القضية خلال الأسابيع الفاصلة بين إعلان تاريخ البتة وتنفيذها في 9 أكتوبر 2016. حلقة المناصرين التي توسعت شيئا فشيئا مفرزة ما سمي حينها الحملة الوطنية لدعم جمنة، والتي ضمت في صفوفها تشكيلات مختلفة من شباب الحراك الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى اصطفاف طيف من القوى السياسية الممثلة في البرلمان إلى جانب هذه القضية، استطاعت أن تكسر الحصار عن تلك البلدة وتنقل معركتها إلى مدارج المسرح البلدي في العاصمة تونس في خطوة أفشلت أهم تكتيكات النظام والمتمثلة في محاصرة الاحتجاجات في الجهات وتفكيك الجبهات، لعزل موجات الغضب خارج المجال السياسيّ المؤثّر وإحباط الحراك الاجتماعي عبر جرّه إلى التفاوض حول الجزئيّات والمطالب القطاعيّة أو الفئويّة الضيّقة.
زخم جعل من يوم 9 أكتوبر محطّة فارقة في مسار الصراع الذّي يخوضه مواطنو جمنة حيث تمّ بيع محصول التمور تحت حماية الأهالي، وبحضور قافلة مساندة قدمت من العاصمة وعدد من المدن الأخرى، حاملة وفودا من الحقوقيين والسياسيين وأعضاء من مجلس النواب وفنانين ونشطاء، وتحت أنظار السلطات التي لم تتدخّل في لحظتها بشكل مباشر بل اختارت أسلوب القمع الناعم خلال الأيام التالية. حيث عمدت وزارة المالية لاحقا إلى تجميد الحسابات البنكية لجمعية حماية واحات جمنة والتاجر الفائز بالبتة في 23 أكتوبر 2016. إجراء أسقطته محكمة الاستئناف في تونس بعد 8 أشهر تقريبا، حين أصدرت حكمها بإلغاء بطاقة الإلزام في حق التاجر سعيد الجوادي ورفع التجميد على حسابه، وإعفائه من الخطية المالية وتحميل جميع المصاريف القانونية للمكلف العام لنزاعات الدولة. لكن هذا القرار انعكس سلبا على محصول السنة اللاحقة وأحال عشرات العمّال على البطالة، وتجاوزت ارتداداته هنشير المعمّر/ستيل ليؤثّر على نشاطات الجمعيّة في مدينة جمنة. حيث حُرمت المدارس والجمعيات الخيريّة والمرافق البلدية والصحيّة من عائدات محصول سنة 2016. ورغم المظلمة، صمد أهالي جمنة الذين واصلوا الرهان على تجربتهم، وتواصلت المؤازرة من الحزام الداعم لقضيتهم، ليتمّ بيع المحصول في 02 نوفمبر 2017 تحت رعاية جمعية حماية واحات جمنة وبحضور ممثّلين عن الدولة. محطّة ثانية تجلّت رمزيتها هذه المرّة في اقتلاع اعتراف ضمني من النظام باستحالة إنهاء التجربة أو عودة الوضع إلى ما قبل سنة 2011. بعد ذلك التاريخ، بدأت سلسلة من المباحثات بين الطرفين لإيجاد حلّ يحفظ للدولة شيئا من “الهيبة” وللجمعية حقّها في استكمال المسار الذي بدأته ونجحت في فرضه، إلا أن هذا المسار لم يطل لتظلّ الأمور على ما هي عليه إلى حدود 08 جويلية 2020 إثر لقاء جمع بين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي والطاهر الطاهري رئيس جمعية “حماية واحات جمنة” وأعضائها لإعادة معالجة ملف هنشير المعمّر/ستيل وإيجاد حلّ لتسوية الوضعية العقارية للضيعة بصفة نهائية على إثر صدور قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في 17 جوان 2020.
واحة بحجم دولة
لم تكن بلدة جمنة بمعزل عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي البائس لمنطقة الجنوب الغربي التونسي الذي خلّفته سياسات دولة ما بعد الاستقلال وخياراتها التنموية. فمع بداية سنة 2011، كانت محافظة قبلي التي تتبعها جمنة تحتل المرتبة الأخيرة (24) على مؤشر جاذبية الجهات والمرتبة 14 على مؤشر التنمية الجهوية. كما بلغت نسبة البطالة في تلك المحافظة 25.3% ونسبة الفقر 18.5%، أما نسبة الأمية فناهزت 18.7% ولم يتمكّن سوى 10.1% من مواطنيها بلوغ مرحلة التعليم العالي. أما على مستوى العمل البلدي، فحلّت بلديات قبلي ومن ضمنهم بلدية جمنة في المرتبة 19 من إجمالي 24 على صعيد جودة ونجاعة الخدمات البلدية.
في ظلّ هذا الوضع ومع غياب الدولة، وعقم برامج الحكومات المتعاقبة، نهضت جمعية حماية واحة جمنة بأعباء تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي في البلدة عبر مواردها الذاتية المتمثّلة في هنشير المعمّر/ستيل بعد استعادته في جانفي 2011. خلال السنة الأولى لبداية التجربة، لم تكن جمعية حماية واحات جمنة تمتلك الموارد المالية الذاتيّة لتمويل الإنتاج، لذلك تمّ الالتجاء إلى الاقتراض من الجمعيات المائيّة وتاجريْ تمور بما قيمته ناهزت 142 ألف دينار. كما تمّ تنظيم حملة تبرّع بين أهالي جمنة كانت حصيلتها ما يقارب 34 ألف دينار. وقد وُجّهت هذه المبالغ لاستصلاح الأرض وإعادة تهيئة قنوات الريّ وشراء المعدّات والتجهيزات اللازمة. أما عائدات سنتي 2011 و2012 فقد غطّت بالكاد مصاريف الإنتاج وتسديد ديون الجمعية.
سنة 2014، مثّلت نقطة الإنطلاق الحقيقية لنجاحات تجربة جمنة. حيث ارتفعت العائدات بشكل كبير لتستقر منذ ذلك التاريخ عند معدّل 1.6 مليون دينار حتى خريف سنة 2019. هذه المداخيل تمّ استغلالها بالكامل بعد طرح المصاريف وأجور العملة – الذين ارتفع عددهم من 40 عاملا سنة 2011 إلى 152 عاملا قارا سنة 2019-لتنمية الجهة وسدّ الفراغ الذي خلفه تقاعس الدولة وتخليها عن دورها في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحيّة وحتّى الرياضيّة بقيمة جملية تجاوزت 1.726 مليون دينار خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2015 و2018. فقد بلغت قيمة مبالغ الدعم لصالح الجمعيات في المجال الاجتماعي أكثر من 119 ألف دينار، بينما ناهزت في المجال الرياضي 554 ألف دينار عبر دعم جمعية الفروسية وألعاب القوى في جمنة وقبلي ونادي الرماية ودار الشباب. أما على الصعيد التربوي، فقد بلغت المبالغ المرصودة لتحسين المنشآت التعليمية كالمعهد الثانوي والمدرسة الابتدائية والإدارة الجهوية للتعليم ومركز التكوين الفلاحي ومركز القاصرين ذهنيا ما يفوق 321 ألف دينار. كما بلغ اجمالي المبالغ الموجّهة لدعم القطاع الصحيّ 109.5 ألف دينار، صُرفت لتحسين المستوصف واقتناء سيارة اسعاف والتبرّع ب 10 آلاف دينار لاقتناء آلة للكشف عن سرطان الثدي. كما شمل تدخّل جمعية حماية واحات جمنة المجال الثقافي، فقد تمّ توزيع التبرعات على مختلف الجمعيات والمهرجانات الناشطة في هذا المجال بقيمة جمليّة تناهز 52.8 ألف دينار. أما إقتصاديّا، فيمثّل مشروع السوق البلدي المغطّى الذي ستعود مداخيله للبلدية، أحد أهم المشاريع الاقتصاديّة بتكلفة تناهز 391.6 ألف دينار.
إذن، لم تكن حالة جمنة إن جاز التعبير مجرّد لحظة رومنسية التفّ حولها الحالمون أو المؤمنون بجدوى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقدرته على إحداث تغيير على الصعيد التنموي، بل ارتكزت هذه التجربة على قاعدة الأرقام والإنجازات، لتلعب طيلة خمس سنوات دورا محوريا في تحسين واقع بلدة جمنة ودعم نسيجها الجمعياتي وحتى المؤسسات الحكومية التي كانت تخوض مع سلطتها المركزية حرب وجود.
لم تكن حالة جمنة لحظة رومنسية بل ارتكزت على قاعدة الأرقام والإنجازات
بعد الاسترداد واقتلاع الاعتراف؛ جمنة وتحدي الديمومة والتطوير
لم تكن عائدات بتّة سنة 2019 بذات المردود الذي تعوّد عليه القائمون على جمعية حماية واحات جمنة. فهي لم تتجاوز 1.3 مليون دينار مسجّلا انخفاضا يقدّر ب23.5% تقريبا عن عائدات سنة 2018 وهو ما سينعكس سلبا على التزاماتها الاجتماعية وتحضيرات الموسم الفلاحي اللاحق. وفيما أرجع رئيس الجمعية هذا التراجع إلى “إشاعة مرض النخيل بالسداية أو العنكبوتة وإحجام البنوك عن منح القروض الموسمية للتجار وكساد السوق المحلي”، إلا أن هذا لا ينفي أن تجربة جمنة وصلت إلى مفترق طرق يفرض إيجاد أجوبة عاجلة عن مصيرها وقدرتها على الصمود أمام مختلف الإشكاليات، سواء كانت طبيعية أو مرتبطة بقواعد العلاقة الإنتاجية. فقد ظلّت عملية تسويق تمور جمنة محافظة على مساراتها التقليدية المتمثلة في إنتاج المادة الفلاحية وتصريفها في شكل بتة يتولى بعدها التاجر تجميع المحصول وتسويقه نحو مشترين جدد قصد التحويل أو التعليب والتصدير، وبذلك تبقى الجمعية في أسفل ترتيب المستفيدين من عائدات الواحة وبؤرة معزولة وسط آليات السوق الكلاسيكية.
ورغم أن هذه النقطة بالذات كانت ماثلة في أذهان المشرفين على التجربة من خلال تقريرهم لسنة 2018، حين تعهدوا بجملة من المشاريع المستقبلية تتمحور حول إنجاز معمل تمور، تحويل منتجات التمر وتصنيعها، إنشاء معمل علب ورق مقوى ومعمل بلاستيك لحماية صابة التمور، إضافة إلى تولي عملية الجني والخزن، إلا أن هذه الطموحات تصطدم بواقع التوازنات المالية للجمعية والتزاماتها الاجتماعية خصوصا مع حجم المصاريف التي يمكن تبويبها ضمن “المساعدات الاجتماعية” لمختلف المؤسسات والجمعيات الناشطة في البلدة، والتي تستنزف تقريبا نصف مداخيل الواحة.
وتتعلّق النقطة الثانية بمدى ملاءمة المناخ الاقتصادي والاجتماعي المحلي وقدرته على استيعاب وتوفير الأرضية الصلبة لتأسيس نسيج من مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تتكامل فيما بينها ضمن حلقة مترابطة تلبّي حاجيات عملية الإنتاج والتسويق. خصوصا في ظلّ الدور الحاسم والمهم للجماعات المحلية في دعم وتعبئة الاعتمادات المالية لفائدة مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وهنا يمثّل وضع بلدية جمنة على سبيل المثال عائقا أساسيا أمام تطوير تجربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في البلدة. حيث تعاني من عجز مالي ناهز 503 ألف دينار سنة 2019، إضافة إلى ما سلف استعراضه من مؤشرات تعكس واقع المحافظة ككل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
إذن، وإن نجحت جمعية حماية واحات جمنة في اختبار النجاعة واقتلعت اعتراف النظام ولكنها بعد خمس سنوات، تجد نفسها أمام تحدّ جديد يتعلّق بسؤال الديمومة والقدرة على الاستمرارية والإنتقال من بؤرة أو جزيرة معزولة إلى مكوّن ضمن نسيج متكامل من هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بعلاقات إنتاج جديدة تسمح بأن يتحوّل الاقتصاد الاجتماعي من مجرّد متنفّس أو تجارب رائدة إلى رافد تنموي أساسي.
نشر هذا المقال بالعدد 19 من مجلة المفكرة القانونية | تونس | لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بين زمنين
لقراءة المقالة مترجمة إلى الإنكليزية