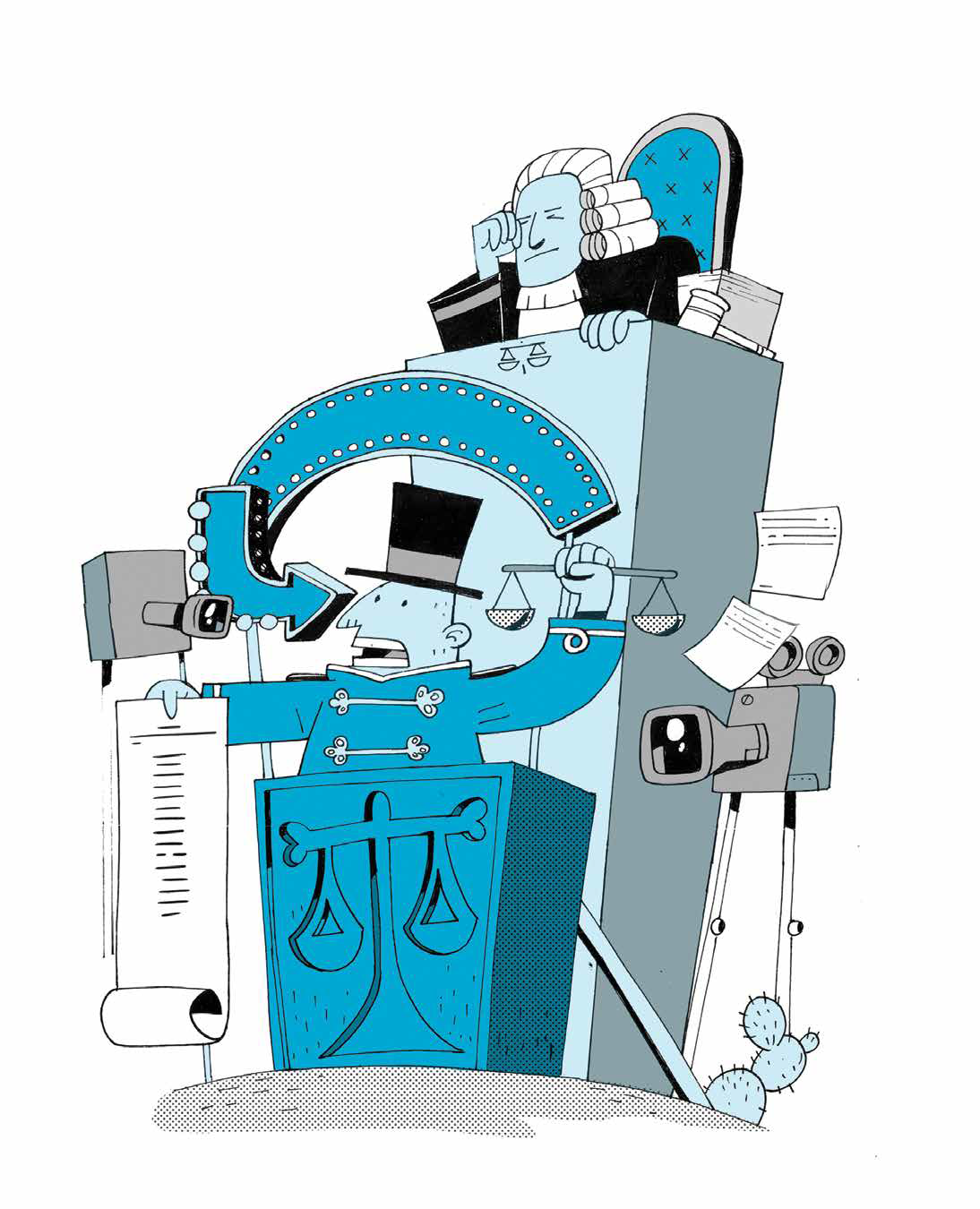“
احتاج الأمر نزاعا حول ملكية قناة تلفزيونية نشأت في الثمانينات أي في خضم حرب 1975-1990، ليقفز في وجه اللبنانيين مجددا ماضيهم الأليم. هذا الماضي الذي طالما جهد أعيان السلطة الحاكمة لطمس الفصول المؤلمة والخلافية منه كما المسؤوليات الناجمة عنه، إلا بالحدود الذي قد يحتاجون إليها للتخلّص من خصوم سياسيين، كما حصل مع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الذي نفذ أحكاما بالسجن وصلت إلى 11 سنة أو رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال عون الذي تم إبعاده إلى فرنسا لأكثر من 15 سنة.
وعليه، بخلاف الحال في دول خاضت تجارب مشابهة، لم يجرِ أي عمل من أعمال العدالة الانتقالية في أي فترة، لا بعد انتهاء الحرب ولا بعد انسحاب الجيوش الأجنبية منه، الإسرائيلي في 2000 ثم السوري في 2005. وبقيت قضايا الضحايا وآلامهم، مع ما قد يستتبعها من اضطراب ضميري عام، لعقود خارج جدول عمل السلطات العامة أو بأحسن الأحوال على هامشها. وبدل أن نعمل على بناء ذاكرة وطنية موحّدة يتشارك فيها الجميع، تمسّكت كل فئة وأحيانا كل مجموعة من المجموعات المشاركة في الحرب، بما تريده من ذكريات، التي غالبا ما تمثّلت في رواية سطحية وانتقائية لها، هي عموما أكثر ارتباطا بالقناعات السياسية منها بما حصل فيها من أحداث حقيقةً.
النزاع الذي يتمحور حوله هذا المقال يتمثل في الدعوى التي أقامتها القوات اللبنانية ضد الإعلامي بيار الضاهر لاسترداد قناة ال بي سي تبعا لما اعتبرته إخلالا بالأمانة التي سلمته إياها (التلفزيون) خلال الحرب. فلتبرير طلب الاسترداد، تعيّن على القوات اللبنانية أن تقدم البراهين على أن “قوات” السلم هي نفسها “قوات” الحرب التي هي موّلت إنشاء التلفزيون الذي فقدته فيما بعد.
وما أن أصدرت القاضية الناظرة في الدعوى (القاضية المنفردة الجزائية في بيروت فاطمة جوني) حكمها برد الدعوى (28 شباط)، حتى تعرّضت لهجوم من قبل أنصار القوات اللبنانية على وقائع التواصل الاجتماعي، وصل أحيانا إلى مستويات غير مسبوقة من التجريح. وفيما سلّم السيد جعجع يوم صدور الحكم باستقلالية القاضية نافيا أن تكون تعرضت أو قابلة للتعرّض لأيّ تدخّل (بما يعكس موقفا استثنائيا هو برأينا بمثابة وسام على صدر القاضية)، إلا أنه رأى في الوقت نفسه ولاحقا أنها خرجت عن مبدأ الحيادية حين أقحمت في الحكم آراءها السياسية المسبقة، والتي شكلت وفق قوله تشويها للتاريخ أو تحليلا فئويا له. وقد وصل جعجع حدّ القول بأن تشويه الذاكرة هذا أدى إلى إنكار وجود فئة من اللبنانيين وتاليا إلى “التمييز العنصري” ضدّهم.
تبعا لذلك، وفيما فتحت هذه القضية وردود الأفعال على هامشها الحديث مجددا عن تاريخ الحرب والذاكرة المرتبطة به وتحديدا التصورات لما هو صحيح أو غير صحيح وعلى الأحرى ما يجدر أن نتذكره أو لا نتذكره منها، فإنها رشحت عن أبعاد أخرى، لا تقل أهمية، قوامها التصورات بشأن العلاقة بين السياسي والقاضي والمجال المتروك لكل منهما في الشأن العام، والتي قد يترتب عليها مفاعيل خطيرة بالنسبة إلى المستقبل.
وقبل المضي في تبيان ذلك، لا بد بداية من استعادة سريعة لأهم أحداث هذه القضية والحيثيات التي انبنى عليها القرار الصادر فيها.
استعادة سريعة لأهم أحداث القضية والقرار الصادر فيها
بالعودة إلى النزاع، نذكر مجددا أن “القوّات” ادّعت على أساس أنها هي التي مولت إنشاء تلفزيون ال بي سي وأنها سلمته كأمانة للسيد ضاهر، وأن رفضه اليوم ردّ التلفزيون إليها يعدّ إساءة أمانة وتاليا جرما جزائيا. وفيما بدأ النزاع في 2007، فإنه اجتاز مراحل التحقيق ليقارب مرحلة الحسم في 2018 بعدما انتهت قاضية الحكم فاطمة جوني من تحقيقاتها في القضية. وخلال هذه الدعوى، ذهب فريقا الدعوى كما عدد من الشهود لاستعادة محطات هامة من أحداث الحرب. وقد تناول هؤلاء مثلا ظروف تأسيس القوات اللبنانية خلال الحرب كتنظيم مسلح وعلاقتها بحزب الكتائب والأحزاب المسيحية الأخرى، وكيفية تمويلها. ولدى استجواب قائدها التاريخي السيد سمير جعجع عن مصدر المال الذي استخدم في تمويل إنشاء التلفزيون، أجاب بوضوح أنه يتأتى عن نظام الجباية (أي فرض الضرائب) الحاصل آنذاك في المنطقة الشرقية.
وكان من البيّن لأي مراقب لاجراءات الدعوى أن اللاعب الأساسي فيها سيكون القاضية جوني نفسها. وهذا الأمر يتأتى عن عاملين:
-
الأول، وهو الأكثر أهمية، إعلان القاضية المتواصل استقلاليتها التامة ورفضها لأي تدخل في عملها وحرصها على ضمان المساواة بين المتقاضين أمامها عملا بمبادئ المحاكمة العادلة. وقد ذهبت القاضية في الجلسة الختامية إلى استدعاء الفريقين عارضة التنحي في حال ساور أيّ منهما شك حول استقلاليتها وحياديتها في الدعوى، الأمر الذي أعرض عنه كلاهما. ورغم الانتقادات التي وجهها لاحقا السيد جعجع للقاضية بما يتصل بحياديتها الفكرية أو العقائدية، فإنه أقر باستقلاليتها الكاملة. وسلوك القاضية في هذا المجال، والذي قد يبدو عاديا في دول معينة، يكتسي أهمية مضاعفة في الوضع الحالي لبنانيا حيث تهيمن ثقافة التدخل في القضاء.
-
الثاني، تكافؤ القوة والنفوذ بين الطرفين: فمن جهة، السيد جعجع الذي بات الفريق السياسي الذي يقوده يحظى ب 15 مقعدا في المجلس النيابي أي ما يزيد عن 10% من مجموع النواب، ومن جهة ثانية، الضاهر الذي يعد أحد أبرز الإعلاميين في المنطقة العربية. ومن شأن هذا الأمر أن يضعف من قدرة أي منهما على فرض مراده على الآخر بطريقة أو بأخرى، ويدفعهما بالضرورة للاحتكام إلى القضاء والقانون.
ومن هذا المنطلق، بدت القضية مناسبة هامة بالنظر إلى هذين العاملين لإبراز تجربة نموذجية لما يمكن أن يكون عليه القضاء المستقل ودوره في حسم نزاعات كبيرة، ومدخلا لإعادة رسم الحدود بين السلطات على هذا الأساس.
وبتاريخ 28 شباط، أصدرت القاضية جوني حكمها برد دعوى القوات. ويتبيّن من قراءة الحكم المكون من 112 صفحة أمران هامان:
الأول، أن السند الأساسي لرد الدعوى تمثل في قاعدة تقنية قانونية يسلّم على تطبيقها غالبية المحاكم، قوامها أنه لا تقبل دعاوى إساءة الأمانة المتصلة بعدم رد “مثليات” (نقود، أسهم تجارية أو ما شابه)، ما لم يثبت توجيه إنذار مسبق للمدعى عليه بوجوب ردها. وهي قاعدة قانونية ورد تفصيلها في الحكم في فقرات قليلة منه، ولم تتطرق بأية حال إلى ذاكرة الحرب أو نضالات أي من الفريقين فيها، وقد بقيت خارج أي نقد من قبل قائد القوات اللبنانية رغم كونها الحيثية الأساسية والحاسمة في رد الدعوى.
الثاني، أن النقد الموجه إلى الحكم اتّصل أساسا بالمسائل الأخرى الواردة فيه والتي اعتبرتها القاضية ضرورية ليس لتقرير مسؤولية الضاهر الجزائية، ولكن لحفظ الانتظام العام وتحديدا حقوق المجتمع والدولة.
ففيما أسندت جمعية القوات اللبنانية دعواها إلى كونها المالكة الحقيقية للتلفزيون، انتهى الحكم إلى دحض هذا السند (أي ملكية القوات للتلفزيون)، من دون أن يكون لذلك أي أثر على الفقرة الحكمية. وقد تم نفي ملكية القوات للتلفزيون بالاستناد إلى اعتبارات ثلاثة:
-
الأول، أن القوات كانت في الثمانينات أي في فترة تأسيس التلفزيون إحدى الميليشيات (العبارة مستخدمة في الحكم ولكنها ليست خاصة بالقاضية إنما رددها فريقا الدعوى في لوائحهما كذا مرة) المشاركة في الحرب الأهلية وقد تكوّنت آنذاك “بنظر القانون خارج إطار الشرعية” مما يمنع من الاعتراف باكتسابها شخصية معنوية وتاليا امكانية اكتسابها لحق الملكية أو أيا من الحقوق الأخرى. وللوصول إلى هذه النتيجة، ذكّر الحكم أن “الدولة هي وحدها من يحق لها أن تنشئ القوات المسلحة، لأنّ أمن الوطن والمواطن هو من صميم الوظائف الحصرية للدولة، ولا يجوز لأية هيئات أو جماعات إنشاء تشكيلات عسكرية أو غير عسكرية إلا بإجازة من الدولة”. وقد سعى الحكم إلى تحصين هذه الخلاصة من خلال التأكيد على أنها نتيجة طبيعية للقانون الوضعي اللبناني، وأنها تنطبق على جميع الميليشيات والمجموعات المسلحة، “أيا كانت المبررات التي حتّمت وجودها، وأيا كانت الغايات التي سعت إلى تحقيقها، وأيا كان التأييد الذي حظي به كل منها ضمن منطقة نفوذه”. وبذلك، لم تضع القاضية نفسها على مسافة واحدة من جميع الميليشيات المتحاربة آنذاك، على نحو يبعد عنها أي اتهام بالتحيز السياسي لهذا الطرف أو ذاك، وحسب، إنما أكدت أن موقفها في رفض شرعية “الميليشيا” لا يرتبط بشكل من الأشكال بأي حكم قيمي لضرورة وجودها أو أهدافها.
-
الثاني، أنه ليس بإمكان جمعية القوات اللبنانية (المنشأة بعد انتهاء الحرب) التذرع بوجود وحدة بينها وبين “قوات الحرب” (أي الميليشيا). فادّعاء هذه الوحدة الذي يجد ما يبرره وفق المحكمة “في النشأة التاريخية والواقعية للقوات اللبنانية”، لا يستقيم من الناحية القانونية، لا سيّما لناحية اصطدامه بما قرّره اتفاق الطائف الذي انتهى إلى حلّ الميليشيات كلها. ومن اللافت هنا أن المحكمة برّرت ما توصلت إليه في هذا الخصوص بالتباين الكبير بين أهداف جمعية القوات (ما بعد الحرب) وأهدافها خلال الحرب. فالأولى هدفت وفق ما جاء في بيان العلم والخبر إلى تخطي النزاعات الفئوية والعمل على بناء وطن يعيش فيه كل أبنائه (وهي تاليا شرعية)، فيما أن الميليشيا كانت كغيرها من الميليشيات تسعى إلى تقسيم البلد وتمارس الإقتتال الأهلي بين أبناء الوطن الواحد (وهي تاليا غير شرعية). وقد رأت المحكمة أن هذا الاختلاف يؤدّي بحدّ ذاته إلى نسف أيّ ادّعاء بالوحدة، حتى ولو لم تتغير قيادتها ولو لم يتبدّل المنتسبون إليها، طالما أن الأهداف هي إحدى الميّزات الأساسية لأي كيان. وقد تميزت القاضية جوني في هذا الصدد عن قرار سابق لمحكمة التمييز كان صدر في إطار هذا النزاع في مرحلة التحقيق (306/2012)، واعتبر أن الفصل بين قوات الحرب وقوات ما بعد الحرب هو “محاولة غير منطقية لفصل الحزب عن الجذور والقواعد الشعبية التي انبثق عنها”.
-
الثالث، أنه على فرض وجود وحدة قانونية بين المدعية والقوات خلال الحرب، فإن المحكمة ثبتت، سندا لإفادة قائد القوات نفسه، أن “التلفزيون وموجوداته تم تمويله من مال الجباية، أي من مال الشعب، وليس من مال القوات”، بحيث تم تسديد “ثمن المعدات التي جهّز بها التلفزيون ورواتب مستخدميه ونفقات تشغيله وبرامجه وبشكل عام كل مستلزماته من مال الجباية”. وقد رأت المحكمة أن الجباية الحاصلة على هذا الوجه لا يمكن أن توليها حقوقا على المتحصلات النقدية منها، طالما أنها لا تتمتع بالطابع الشرعي، سندا لأحكام الدستور الذي يجعل من جباية الضرائب وظيفة حصرية للدولة. وللوصول إلى هذه النتيجة، ذكرت المحكمة ب “أنّ حق الملكية … يرتبط وجوبا كسائر الحقوق، بشرعية تلقّي المال”، طالما أن “الشرعية هي من أركان الحق التي بغيابها ينعدم الحق بمجمله”. ف “لا يحق لأحد التذرع باكتسابه حقوقا بالإستناد إلى فعل غير مشروع، ولا يتصور أن يكون هذا الفعل سببا لإنشاء حقّ أو لإنهاء حقّ قائم قبله”.
انطلاقا من ذلك، خرجت القاضية جوني من حدود النزاع بين الفريقين، لتفرض من خلال حكمها أصول الانتظام العام، سواء في كيفية اكتساب الشخصية المعنوية أو اكتساب حقوق الملكية. وقد انتهت بنتيجة ذلك إلى إعلان عدم قابلية الميليشيات المنشأة في زمن الحرب على اكتساب حقوق الملكية على الأموال التي جبتها أو استولت عليها. بل تبقى أموال هذه الميليشات ملكا للشعب، وتاليا للدولة. وهو انتظام عام ينطبق ليس فقط على القوات إنما على كل المجموعات المتناحرة خلال الحرب، بما يتصل بالأموال المحصّلة منها. وتجد هذه النتيجة دعامتها في قانون العفو نفسه الذي ولئن منح عفوا عاما للجرائم السياسية، فإنه أكد على أن العفو يبقى من دون أي أثر على الحقوق المدنية الناشئة عن الأفعال المرتكبة خلال الحرب.
وقد تضمن الحكم حلا لمسائل أخرى كثيرة، يستشف منها حيادية المحكمة، أهمها ردّ ادعاء الضاهر أنه اشترى التلفزيون من القوات (وهو أمر يؤكد صحة أقوال القوات في هذا الخصوص) أو أيضا إعادة توصيف الأموال المدعى بالاستيلاء عليها والتي تتكون وفق المحكمة ليس من المعدات بل من الأسهم في الشركة المنشأة أي “المثليات”. كما ورد في الحكم ما مفاده أن جرم إساءة الأمانة تتحقق عناصره فيما لو تم إرسال إنذار للمدعى عليه، بمعزل عما إذا كانت القوات مالكة للمال المسلم إليه أم لم تكن كذلك. ويستدلّ من هذا الموقف أن القاضية كانت لتحكم على الضاهر بجرم إساءة الأمانة لو أن “القوات” أرسلت إنذارا إليه قبل تقديم الدعوى، وأنها لكانت في هذه الحالة تمكّنت من مصادرة جزءا من أسهمه في شركة ال بي سي على اعتبار أنها تعتبرها ملكا للدولة، طالما أنه لا يمكن اللجوء إلى المصادرة بغياب الإدانة.
ذاكرات الأبطال
كما شرحنا أعلاه، ما أن صدر الحكم حتى صدرت مواقف اعتراضية من قائد القوات اللبنانية وعناصرها. ورغم أن ردّ الدعوى حصل لسبب تقنيّ محض وحاسم كما بينا أعلاه (عدم توجيه إنذار) لم يتطرّق إليه هذا الأخير قط، فإنه عمد إلى اتهام القاضية بإقحام آرائها السياسية في الدعوى من دون أن يطلب أي من الفرقاء منها ذلك. وفيما بيّن في تصريحه الصادر بتاريخ الحكم أن الآراء السياسية التي يقصدها (الطعجة السياسية) تتمثل في معاداتها للمجموعات المسلحة “الميليشيات”، فإنه صعّد من موقفه النقدي في مؤتمره الصحافي الذي انعقد بتاريخ 15/3/2019. وقد وصل إذ ذاك حدّ اتهامها ب “تشويه التاريخ” أو إبداء “تحاليل تاريخية فئوية” بشأن “أحد فرقاء النزاع ونضاله ومقاومته”. ويُلحظ أن تبديل الموقف هذا حصل ضمن خطاب قوامه المفاخرة والتمجيد بالذات وبالقوات اللبنانية. ف “ليس في تاريخ الشعوب وأحزابها تجربة تشبه تجربة حزب “القوات اللبنانية”. كما أن جعجع ذهب في محلات أخرى، إلى الإشادة بماضي القوات ودورها ك “مقاومة” في حماية لبنان ضد مختلف أشكال الاحتلالات، كل ذلك بمنأى عن أي مراجعة ذاتيّة.
والملفت أن السيد جعجع ذهب في الخطاب نفسه إلى دعوة الرؤساء الثلاثة و”نوّاب الأمة” ووزير العدل (الذي أسماه وزير الوصاية على العدل) ومجلس القضاء الأعلى إلى “التوقف مطولا عند الانحراف الجوهري الذي طبع الحكم موضع الشكوى، واتخاذ كل التدابير اللازمة لكي لا يتعرّض لبنانيون مستقبلا لمثل ما تعرضت له القوات اللبنانية حاضرا”.
وهذا التصريح يستوقفنا في مكانين:
فهو من جهة يفترض أن ثمة تاريخا موحدا ومتفقا عليه بحيث يكون أي خروج عنه تشويها له وهو افتراض يناقض عنوة هيمنة الذاكرات الانتقائية والفئوية بل المتناقضة في لبنان. وهكذا، وفيما امتنع ويمتنع لبنان الرسمي عن أي مراجعة للحرب وأحداثها وتاريخها خوفا من الخصومات التي قد تنشأ بفعل ذلك بين القوى المشاركة في الحكم، يجد السيد جعجع أن من حقه أن يعتبر أي انتقاص لنضالات القوات ولو في معرض تكييفها واقعيا (تسميتها ميليشيا) أو قانونا (القول بأنها غير مشروعة) تشويها للتاريخ وانحيازا ضدها.
وهو من جهة ثانية، يستدعي أطرافا سياسيين كان عدد كبير منهم في حال حرب مدمّرة مع القوات اللبنانية ويعرف سلفا أن لهم ذاكرات أخرى عن الحرب، ذاكرات تعظّم في الغالب أدوارهم (هم) لتشيطن في بعض الأحيان أدوار خصومهم في الحرب، ومنهم القوات. فما الذي عسى يستدعيه السيد جعجع في ظلّ كل هذه االمعطيات، من خلال دعوة هؤلاء إلى التوقّف والتأمّل والتصرّف بالضبط؟
الشرح المنطقي الوحيد لهذه التصريحات هو أنها تعكس توافقا غير معلن بين القوى السياسية (شركاء الحرب والسلم) على احترام ذاكرات الآخرين (كل الذاكرات) رغم اختلافها وتناقضها.
فلكلّ أن يمجّد ذاته أمام شعبه من دون أن يكون لأيّ منهم المسّ بأي من ذاكرات الآخرين، تحت طائلة اعتباره إخلالا بالتوافق الوطني وربما العيش المشترك، وبالمحصلة مسّا بالرموز الوطنية مشابها في عمقه تماما لما قد يحدثه المسّ بالرموز الدينية (التي بدورها قد تكون متناقضة). وهذا ما يمكن تسميته ب “ذاكرات الأبطال” أي الذاكرات القائمة على تمجيد قادة الحرب والمشاركين فيها، وفي الآن نفسه على حجب مسؤولياتهم والمآسي الذين تسببوا بها هنا وهنالك، وبكلام آخر الضحايا. وهذا الشرح هو وحده يفسّر الجمع الحاصل بين تمجيد تاريخ القوات ومناشدة من حاربها وناصبها العداء التضامن في الدفاع عن هذا التاريخ… الدفاع عنه ضد التشويه.
وأكثر ما يؤلم في هذا الخصوص هو أن هذا الخطاب يبيّن الحضور الطاغي للماضي الذي يبقى جاثما بيننا، في كل أبعاده، من دون أي مسعى جدّي لتنقيته وتاليا لتجاوزه.
القضاء والنظام العام والدولة تحت سقف التوافق
بما لا يقل أهمية، هو النظرة التي عبر عنها السيد جعجع للوظيفة القضائية، وبخاصة في مجال تفاعلها مع السلطة السياسية. فعلى نقيض المنطق القانوني البديهي الذي يفرض على القاضي – كل قاضٍ – عدم الاعتراف لا بمشروعية المجموعات المسلحة ولا بمشروعية أي كان في جباية ضرائب بالنظر إلى انحصار هاتين الوظيفتين بالدولة، جاء خطاب السيد جعجع ليعتبر هذا المسلك البديهي بمثابة رأي سياسي مسبق وانحيازا (بل تمييزا عنصريا) ضد فئة من اللبنانيين. ونفهم أن المقصود من التمييز العنصري هو حرمان القوات اللبنانية من الاحتفاظ بما جنته خلال الحرب وذلك بخلاف سائر القوى المشاركة فيها، والتي هي احتفظت بكل ما طالته أيمانها. ولإدراك ما تعنيه عبارة “التمييز العنصري”، يتعيّن علينا أن نستذكر ما تعرض له السيد جعجع من محاكمات وسجن على خلفية ما نسب إليه من أفعال حصلت خلال الحرب، وذلك بخلاف سائر قادة الأحزاب والميليشيات المتقاتلة والذين هم حظوا عموما بشراكة محفوظة في الحكم.
إلا أنه ومع كل تفهمنا لأسباب الشعور بالتمييز أو الغبن، يبدو أنه فات السيد جعجع في خضمّ نقده للحكم والقاضية التي أصدرته، أن احتفاظ سائر الميليشيات بما جنته خلال الحرب ليس حقا مكتسبا وأنه لم يتمّ بقرار قاضٍ ولا بقانون إنما بقوة الأمر الواقع أو بموجب تسويات وتفاهمات سياسية ضمنية تعتبر مدخلا وامتدادا لنظام المحاصصة في آن. وعليه، يصبح إلزام القاضي باحترام هذه التسويات والتفاهمات، بمثابة إخضاع له لما تقرره القوى السياسية، بمعزل عمّا يقرره القانون أو المنطق بل وبخلاف معه. وهذا ما عبّر عنه الحكم بشكل بليغ. فبعدما تساءلت القاضية جوني فيما إذا كان الواقع المعيوش بعد الحرب، والذي تمثل في استبقاء الميليشيات والأحزاب على مجمل ما استولت عليه خلال الحرب، يغيّر من الأمر الذي وصلت إليه بتطبيق حيادي للقانون، أجابت القاضية أنها “لا تلتزم إلا بحكم القانون في أحكامها، ولا تلزمها أية تسويات سياسية، وطالما أنها لم تقترن بقوانين صريحة تكرس ملكية الأحزاب لما جمعته ميليشياتها” في تعارض للقانون. وقد جاءت إجابة المحكمة في هذا الخصوص جدّ معبرة وبمثابة إعلاء للنظام العام على التطبيع الحاصل مع التسوية القائمة على الأرض بما يهدد هذا النظام العام. ويأتي هذا الموقف القضائي بمثابة تنبيه إزاء المبالغة في التطبيع مع الواقع، والتي غالبا ما أدت إلى تجاهل الأحكام القانونية. كما أدت في حالات كثيرة إلى تفسير القوانين وتطبيقها (تسخيرها) على نحو يؤدي إلى إضفاء المشروعية على الواقع، بدل إخضاع الواقع لمقتضيات القانون.
من هذا المنظار، يظهر بوضوح القصد من اتهام جوني بإقحام آرائها السياسية: ف “القاضي السياسي” الذي قصده جعجع ليس القاضي السياسي في انتمائه وعلاقاته، ليس القاضي الذي يبحث عن حماية ودعامة سياسية أو يتردد على صالونات السياسيين ويقيم علاقات دائمة معهم (وكل ذلك بعيد كل البعد عن القاضية جوني وفق اعتراف جعجع نفسه)، هو ببساطة القاضي “المخالف” الذي يفكر بشكل يختلف عن التوجه السائد أو التوافق السياسي، حتى ولو كان خروجه ذاك واجبا عليه قانونا.
وهكذا، وفيما يبقى القاضي “السياسي” في انتماءاته وعلاقاته في معظم الأحيان بمنأى عن أي ملاحقة أو حتى التفاتة مهما كثرت تجلياته وطلعاته ونزلاته وتضاءلت استقلاليته (بل غالبا ما يتولى مناصب عليا)، فإن القاضي “المخالف” يصبح منذ أول تجلّ له، وفق ما نفهمه من خطاب السيد جعجع، خطرا على المنظومة الحقوقية برمتها، على حاضرنا ومستقبلنا، خطرا توجب مواجهته استدعاء أعيان النظام كلهم تماما للتلاحم مجددا لإعادة رسم الحدود التي يتعين على القاضي الالتزام بها بعد فرض الوصاية عليه. ومؤدى ذلك هو إعطاء التسويات والتوافقات السياسية قيمة أعلى من الدستور والقانون فتطبق لأنه يجب أن تطبق، من دون أن يكون لأي قاضٍ حق تقييمها أو التدقيق فيها.
كان حريا بالسيد جعجع، الذي تدعم كتلته اقتراح قانون استقلال القضاء وشفافيته، أن يكون أكثر حذرا في إطلاق هكذا مواقف. فبقدر ما يحتاج الماضي إلى نظرة جديدة، تغلب النقد الذاتي على خطاب التمجيد الذاتي وتغلب أنسنة الذاكرة وتوحيدها على فئوية وانتقائية الذاكرات، يحتاج المستقبل إلى رؤية تجديدية، يحتلّ فيها القضاء المستقلّ، القادر على حماية النظام العام (ومعه الدولة) وتغليبهما على التسويات والتفاهمات والإقطاعات، مكانة القلب.
“