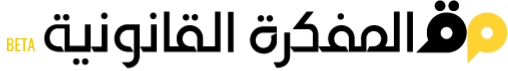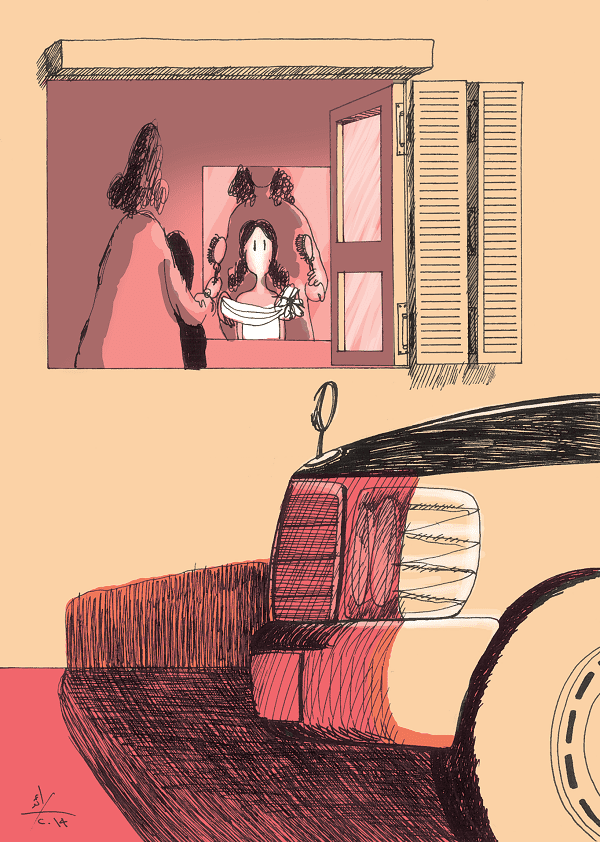كريم نمّور
قدّم النائب سامي الجميّل (كتلة الكتائب) في تاريخ 20 آذار 2024 اقتراح قانون جانب مجلس النوّاب، يرمي الى تعديل بعض المواد في قانون العقوبات اللبناني المتعلّقة بالجرائم المخلّة بالأخلاق والآداب العامة (المواد 503 الى 521 من القانون المذكور). وقد يكون أبرز ما تضمنه هذا الاقتراح، تعديل المادة 503 الحالية من قانون العقوبات الخاصة بمعاقبة الاغتصاب، في اتجاه إلغاء استثناء الاغتصاب المرتكب من الأزواج منها، وذلك استجابة لمطالب اجتماعية ونسوية ملحّة بهذا الشأن. ووفق أسباب الاقتراح الموجبة، فقد أصبح عقد الزواج “وسيلة قانونية لتجريد المرأة من كرامتها وحريتها وحقها بسلامة جسدها مع [ما] يترتب على ذلك من عدم استقرار عاطفي ونفسي نتيجة إجبارها على ممارسة العلاقة الجنسية رغم انتفاء الرغبة لديها”. ولهذا الغرض، تذكّر الأسباب الموجبة أن لبنان منضمّ إلى “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (CEDAW)، ما يوجب على السلطات اللبنانية تأمين الانسجام التشريعي وإلغاء أيّ تعارض بينها وبين النصوص المحلية. فالاتفاقية تحث الدول الأطراف على شجب جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ومن دون إبطاء سياسة تستهدف إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية وتشريعاتها الأخرى، وضمان تحقيقه فعلياً. ويتم ذلك وفق الاتفاقية من خلال التشريع وأيضاً من خلال اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكلّ الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أيّ من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة”.
لكن أبعد من الهدف الأساسي المعلن من الاقتراح، نلحظ إفراطاً من قبل أصحاب الاقتراح في تبنّي المنحى العقابي، إفراطاً تجلّى في تخطّيهم أصول التشريع في المسائل الجزائية. ومن أهم الشواهد على هذا الإفراط، إعادة التأكيد على شرعية عقوبة (“الأشغال الشاقة المؤبّدة”) فضلاً عن تضمين الاقتراح نصوصاً جرمية مطاطة ومبهمة في موازاة تقييد القاضي في ممارسة وظيفته في تفريد العقوبة في العديد من مواده. وقد برّر أصحاب الاقتراح إفراطهم في تبنّي المنحى العقابي هذا، بأن “التجربة أثبتت أن العقوبات المطبّقة استناداً للنصوص الحالية غير كافية وتفتقر بشكل عام للطابع الردعي” من دون ذكر أي دراسة علمية أو غير علمية بهذا الشأن (وكأنما “التجربة” التي يسترشدون بها هي مجرد انطباعات). وإذ أعادت الأسباب الموجبة ضمناً التأكيد على أهمية “العائلة” المتماسكة (وهي إحدى القيم العليا في عقيدة حزب الكتائب التقليدية)، فإن واضعي الاقتراح بدوا أقلّ اهتماماً بدراسة الواقع الاجتماعي، وبخاصة بما يتصل بالمراهقين والشباب. وقد بدا الاقتراح من هذه الوجهة وكأنه يجرّد هؤلاء من أي إرادة أو سلطة على أجسادهم وحيواتهم الجنسية.
تشديد العقوبة لا يضمن الملاحقة
أول ما نلحظه كما سبق بيانه، هو تشدّد الاقتراح عموماً في مقاربته لتجريم الأفعال التي يتناولها مقارنة بالنصوص المعمول بها حالياً. ففي حين تعاقب المادة 503 من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل مع رفع العقوبة إلى سبع سنوات على الأقل إذا كان المعتدى عليه لم يتمّ الخامسة عشرة من عمره، رمى اقتراح الكتائب إلى رفع العقوبات لتتراوح بين الأشغال الشاقة لمدّة عشرين سنة والأشغال الشاقة المؤبدة. الاتجاه نفسه أي تشديد العقوبات الحالية اعتمده الاقتراح في المواد 504 حتى 509، مع تكريس عقوبة “الأشغال الشاقة” المؤبّدة كما المؤقتة، علماً أن تعبير “أشغال شاقة” ومفهومه هو مخالف للمبادئ والحقوق الأساسية التي التزم بها لبنان ولاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد منديلا).
وفي حين حاولت أسباب الاقتراح الموجبة تبرير تغليب المنطق العقابي هذا بالإشارة إلى الطابع غير الردعي للعقوبات الحالية، فهي تقاعست بالمقابل عن تبيان كيف توصّل أصحاب الاقتراح الى هذه النتيجة، ولا سيما أن مراجعة دراسات أكاديمية بشأن ملاحقة ومعاقبة جرائم التعدي الجنسي والاغتصاب حول العالم، تظهر أن رفع العقوبة في هذا المجال (وتالياً درجة قساوتها) قد لا يشكل رادعاً على الفاعل، بل العكس تماماً. ففي حين تؤدي العقوبات المرتفعة إلى تعزيز أزمة اكتظاظ السجون وتكبيد أعباء اضافية على خزينة الدولة من ناحية وعلى العدالة الجنائية وإدارتها عموماً من ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي أيضاً الى تفاقم حالات التكرار في مثل هذه الجرائم نظراً لما قد تشكّله السجون من مدارس عمليّة للتدريب والتعليم على اقتراف الجرائم عموماً[1]. فالأبحاث في علم الجريمة أظهرتْ أن قساوة العقوبة تبقى العامل الأضعف في مكافحة الجريمة في المجتمع. وما يؤدي فعلياً إلى تدنّي الجريمة في المجتمع هو عاملا حتمية وسرعة الملاحقة والمعاقبة، أي العمل على الأدوات التي تقلّص من احتمالات الإفلات من العقاب[2]. أمّا قساوة العقوبة، فيمكنها أن تشوّش على عامليْ حتمية وسرعة الملاحقة بسبب تأثيرها على بطء الإجراءات القضائية نظراً لطبيعتها وعلى اكتظاظ السجون في نهاية المطاف[3]. وبالعودة إلى جرائم العنف الجنسي والاغتصاب، فالواقع أن معظم الحالات تبقى من دون ملاحقة جديّة[4]، لا سيّما بسبب استخفاف أجهزة الضابطة العدلية بها وعدم أخذها على محمل الجدّ[5] وسواد اتجاه إلى لوم الضحيّة والتشكيك في مصداقيتها، إضافة إلى الخوف والرّهبة اللذيْن تولّدهما هذه الجرائم على الناجين منها وضحاياها، مما قد يثنيهم عن الإفصاح عنها. وهو أمر سبق للمفكرة القانونية أن سجّلته في دراسة لها سنة 2020 حول توجّهات المحاكم في قضايا الاغتصاب في بيروت وجبل لبنان[6]. أما السبب الآخر لقلّة ملاحقة هذا النوع من الجرائم، فهو صعوبة إثباتها عموماً، هذا ما أدى بدول أخرى الى تخفيف عبء الاثبات على الناجيات في مثل هذه الحالات وإيلاء أهمية كبرى للتقييم النفسي وتمديد مهلة مرور الزمن فيما يخصّ الجرائم الجنسية[7]. فضلاً عما تقدّم، من المهمّ التذكير بما توصّلت اليه دراسة المفكرة القانونية سنة 2020 المذكورة لناحية غياب شبه تامّ للطبقات الوسطى والميسورة في هذا النوع من القضايا[8]، وهو أمر لا يعني حتماً أن العنف الجنسي والاغتصاب لا يقترفان وسط هذه الطبقات، بل قد يفسّر بتأثّر القضاء بالتنميط الاجتماعي: فالطبقات العاملة غالباً ما تُصوّر على أنها عنيفة، وأكثر عرضة لارتكاب الجرائم الجنسية. وبذلك، يصبح المتهم المتعلّم، الميسور، غير متطابق مع المجرم النمطي ويصعب بالتالي إدانته[9]، مما يؤدّي إلى افلاته من الملاحقة والعقاب في نهاية المطاف.
وعليه، كان من الأجدى بأصحاب الاقتراح أن يعملُوا على سبل تعزيز عامليْ الحتمية والسرعة في مكافحة جرائم العنف الجنسي والاغتصاب في المجتمع، لا سيما من خلال اعتماد قواعد أكثر مرونة في الإثبات والعمل على أدوات الملاحقة وتطوير عمل أجهزة الضابطة العدلية بشكل ممأسس، بدل تعزيز المنطق العقابي على هذا النحو.
مخالفة الاقتراح لمبدأ التناسب
في حين تعاقب المادة 503 من الاقتراح “من أكره الغير بالعنف والتهديد على الجماع”، تعاقب المادة 504 منه “من أقدم على مجامعة شخص بغير رضاه نتيجة ما مارسه عليه من ضروب الحيلة والخداع”. إلا أن الاقتراح يساوي في مقاربته بين الفعلين المنصوص عليهما في المادتين المذكورتين في قساوة العقوبة التي تتراوح بين “الأشغال الشاقة لمدة عشرين سنة” و”الأشغال الشاقة المؤبدة” وفق ظروف الجريمة، معتمداً نفس أسباب التشدّد نسبياً لكلا الفعلين. وعليه، نستشفّ من الاقتراح أنه يعتبر الجماع بالعنف والتهديد بنفس درجة خطورة الجماع الحاصل بنتيجة استخدام ضروب الحيلة والخداع (بغض النظر عن التعابير المطاطة المستخدمة والتي أعود اليها أدناه). وعليه، يكون الاقتراح قد خالف مبدأ التناسب بين خطورة الفعل وقساوة عقوبته الذي يرعى صياغة النصوص الجزائية. فأن نتعامل مع الفعلين على أنهما بنفس درجة الخطورة الاجتماعية، لا يتّسق مع روحية قانون العقوبات الذي يميّز بين فعل مقترف بالحيلة والفعل نفسه إذا اقترف بالعنف (مثل السرقة – مادة 640) من حيث الأثر الاجتماعي وكيفية معاقبتهما.
من ناحية أخرى، فإن أصحاب الاقتراح لم يكتفوا بإلغاء استثناء الاغتصاب الزوجي من العقاب، إنما ذهبوا إلى اعتبار “الرابطة الزوجية” سبباً مشدّداً للعقوبة (التي لا تنقص في هذه الحالة عن خمس وعشرين سنة مقابل عشرين سنة للحالات الأخرى) من دون أي تبرير مُقنع، وعلى نحو يقارب العبث. وإذ ذهب الاقتراح من جهة أخرى إلى إلغاء “إزالة بكارة” المعتدى عليها من أسباب التشدّد في المادة 512 (بحجة أنه “لا يجوز أن يستفيد المعتدي من كون الضحية ليست بكراً حتى تكون عقوبته أخف بموجب النص، ومن ناحية الضحية، فمن واجب المشترع أن يحافظ على حق المرأة بسلامة جسدها دون تمييز بين ما إذا كانت بكراً أم لا طالما لا يوجد عنصر آخر مستقل يستوجب تعزيز هذه الحماية وتشديد العقوبة مثل العجز الجسدي أو العقلي أو غيره من الحالات الخاصة التي وردت في النصوص الجديدة المقترحة)، غير أن الاقتراح لم يشر الى إزالة البكارة في أسباب التشدّد المذكورة في المادتين 503 و504، وهو تالياً يناقض نفسه في نظريته – لا سيما نظراً لمقاربته للاغتصاب الزوجي – ويخلق تمييزاً آخراً لصالح الناجية المتزوّجة من الفاعل التي تستوجب تشديد العقوبة عكس “إزالة البكارة”. فماذا يعني إلغاء “إزالة البكارة” من أسباب التشدّد؟ وهل هذا يراعي مبدأ التناسب، لا سيما بالنظر للظروف الاجتماعية والثقافية المحليّة؟
استحداث أسباب تشدّد وفق تصنيف جديد للقاصرين
يوجد الاقتراح تصنيفاً جديداً للقاصرين مقسمّاً إيّاهم إلى ثلاث فئات عمرية: القاصرين الذين لم يبلغوا الثانية عشرة والقاصرين بين الثانية عشرة والسادسة عشرة والقاصرين بين السادسة عشرة والثامنة عشرة، وذلك بالنسبة لمجمل الجرائم الجنسبة الواقعة عليهم. ووفق أسباب القانون الموجبة “فالنصوص المطبّقة حالياً لا تعتمد هذا التصنيف الثلاثي سوى في بعض الجرائم المحدّدة التي حرص المشترع على تشديد عقوباتها بشكل خاص عندما لا يكون القاصر المعتدى عليه قد بلغ الثانية عشرة بعد (المواد 505 و507 و509 و510 و513)، في حين أن هذه الفئة من القاصرين لم تستفد من ذات الحماية بالنسبة لجرائم أخرى وإن كانت احياناً أشد خطورة من الأولى (المواد 503 و504 و508 و514 و515 و519)، من دون أن يتبدى ما يبرر هذا التمييز”، كما يأتي الاقتراح وفق نفس الأسباب الموجبة “[لإفادة] القاصرين الذين لم يتموا السادسة عشرة من عمرهم من ذات الحماية التي يستفيد منها أولئك الذين لم يكملوا الخامسة عشرة”.
ان تصنيف الاقتراح المذكور يستدعي الملاحظات التالية:
- يرفع الاقتراح سنّ الفئة الثانية من 15 سنة (النص الحالي) إلى 16 سنة مؤكداً على سنّ الـ18 للرشد الجنسي (وفق تعريفه للفئة الثالثة). وهو تعديل لا تبرره أسباب الاقتراح الموجبة (علماً أنه قد يتوافق مع اقتراحات قوانين أخرى تحدد السنّ الأدنى للزواج بـ18 سنة[10]). هنا تجدر الإشارة أنه ليس هناك سنٌّ معتمد في المعايير الدولية في هذا الشأن وهو أمر متروك لمعالجته وفق القوانين المحليّة. لا بل أن رفع سنّ الرشد الجنسي (أو سنّ القبول – Age of consent) قد يؤدي حتى الى نتائج سلبية إزاء حياة المراهقين الجنسية، لا سيما نظراً لواقع الممارسات الجنسية وسط المراهقين، وهو أمر لم تبحثه أو تناقشه أسباب الاقتراح الموجبة. فوفق بعض الدراسات (لا سيما مثل الورقة البحثية التي أعيد نُشرها سنة 2019 على موقع معاهد الصحة الوطنية الأميركية[11])، فإن القوانين التي ترفع سنّ الرشد الجنسي (لا سيما لغاية الـ18) من شأنها الإضرار والالتفاف حول وكالة وسيطرة المراهقين على أجسادهم ونكران حقهم باتخاذ قرار إزاء ممارسة الجنس ومتى ممارسته ومع من. لا بل من شأن مثل هذه القوانين أن تؤدي إلى مزيد من الوصم والتجريم تجاه الأشخاص الذين يمارسون الجنس قبل الزواج وخلق مزيد من الحواجز بوجه الوصول إلى الصحة الجنسية والإنجابية. وقد يكون الأجدى العمل على توفير المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية لتمكين المراهقين باكراً حول هذه المسائل وحمايتهم فعلياً في نهاية المطاف.
- إن الاقتراح يعيد تدوير التصنيف الثلاثي لأعمار الرشد الجنسي، بحيث يعيد تكريس تصنيف الفئة العمرية الثالثة (أي لغاية 18 سنة) التي كان قد تمّ إدخالها الى المادة 505 من قانون العقوبات بداية سنة 1983 أيّام الرئيس أمين الجميّل (والد صاحب الاقتراح الراهن، سامي الجميّل) لتصبح الفقرة الثانية من المادة المذكورة تجرّم “من جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة” الاّ إذا “عُقد زواج صحيح بينهما”. فيأتي الاقتراح الراهن ليلغي فرضيّة الزواج لوقف الملاحقة أو المحاكمة، ويرفع سنّ الفئة الثالثة من 15 الى 16 ومعه يرفع العقوبة من سنتين إلى ثلاث سنوات ويربط الدعوى العامة بشكوى المتضرّر.
ان إيجاد الاقتراح لهذه الفئات العمرية المستحدثة يطرح بعض الأسئلة التي من شأنها أن تشي بما قد يولّده الاقتراح – إن تمّ إقراره – من إشكاليات قضائية ووصمة إزاء الممارسات الجنسية لدى المراهقين. فكيف نعالج مسألة مراهقين مارسوا الجنس بين بعضهم البعض، لا سيما في ظل وجود تفاوت بسيط في العمر مثل 15 و17 أو 16 و17 أو 15 و18 مثلاً؟ من ناحية أخرى كيف عسى لهذا الاقتراح – ان اعتمد – أن يوفّق بين نصه وبعض نصوص الأحوال الشخصية، لا سيما تلك المتعلّقة بسنّ الزواج لدى بعض الطوائف في لبنان؟ ماذا عن واقع الممارسات الجنسية في أوساط المراهقين اليوم في لبنان؟ أما كان من الأجدى البحث ومناقشة دراسات ميدانية واجتماعية ونفسية في هذا الشأن بغيت التوصل لنص قانوني يوفّق بين الممارسة في الواقع وحتمية حماية القاصرين من العنف الجنسي كما ووصولهم للصحة الجنسية والانجابية؟
مخالفة الاقتراح لمبدأ الدقة في صياغة النص الجزائي
لا بد أيضاً التوقّف على بعض التعابير التي يستخدمها الاقتراح في تعريفاته لإيجاد أو إعادة تدوير تجريم بعض الأفعال، لا سيما تلك المذكورة في المادة 504 (التي تعاقب “من أقدم على مجامعة شخص بغير رضاه نتيجة ما مارسه عليه من ضروب الحيلة والخداع“) أو 507 (التي تعاقب “من حمل آخر […] بالحيلة والخداع على مكابدة أو إجراء فعل مناف للحشمة“) منه. فباستخدامه تعابير مطاطة مثل “الحيلة” و”الخداع” و”فعل مناف للحشمة” في تعريفه لأفعال جرميّة، يكون الاقتراح قد خالف مبدأ الدقّة في صياغة المواد العقابية، بما يناقض مبدأيْ شرعية العقوبات والمساواة أمام القانون، وهو أمر تزداد خطورته كون الأفعال المذكورة في هذه المواد تشكّل جناية، تصل عقوبتها الى سبع سنوات أشغال شاقة بالنسبة للمادة 507، وبالنسبة للمادة 504 تتساوى عقوباتها بقساوة العقوبات المنصوص عليها في المادة 503 (التي تعاقب “من أكره الغير بالعنف والتهديد على الجماع” أي الاغتصاب) والتي قد تصل الى الأشغال الشاقة المؤبدة، ما يخالف أيضاً مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة وفق ما أسلفته.
فما معنى ضروب الحيلة والخداع؟ وما معنى فعل منافٍ للحشمة؟ هل راجع أصحاب الاقتراح مقاربة الاجتهاد اللبناني لهذه التعابير قبل صياغتهم اقتراحاً يعاقب عليها ويجعل منها جنايات وينزل عليها عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبّدة؟ إن مراجعة سريعة للاجتهاد اللبناني تظهر مقاربة هذا الأخير لهذه الأفعال وتالياً خطورة ما يقترحه أصحاب الاقتراح على صعيد العدالة الجنائية والسلام الاجتماعي.
إذ وفق الاجتهاد اللبناني، فإن ضروب الخداع يمكن أن تتمثّل بلجوء الفاعل “إلى استعمال الوعود” (مثل الوعد بالزواج أو الإيهام به)، و”استمطار العهود، وتدبيج الكلمات المعسولة” (بمعنى آخر مغازلة الشريكة)[12]، كما يمكن أن تتمثّل ضروب الحيلة بتقاعس الفاعل عن دفع مبلغ من المال كان قد وعد به الشريكة[13]. أما الفعل المنافي للحشمة فهو – وفق الاجتهاد اللبناني – “كلّ فعل منافٍ للآداب يقع مباشرة على عورات الغير ومن شأنه أن يخدش عاطفة الحياء العرضيّ للمجنى عليه، تلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها. [ويعود] للمحكمة أن تقرر ما إذا كان الفعل المشكو منه يخدش من حيث أهميته عاطفة الحياء للمجنى عليه بحيث يستحقّ تسميته بالفعل المنافي للحشمة أو باعتبار فعلاً منافياً للحياء”[14]. فهل التقبيل أو تلمس بعض أماكن الجسد (مثل الشعر أو الرجلين الخ.) يشكل فعلاً منافياً للحشمة؟ وما معنى العورة في مجتمعنا اليوم؟ هل يختلف معنى هذا المصطلح بين بيئة وأخرى؟ هذه الأسئلة ليست بديهية نظراً للنتائج التي يمكن أن تترتّب عليها، لا سيما إزاء اعتبار الفعل يقع تحت أحكام المادة 507 وتالياً تشكيله لجناية تستوجب أشغال شاقة تصل الى سبع سنوات.
في الواقع، فإن من شأن استخدام مصطلحات مطاطة على هذا الشكل في نص جزائي أن يحوّل الاقتراح – إن تمّ إقراره – الى أداة لتطويع العلاقات أخلاقياً – وفق مفهوم، هو الآخر، مطاط – في نظام غالباً ما يقحم ذاته في حيوات سكّان البلد الحميمية ولا يحترم خصوصيتها، لا بل يصل إلى حدّ تجريمها أحياناً، على غرار ما يقوم به إزاء الأقليّات الجنسيّة (مثل المثليين والمثليات بالاستناد إلى المادة 534 من نفس قانون العقوبات). تالياً، من شأن هذا الاقتراح أن يولّد “مطوعاً” محلياً لضبط العلاقات الحميميّة وزجّها في أطر تقليدية محددة. لا بل وفي حين ألغى أصحاب الاقتراح “منحة” إعفاء المعتدي من الملاحقة إن تزوّج من ضحيته سنداً للمادة 505 الحالية، فهم يعيدون إدخال هذه المنحة – ربما، لا إرادياً – بشكل غير مباشر في المادة 504. فعلى الفاعل الذي وعد ضحيّته بالزواج (حيلة وخداع) أن يقوم إذ ذاك ويتزوّج فعلياً بها للتهرّب من سطوة أحكام المادة 504 المقترحة، مع ما قد يتبع ذلك من تداعيات سلبية على الحياة الزوجية وحياة الأسرة التي يحرص عليها أصحاب الاقتراح وفق ما أكّدوا عليه مراراً في الأسباب الموجبة.
مخالفة الاقتراح لمبدأ تفريد العقوبة وحدّه لدور القاضي في قيامه بوظيفته
في العديد من مواده يحدد الاقتراح حدا أدنى للعقوبة (peine plancher). فـ”لا تنقص العقوبة عن” خمسة وعشرين سنة أو ثلاثين سنة أو حتى المؤبّد في بعض الحالات المنصوص عليها في المادتين 503 و504، وهي عبارة (أي “لا تنقص العقوبة عن…”) توالت على معظم مواد الاقتراح (505 و509 و514 الخ.) وأتت أكثر وضوحاً في بعضها الآخر (مثل “يكون الحد الأدنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة…” – المادة 507 من الاقتراح). وهو أمر تزداد خطورته عندما يترافق مع استخدام الاقتراح لتعابير مطاطة مثل “حيلة” و”خداع” و”مناف للحشمة” و”أذى خطير” الخ. فمن شأن إيجاد الاقتراح لحدّ أدنى للعقوبة أن يتعارض مع مبدأ تفريد العقوبة بحيث يجرد تبعاً لذلك القضاء من صلاحية تفريد العقوبات.
فضلاً عن ذلك، فإن من شأن هذه الأحكام أن تشكل أيضاً تعدياً على صلاحية القاضي ودوره الاجتماعي، حاصرة إياه في التثبت من الإدانة وتحديد العقوبة التي تتناسب مع خطورة الفعل موضوع المحاكمة. وهي تجعل من القاضي إذ ذاك مجرد أداة تقنية لتطبيق القانون (technicien du droit) وليس مفكراً في القانون (penseur du droit). وهذا الأمر إنما يشكل تعرضاً للاستقلالية الوظيفية للقاضي وانتقاصاً من دوره الاجتماعي وبالنتيجة مساساً بحق المتقاضي بالتمتع بضمانات المحاكمة العادلة.
للاطّلاع على اقتراح القانون
[1] German Lopez, “The justice system needs to take rape more seriously. That doesn’t mean longer prison sentences.”, Vox, Sep 2, 2016.
[2] Ibid.
[3] Mark A.R. Kleiman, “Smart on Crime”, Democracy Journal, Spring 2013, no. 28.
[4] “The Criminal Justice System: Statistics”, the Rape, Abuse, and Incest National Network (RAINN).
[5] G. Lopez, op. cit.
[6] لمى كرامة، “توجّهات المحاكم في قضايا الاغتصاب في بيروت وجبل لبنان“، المفكرة القانونية، العدد 63، آذار 2020.
[7] تاتيانا لبّوس، “فرنسا تعتمد قواعد أكثر مرونة في إثبات الجرائم الجنسية: هكذا نحمي الضحايا“، المفكرة القانونية، العدد 63، آذار 2020.
[8] لمى كرامة، المرجع نفسه.
[9] المرجع نفسه.
[10] رانيا حمزة، “ثلاثة اقتراحات عالقة في الإدارة والعدل.. غالبية الشعب اللبناني ترفض زواج القاصرات“، المفكرة القانونية 24/09/2018.
[11] Suzanne Petroni, Madhumita Das, Susan M Sawyer, “Protection versus rights: age of marriage versus age of sexual consent”, The Lancet – Child & Adolescent Health, published December 05 2018, Volume 3, ISSUE 4, P274-280, April 2019, referenced by the National Library of Medicine (NIH).
[12] محكمة استئناف البقاع، قرار رقم 203، صادر تاريخ 10/7/1997.
[13] محكمة جنايات جبل لبنان، قرار رقم 322، صادر بتاريخ 27/4/2000 (هيئة المحكمة: الرئيس جوزف غمرون والمستشاران خالد حمود وأحمد حمدان):
وحيث يبقى الحل المنطقي الذي توصلت اليه المحكمة، والذي برر تراجع المدعية عن دعواها فيما بعد وهو جرها بالحيلة الى ذلك المنزل البقاعي البعيد، من قبل المتهم، وممارسة الجنس من قبل الاخير معها، بهذه الطريقة، دون ان يدفع لها ما وعدها به من مال، الا ربما، في وقت لاحق لتوقيفه، الامر الذي حملها على اسقاط حقوقها الشخصية ومغادرة الاراضي اللبنانية.
وحيث يكون فعله، كما هو موصوف اعلاه، مشكلا للجناية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة /504/ ق.ع.
[14] محكمة جنايات جبل لبنان، قرار رقم 39، صادر بتاريخ 17/1/2000 (هيئة المحكمة: الرئيس حاتم ماضي والمستشاران ميشلين بريدي وجان بصيبص).