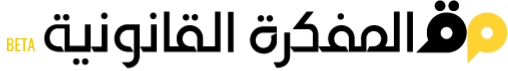صادق “مجلس نواب الشعب” في جلسة 6 جوان 2024، على مقترح قانون يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، في انتظار ختمه من الرئيس قيس سعيّد وإصداره. هو بذلك أوّل تشريع يصادق عليه برلمان الرئيس سعيّد ويكون بمبادرة من النواب، الذين انطلقوا من نصّ مشروع قانون سابق بدأ العمل عليه في وزارة الصحّة منذ 2016 ومرّ أكثر من مرّة على الجلسة العامّة، مع تعديلات مسّت ببعض خياراته الجوهرية. وهو على الأرجح، بالنظر إلى موضوعه، من أهمّ التشريعات في حصيلة المجلس منذ بداية اشتغاله قبل أكثر من سنة. فهو يملأ، على الأقلّ نظريّا، فراغا تشريعيّا في مجال حقوق المرضى، ويوحّد وينظّم ويفصّل المسؤوليّة الطبيّة التي كانت تخضع إلى اجتهادات قضائيّة مختلفة بين القضائين العدلي والإداري. لكنّ النتيجة كانت تضاربا في الأحكام، وتقليصا خطيرا من مجال ومبالغ التعويض الممكنة، وتشريعا قد يسبّب في النهاية مشاكل أكثر مما يحلّ، ويضيّق على الحقوق أكثر مما يمنح، ويُفيد شركات التأمين أكثر مما هي أصلا مستفيدة، على حساب المرضى ومهنيي الصحة.
حصلت المصادقة في أجواء تقرب الإجماع، وبعد نقاش باهت لم تبرز فيه أيّ من النقاط الخلافيّة أو الرهانات (وبالأخصّ الماليّة) التي لطالما التصقت بهذا المشروع وعطّلت في السابق المصادقة عليه. وفي حين احتفل رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة بإنجاز “عجزت عن تحقيقه البرلمانات المتعاقبة”، اختار رئيس لجنة الصحة نبيه ثابت شُكر الرئيس قيس سعيّد لأنّه “أتاح هذه الفرصة”. غياب النقاش والجدال هذه المرة، لا يعود فقط إلى ضعف تسيّس جلّ أعضاء البرلمان، وضُعف إلمامهم بالموضوع وعدم متابعتهم للنقاشات السابقة، ولكن أيضا لأنّ أكثر اللوبيات قُدرة في العادة على التعطيل خرجت هذه المرّة، وعلى نقيض شعارات “العهد السعيد”، منتصرة.
مخاض “سيزيفي” لسنوات
نحتاج أوّلا، لكي نفهم رهانات هذا القانون والخيارات التي كانت متاحة ومواقف مختلف الأطراف منها، إلى العودة قليلا إلى مسار إعداد ومناقشة النصّ. فقد تشكّلت في نهاية 2015 لجنة تفكير صلب وزارة الصحّة، ضمّت ممثلين عن الوزارات المعنية والعمادات والنقابات المهنية والخبراء والأساتذة، بغرض صياغة مشروع قانون ينظم حقوق المرضى والمسؤولية الطبية. إذ لا يوجد نصّ تشريعي يكرّس ويجمع ويضمن حقوق المرضى. في حين تخضع المسؤولية الطبية إلى قواعد عامّة لا تراعي خصوصيّتها، سواء في مجال المسؤولية المدنية (التعويض) أو الجزائية (القتل أو الجرح عن غير قصد). أنتج هذا الفراغ لا مساواة بين المرضى في القطاع الاستشفائي العمومي، الذين يخضع التعويض لصالحهم إلى فقه قضاء المحكمة الإدارية، ومرضى القطاع الخاصّ، وتعطيلا في حصول المرضى على الحقّ في التعويض الذي يأخذ سنوات طويلة. كما أدّى إلى تواتر التتبعات الجزائية ضدّ مهنيي الصحة وإيقاف عدد منهم، بما أثار احتجاج القطاع وساهم، حسب الأطباء على الأقلّ، في ظاهرتين سلبيّتين وهما “الطبّ الدفاعي”، أيّ اللجوء إلى طلب تحاليل غير ضرورية تُثقل كاهل المريض وتفادي أي اجتهاد أو مبادرة غير مضمونة النتائج، وهجرة الأطباء، التي تكثّفت بالأخصّ خلال السنوات الأخيرة.
عملت اللجنة بطريقة تشاركيّة وكان أهمّ الأسئلة التي اعترضتها هو نظام التعويض. فاعتمدت في مرحلة أولى خيار شركات التأمين، أي أن يكون التأمين إجباريّا على مهنيي الصحة في القطاع الخاصّ والمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، على أن تتكفل شركات التأمين بالتعويض عن الأخطاء الطبية وكذلك الحوادث الطبية[1]. لكنّ شركات التأمين رفضت بشكل قطعي تأمين الحوادث الطبية، بالنظر إلى “طابعها الاحتمالي” وغير القابل للتوقع، مقابل تمسّكها بتأمين المسؤولية عن الأخطاء الطبية، أسوة بالمثال الفرنسي، ومطالبتها بفرض إجباريّة التأمين على الخواصّ والمستشفيات العمومية على حدّ السواء، وبتسقيف التعويض وإخضاعه لجدول قياسي[2]. نتيجة لذلك، تخلت لجنة الصياغة عن خيار الاعتماد على شركات التأمين، لصالح خيار النظام التضامني من خلال صندوق وطني للتعويض، يتمّ تمويله بمساهمات إجبارية من مختلف المهنيّين إضافة إلى الدولة، ويتكفّل بالتعويض على الأخطاء والحوادث الطبيّة. كما أقرّت مرحلة تسوية رضائيّة إجبارية قبل المرور إلى الطور القضائي، ونظّمت مختلف إجراءاتها.
مرّ المشروع بعد مصادقة مجلس الوزراء إلى البرلمان، فحافظت لجنة الصحة على خياراته الكبرى، ليُعرض على الجلسة العامّة ليوم 31 جويلية 2019، آخر جلسة عاديّة لبرلمان 2014-2019، كآخر نقطة في جدول أعمالها وتتعذر المصادقة عليه لسوء التنظيم وضعف حضور النواب. وحين عُرض على الجلسة العامّة مجددا يوم 15 جانفي 2020، قرّر النواب الجدد حينها إعادته إلى اللجنة بتركيبتها الجديدة لمزيد دراسته، بعد ضغط من لوبيات المصحات الخاصّة وأطباء الممارسة الحرّة وشركات التأمين. فقد نجحت الأخيرة في إقناع مهنيّي الصحة بأنّ الصندوق المراد بعثه مصيره الإفلاس إذا لم يتمّ تسقيف التعويضات، وأنّ الدولة ستتخلى عن دورها وستحمّلهم وحدهم مسؤولية تمويله. أعادت لجنة الصحة، بتركيبتها الجديدة، نقاشًا تشاركيّا مستفيضا للمشروع وانتهت إلى الحفاظ على خياراته الجوهرية في تقريرها الصادر في آخر الدورة البرلمانية الأولى. لكنّ عرضه على الجلسة العامّة تأخّر بسبب الظروف الوبائية ووجود أولويات أخرى… وتصدّي لوبيات القطاع الخاصّ. بعد سنة، في منتصف جويلية 2021، انعقدت لقاءات لتقريب وجهات النظر بين لجنة الصحة في البرلمان ووزارة الصحة ومختلف المنظمات الممثلة لمهنيي الصحة، ونجحت، حسب أحد المساهمين في أعمال الصياغة، القاضي الإداري السابق والمحامي عصام الصغيّر، في تذليل الصعوبات وإيجاد توافقات تحافظ على حقوق المرضى وعلى فلسفة المشروع القائمة على إحداث صندوق تضامني للتعويض وعدم إخضاع حقّ التعويض لأي جدول قياسي. لكنّ تجميد البرلمان مع انقلاب 25 جويلية 2021 وضع حدّا لهذا الجهد. ولم يكن النصّ الذي أصبح محلّ توافق مع جلّ المنظمات المهنيّة من ضمن أولويات الرئيس سعيّد، الذي احتكر سلطة التشريع عبر المراسيم طيلة أكثر من سنة ونصف، رغم أنّه استعمل الأزمة الوبائية لتبرير “الخطر الداهم”.
فانتظرنا تنصيب برلمان سعيّد، بعد انتخابات غاب عنها الأحزاب والناخبون، ليقترح مجموعة من النواب نسخة جديدة بالاستئناس بالمشروع السابق… مع تغييرات جوهرية. إذ تخلّى المقترح في نسخته المقدمة من هؤلاء النواب عن فكرة صندوق التعويض، ليحدّد كجهات للتعويض عن الأخطاء والحوادث الطبية، شركات التأمين (في القطاع الخاصّ) والدولة (في القطاع العامّ). انطلق بذلك مسار تشريعي تتالت فيه التنازلات لفائدة شركات التأمين على حساب البقيّة، مرضى ومهنيّين.
حقوق المرضى لا تطرح إشكالا
لم تطرح حقوق المنتفعين بالخدمات الصحيّة، طيلة النسخ المتعاقبة من مشروع القانون، إشكالا يُذكر. ولا تختلف الصيغة النهائية المصادق عليها في هذا الباب كثيرا عن المشروع الحكومي الأول. أوّلها حقّ الانتفاع بالخدمات الصحية في أفضل الظروف الممكنة دون أيّ تمييز (الفصل 4)، وحرية اختيار الهيكل أو المؤسسة الصحية مع بعض الاستثناءات (الفصل 5)، وحقّ مغادرتها أو رفض متابعة تلقي العلاج مع مراعاة استثناء الإيواء الوجوبي وبعض الإجراءات (الفصل 11).
كما يلتزم مهنيو ومؤسسات الصحة بتقديم الخدمات الصحية لطالبيها طبقا للقانون وفي نطاق احترام حقوقهم وحرياتهم وحفظ كرامتهم (الفصل 6)، ويعملون على ضمان سلامتهم وفقا لمواصفات جودة العلاج (الفصل 9). أمّا واجب حسن استقبال المرضى ومرافقيهم، ووضع علامات الإرشاد والتوجيه الضرورية وتمكينهم من إبلاغ مقترحاتهم وتشكياتهم والتعامل معها، فتمّ إضعافه في النسخة المصادق عليها ليصبح واجب بذل عناية (“تعمل على” عوض “تلتزم”). كما تمنح المؤسسات الصحية، عند التعهد بحالات استعجالية، الأولوية لتقديم الخدمات الصحية الضرورية على أن تتم تسوية المسائل الإدارية والمالية لاحقا (الفصل 8)، وهي حاجة حقيقيّة في ظلّ تعمّد جلّ المصحات الخاصّة فرض شروط مالية مسبقة.
ويبقى من أبرز الحقوق وأكثرها إثارة للنقاش وتفصيلا في الإجراءات، هو واجب إعلام المنتفع بالخدمة الصحية (أو وليه الشرعي أو المقدم عليه)، بصفة مسبقة، بهوية الطبيب المعالج والكشوفات والعلاجات المقترحة وجدواها ومدى تأكدها وأخذ رأيه بشأنها، مع إعلامه بالمخاطر المتوقعة، وكلّ ذلك بلغة مبسطة ومفهومة، والتنصيص في الملفّ الطبي على الإعلام (الفصل 12). كما نصّ مشروع القانون المصادق عليه على استثناءات لواجب الإعلام، وهي الحالات الاستعجالية التي تكون حياة المريض فيها مهددة، ورفض الأخير تلقي الإعلام، وتعلّق الإعلام بمرض خطير أو مُهلِك بما يؤثر على حالته الصحية، بشرط إعلام العائلة أو من يعيّنه المريض (الفصل 13). كما كرّس النصّ واجب الحصول على الموافقة الحرّة والمستنيرة للمنتفع بالخدمة الصحية (أو وليه إذا كان مقيّد الأهلية) على تلقي العلاج، بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا، باستثناء الحالات الاستعجالية. كما يحقّ للمنتفع النفاذ إلى الملفّ الطبي والحصول على نُسخة كاملة منه (الفصل 17)، وفي حماية معطياته الشخصية بما فيها المعطيات المضمنة في الملفّ الطبي (الفصل 16). وكلّ إخلال بهذه الحقوق والواجبات يعدّ خطأ مهنيا موجبا ليس فقط للتتبعات التأديبية و/أو القضائيّة، ولكن أيضا لطلب غرم الضرر. لكنّ التنصيص على هذه الحقوق، قابله في النسخة الأخيرة المصادق عليها تقليص فعليّ في أهمّ الرهانات، وهو الحقّ في التعويض.
حقّ التعويض… على مقاس شركات التأمين
كانت خيارات المسؤولية الطبية، كما كان منتظرا، الأكثر عرضة للتعديل خلال المسار التشريعي الجديد. ولئن حافظ البرلمان على خيار تنظيم التسوية الرضائيّة، التي من شأنها تخفيف العبء على المحاكم وتسريع الحصول على التعويض، فقد تخلى عن إجباريّة المرور بها وجعلها إمكانيّة اختياريّة للمنتفعين بالخدمات الصحية. لكنّ التغييرات الأهمّ مسّت مجال التعويض ومقداره ونظامه، استجابة لإرادة شركات التأمين.
تغيير مضلّل لأساس المسؤوليّة:
قد يظهر للوهلة الأولى، لمن لم يتتبّع المخاض التشريعي، أنّ النسخة الأخيرة المصادق عليها وسّعت في مجال التعويض، بالمقارنة ليس فقط مع النسخ السابقة، بل ومع نظام المسؤولية الطبية في تونس إلى الآن ومع الغالبية الساحقة للتجارب المقارنة. فقد صوّتت الجلسة العامّة على مقترح تعديل على الفصل 24 (23 في النسخة المصادق عليها)، في اتجاه إقرار “الضرر” أساسا للمسؤولية الطبية لمهنيّي الصحة، بعد أن كانت في النسخ المتتالية مؤسّسة على “الخطأ” (وهي القاعدة العامّة في الأنظمة المقارنة في العالم). وهو تعديل اقترحه المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في رأيه. يعني ذلك، نظريا، هامشا أكبر للحصول على تعويض، حيث لا يُشترط إثبات الخطأ والعلاقة السببيّة بينه وبين الضرر (وهو ليس بالأمر الهيّن في المجال الطبي)، وإنما فقط حصول الضرر (وهو الأسهل). لكنّ هذه القراءة تسقط بمجرّد قراءة الفصول الموالية التي تفصّل هذه المسؤولية، والتي يحيل إليها الفصل 24. فالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية مسؤولة عن “الأخطاء الطبية” المرتكبة من مهنيي الصحة الراجعين لها بالنظر والذين تستقبلهم في إطار الشراكة. والمؤسسات الصحية الخاصّة مسؤولة عن “الأخطاء الطبية” المرتكبة من مهنيي الصحة الراجعين لها بالنظر، طالما كانوا أجراء لديها. في حين يكون أطباء الممارسة الحرّة، وأطباء القطاع العامّ الممارسون لنشاطهم بعنوان خاصّ (نشاط خاصّ تكميلي، APC) مسؤولين عن الأخطاء الطبية التي يرتكبونها. كما يتحمل جميعهم المسؤولية عن الإخلال بالتزاماتهم القانونية. في كلّ هذه الحالات، أساس مسؤوليّة مهنيّي الصحة هو الخطأ، وليس الضرر.
أمّا المسؤولية الموضوعيّة عن الأضرار الناتجة عن التعفّنات المرتبطة بالخدمات الصحّية، وعن الأضرار الناتجة عن الموادّ والمنتجات الصحية التي يستخدمونها (مع إمكانيّة الرجوع على المتسبّب فيها)، فقد كانت موجودة في النسخ الماضية للمشروع كاستثناء لأساس المسؤولية الطبية لمهنيّي الصحة القائم على الخطأ. لكنّ التغيير الأكبر والأخطر كان حذف الحوادث الطبيّة من مجال الحقّ في التعويض (وهو ما سنأتي عليه مفصّلا في النقطة الموالية). كما حافظت النسخة الأخيرة على استثناءات حقّ الحصول على التعويض، وهي أن يكون الضرر ناتجا مباشرة وكليا عن خطأ المنتفع بالخدمة الصحية أو رفضه أو عدم التزامه بالتوصيات، أو عن مضاعفات متعارف عليها في مرضه، أو عن فشل علاجي. استثناءات هي أيضا مبرّرة بمنطق تأسيس المسؤولية على الخطأ الطبي.
فما الذي يغيّره اعتماد الضرر أساسا للمسؤوليّة بدل الخطأ؟ لو كانت إرادة المشرّعين الجدد تسهيل الإثبات على ضحايا الأخطاء الطبية، لكان بالإمكان الاستلهام من النظريات الفقه قضائيّة التي طبقتها المحكمة الإدارية في مجال المسؤوليّة الطبية، والتي توسّعت كثيرا في مفهوم الخطأ، خصوصا من خلال نظرية الخطأ المفترض (أو قرينة الخطأ) الذي يحوّل عبء إثبات عدم حصول خطأ إلى المؤسسة الصحية. عوض البناء على ذلك، فضّل النواب إسقاط تعديل لم يناقش أبدا، يغيّر أساس المسؤوليّة، من دون أيّة استتباعات في الأحكام التفصيلية التي بقيت مبنيّة على أساس الخطأ. النتيجة، ستكون على الأرجح اضطرابا قضائيّا في التطبيق، أو إسقاط أيّ مفعول عملي لاعتماد الأساس الموضوعي للمسؤولية، خصوصًا بالنظر إلى إقصاء الحوادث الطيبّة من نطاق الحقّ في التعويض، نزولا عند رغبة شركات التأمين. أي أنّ تغيير الأساس القانوني كان، على الأرجح، مجرّد دعاية تحجب التقليص الكبير في الواقع من الحقّ في التعويض.
إلغاء التعويض عن الحوادث الطبيّة:
كانت الحوادث الطبيّة، كما قلنا، من أهمّ رهانات صياغة مشروع القانون، وهي التي دفعت في البداية لجنة الخبراء ثمّ اللجان البرلمانية في 2019 و2020 إلى اعتماد الخيار التضامني. وهو ما نجده أيضا في الأنظمة المقارنة في العالم، حيث أنّ التعويض عن الحوادث الطبيّة، وبصفة عامّة عن المسؤولية الموضوعيّة بدون خطأ، يتمّ بالأخصّ عبر صناديق تضامنيّة أو عمومية (فرنسا وبلجيكا مثلا). فمفهوم الحوادث الطبّية أشمل وأوسع بكثير من حالات التعفن الجرثومي والضرر الذي تسبّبه تجهيزات أو موادّ صحّية، التي اقتصر عليها النصّ المصادق عليه. إذ يشمل على سبيل المثال المضاعفات التي تحصل في الكثير من الأحيان بعد عمليات جراحيّة، التي قد تؤدي إلى أضرار وخيمة من دون أن يسبّبها أيّ خطأ طبي. وقد كانت المشاريع الأولى تميّز بين المفاهيم الثلاثة. أمّا النسخة النهائية، فأبقتْ على تعريف الحادث الطبّي في الفصل الثالث، بوصفه “كلّ طارئ طبّي يقع بمناسبة تقديم خدمة صحية ويلحق ضررا غير عادي بالغير بالنظر إلى المعطيات العلمية القائمة في غياب كلّ خطأ”، مع حذف كلّ الإحالات عليه في الفصول اللاحقة.
إقصاء الحوادث الطبّية يمثّل في حدّ ذاته تضييقا فادحا من الحقّ في التعويض، خصوصا وأنّ التطور التكنولوجي للطبّ يزيد بالضرورة من احتمالية حصول الحوادث الطبّية[3]. وهو تراجع ليس فقط على المشروع الحكومي القديم، بل وعلى مقترح النواب أيضا في صيغته الأصلية، الذي أقرّ التعويض عن الحوادث الطبية في القطاع الخاصّ عن طريق شركات التأمين وفي القطاع العامّ من طرف الدولة. ويبدو أنّ حذف الحوادث الطبية ناتج عن تضافر ضغط شركات التأمين مع الإرادة الحكومية في عدم تحمّل الدولة مصاريف التعويض، بسبب سياسة التقشّف. فقد طالب وزير الصحة علي المرابط اللجنة البرلمانية بـ”الإبقاء فقط على شركات التأمين كجهة وحيدة مكلفة بالتعويض في القطاعين العام والخاص على حدّ سواء وذلك لكون الدولة غير قادرة على دفع التعويضات اللازمة والتي سيرتفع مقدارها بشكل كبير بعد صدور قانون المسؤولية الطبية وهو ما يقتضي إلزام جميع المؤسسات الصحية العمومية بإبرام عقود تأمين”[4]. وكان ممثل وزارة المالية قد أكّد من جهته أنّ شركات التأمين تقصي الحوادث الطبية من عقود تأمين المسؤولية الطبية، وهو ما سيتواصل بلا شكّ بعد دخول القانون حيز النفاذ.
إلغاء السلطة التقديرية للقاضي في تحديد مبلغ التعويض:
ما لا يقلّ خطورة عن التضييق من مجال التعويض، هو وضع سقوف له من شأنها تفريغ مبدأ التعويض الكامل والعادل من مضمونه. إذ ينصّ الفصل 29 على أنّ التعويض على الأضرار البدنية والمعنوية والجمالية، يكون على أساس “نقطة العجز” التي تحدد قيمتها لجنة وطنية يتمّ إحداثها بأمر، على أن تكون قابلة للتعديل دوريا حسب التغييرات الاقتصاديّة والمالية. وعليه، تكون شركات التأمين قد تحصّلت على أهمّ مطالبها، حيث لم يعد التعويض في المسؤولية الطبية خاضعا للسلطة التقديرية للقاضي، حسب الحالة التي أمامه، وإنما يتحوّل إلى مجرّد عمليّة حسابيّة لا يمكن أن تتجاوز سقفا معيّنا. وحده الضرر المهني والناتج عن العجز المؤقت عن العمل (للضحية) والاقتصادي (لذويه في حالة الوفاة)، يُحتسب على أساس الخسارة الفعلية للدخل. ولكنّ ذلك لا يمكن أن يعوّض ضعف التعويض عن بقيّة الأضرار، إذ هو يقتصر على الضحايا النشطين ممن لديهم عمل نظامي يحقّق دخلا يمكن إثباته.
هذا النظام ليس جديدا، فهو معتمد بالأخصّ في التعويض عن حوادث الطرقات منذ قانون 2005، وهو يؤدّي في الواقع إلى حرمان غالبية المتضرّرين من حقّهم في تعويض عادل. وقد أصرّت جمعية شركات التأمين على اعتماد نظام شبيه في المسؤولية الطبية، وهو ما رفضته وزارة الصحة واللجان النيابيّة المتعاقبة قبل 25 جويلية 2021، بناء على الوعي بنتائجه العملية الكارثيّة على حقوق ضحايا حوادث الطرقات، كما يظهر من خلال مختلف تقارير اللجان السابقة[5]. لكنّ البرلمان، ممثّلا بلجنة الصحة ثمّ في الجلسة العامّة، تغاضى عن ذلك. خصوصا وأنّ وزارة المالية ساندتْ هي الأخرى، عند الاستماع إليها، فكرة الجدول القياسي والتسقيف وتطبيق نظام حوادث الطرقات، لضمان “المساواة بين مرضى القطاعين العامّ والخاصّ”[6]. هكذا التقى التقشف الحكومي مع مصالح رأس المال لحرمان ضحايا الأخطاء الطبية من تعويض كامل.
تبنّى البرلمان إذًا خيار تحديد نقطة العجز بنصوص ترتيبية، من دون التفكير حتى في وضع حدود دنيا لها في القانون. وليس مستبعدًا إذًا أن يخضع هذا التحديد، كما الخيار التشريعي، إلى منطق سياسات التقشّف الحكومية وضغط شركات التأمين. مّر هذا الخيار من دون نقاش يُذكر داخل اللجنة، على الأقلّ حسب تقريرها. بل أنّ الفصل مرّ بعد ذلك في الجلسة العامّة من دون أيّ مقترح تعديل، ومن دون أي اعتراض في التصويت (109 موافقين، محتفظ واحد). أي أنّ أحد أهمّ رهانات القانون، والمطلب الأساسي لشركات التأمين، لم يسمع صوتا واحدا يعارضه داخل “برلمان” 25 جويلية.
إجبارية التأمين على الخواصّ:
بعد أن نصّ مقترح القانون في صيغته الأصلية على أنّ جهتي التعويض هما الدولة وشركات التأمين، اختارت لجنة الصحة حذف ذلك الفصل، وجعل واجب التعويض على عاتق المؤسسات الصحية والمهنيين عند ثبوت مسؤوليّتهم. وكان ذلك يعني إبقاء الخيار لهم حول اللجوء إلى التأمين، علما أنّ جلّ الخواصّ لديهم عقود تأمين، وكذلك المستشفيات العمومية الكبرى. لكنّ الخيار استقرّ في النهاية على إقرار إجبارية التأمين على الهياكل والمؤسسات الصحية الخاصّة وأطباء الممارسة الحرّة وأطباء القطاع العامّ الممارسين لنشاطهم بعنوان خاصّ. هكذا نجا القطاع العامّ من إجبارية التأمين، التي كان اقترحها وزير الصحّة نفسه. إذ نصّ الفصل 31 على أن تواصل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية الإجراءات المعمول بها حول التعويضات.
لكنّ إجبارية التأمين على الخواصّ، في غياب التزامات واضحة على عاتق شركات التأمين باستثناء “دفع التعويضات”، ستمنح الأخيرة قدرة تفاوضيّة أكبر لفرض شروطها. وليس مستبعدًا أن تنعكس الشروط الماليّة للتعويض على التعريفات الطبيّة في القطاع الخاصّ، وهو ما أقرّ به ممثّلو وزارة المالية في النقاش داخل اللجنة. كما أحال الفصل 31 إلى قرار مشترك بين وزيريْ الصحة والمالية يحدّد طرق وإجراءات دفع التعويضات وكيفية احتسابها وفقا للقواعد والمقاييس المذكورة أعلاه أي وفقا للجدول القياسي والتسقيف التي طالبت بهما شركات التأمين. مقاييس تعويض ستنطبق على المتضرّرين في القطاعين العامّ والخاصّ، لتساوي بينهما في لاعدالة التعويض.
المسؤولية الجزائية: هل التحصين من السجن حلّ؟
كان تنظيم المسؤولية الجزائيّة لمهنيّي الصحّة من أبرز أهداف مشروع القانون منذ الشروع في صياغته، وذلك من خلال إدخال أحكام تراعي خصوصيّة المهن الطبية (التي لا تتناسب مع أحكام الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية حول القتل أو الجرح من دون قصد)، وإجراءات خاصّة تحصّن الأطباء من “سهولة” لجوء القضاة إلى الاحتفاظ والإيقاف التحفظي.
كانت النسخ المتتالية من مشروع القانون تقرّ “الإهمال الجسيم” أساسًا للمسؤولية الجزائية لمهنيّي الصحة. لكنّ النسخة الأخيّرة استبدلت الإهمال الجسيم بالخطأ الجسيم، نزولا عند رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، مع الحفاظ تقريبا على نفس التعريف في الفصل الثالث باستثناء “التقاعس”. إذ يعني الخطأ الجسيم، حسب الفصل الثالث، “اللامبالاة بسلامة المنتفع بالخدمة الصحية مع ثبوت وجود فارق هامّ وملحوظ بين العناية المقدّمة والمعطيات العلمية القائمة نتجت عنه الأضرار الحاصلة”. وينبني مقترح المجلس القضائي على أنّ مفهوم الخطأ الجسيم أشمل من “الإهمال” الجسيم.
لكنّ اعتماد مفهوم “الخطأ الجسيم” قد يكرّس الخلط بين المسؤوليّتين المدنية والجزائيّة، فهو المفهوم نفسه الذي يتيح أيضا للهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصّة حقّ الرجوع على منظوريها. هذا الخلط بين الخطأ الجزائي والمدني في المجال الطبي دارج في الواقع القضائي، ويؤدّي في كثير من الأحيان إلى التضييق من المسؤولية المدنية في صورة حكم جزائي يبرّئ مهنيّي الصحة[7]، على الرغم من مخالفة ذلك للفصليْن 101 من مجلة الالتزامات والعقود و19 من المجلة الجزائية اللذيْن يكرّسان الفصل بين الخطأ الجزائيّ والخطأ المدنيّ.
أمّا بخصوص الإجراءات، فقد تبنّى البرلمان نظاما شبيها بإجراءات التتبعات الجزائية للمحامين، يقتضي إعلام وكيل الجمهورية سلطة الإشراف القطاعي والهيئة المهنيّة في أجل 72 ساعة، وإحالة الملفّ وجوبا على التحقيق. لكنّ الإضافة، بالمقارنة مع جلّ النسخ السابقة ومع حصانة المحامي، كانت في اشتراط اختبار طبّي وفق نفس القواعد والإجراءات المحددة في إطار التسوية الرضائيّة[8]، لتحديد المسؤولية الجزائية يقرّ “بوجود قرائن جدّية متضافرة تُثبت الإدانة”، كي يتسنّى الإذن بالاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي لمهنيّي الصحة. وهي إضافة تطرح إشكالا حقيقيّا، لم تُناقش هي الأخرى كما يجب. فالاختبارات الفنّية هي من دون شكّ أداة مهمّة تُنير القاضي في قراره، خصوصا في مثل هذه القضايا. لكنّ إكساءها صبغة تقريريّة وحاسمة يسحب صلاحية الإيقاف من القضاء ليمنحها إلى الخبراء، أي إلى “القطاع” الطبي، وهو ما يحمّلهم مسؤولية أكبر وقد يدفعهم إلى تغليب منطق التضامن القطاعي. ورغم أنّ سهولة اللجوء إلى الاحتفاظ والإيقاف التحفظي في الممارسة القضائيّة إشكال حقيقي، فالحلّ ليس بالضرورة في تحصين مِهن بعينها، وإن كانت لها خصوصيّة فنيّة تجعل الموت والأضرار الجسديّة احتمالا قائما في أعمالها.
خلاصة
لا شكّ أنّ اللجوء الكثيف إلى الشكايات الجزائيّة ضدّ الأطباء ظاهرة سلبيّة، لا نجدها في أنظمة مقارنة. ولكنّ أهمّ أسبابها، هي صعوبة وتعطّل النفاذ إلى الحقّ في التعويض. إلا أنّ “نواب الشعب”، عوض أن يوسّعوا ويسهّلوا تكريس الحقّ في تعويض كامل وعادل بما من شأنه أن يقلّص شيئا فشيئا من الشكايات الجزائيّة، فضّلوا تفصيل نظام المسؤولية الطبية على مقاس شركات التأمين، وترضية الأطباء المتضرّرين هم أيضا من سطوة شركات التأمين، بتحصينهم جزائيّا.
وعليه، انتهى مخاض التشريع للمسؤولية الطبية بتراجع فادح عن الخيارات الأولى، ورضوخ لمطالب لوبي شركات التأمين. ولعلّ الأدهى والأمرّ، هو أنّ الخيارات لم تناقش بالوضوح الكافي، ربما لإخفاء هذا الانحياز. انحياز ظهر مبكّرا من الاستماعات التي أجرتها اللجنة البرلمانية، والتي اكتفت بالأطراف الحكومية والعمادات والمنظمات المهنيّة للخواصّ. فعلى عكس أعمال اللجان الفارطة زمن “العشرية”، لم تتمّ دعوة الاتحاد العامّ التونسي للشغل ولا الجمعيات الممثلة للمتضررين من الأخطاء الطبية والمدافعة عن الحقّ في الصحّة. فكانت الكلمة العليا لشركات التأمين، التي استطاعت في السنوات الفارطة بفضل تأثيرها على المنظمات والنقابات المهنيّة، تعطيل مشروع قانون وضع حقّ المريض ومصلحته في أعلى سلّم الأولويات. أمّا اليوم، فقد أصبحت تمرّر خياراتها مباشرة بكلّ سهولة، في غياب أيّ نقاش ديمقراطي، وعلى نقيض الشعارات الثوريّة والاجتماعيّة ومزاعم الحرب على اللوبيات، التي تصمّ السلطة كلّ يوم آذاننا بها.
[1] سلمى منيف، قراءة في مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية، ملتقى حول مشروع القانون عدد 41 لسنة 2019، من تنظيف الجمعية التونسية لقانون التأمين بالتعاون مع الجامعة التونسية لشركات التأمين، سبتمبر 2020.
[2] أنظر: مجلس نواب الشعب، تقرير لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية عدد 2019/41، جويلية 2020، ص. 29 و30.
[3] Anis Ladhar, La faute et la responsabilité en matière médicale, Préface de Sami Jerbi, Centre de Publication Universitaire, 2014, p. 351 et s.
[4] مجلس نواب الشعب، تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية (عدد 2023/30)، مارس 2024، ص. 11 و12.
[5] أنظر مثلا تقرير 2020، سبق ذكره، ص. 20، 26، 27، 64.
[6] مجلس نواب الشعب، تقرير لجنة الصحة لمارس 2024، سبق ذكره، ، ص. 30.
[7] Anis Ladhar, op. cit., p. 177.
[8] نظّم النصّ الاختبار الطبي في مجال المسؤولية المدنية في الفصول 42 إلى 46، عبر لجنة خبراء تتكون من ثلاثة أعضاء من ضمن قائمة الخبراء العدليين المعتمدين، يعينهم رئيس اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض (قاض إداري أو عدلي). ويكون من بينهم وجوبا طبيب شرعي وخبيران في الاختصاص أحدهما استشفائي جامعي. ويمكن إضافة خبراء آخرين عند الاقتضاء أو الاستعانة بآراء ذوي الكفاءة.