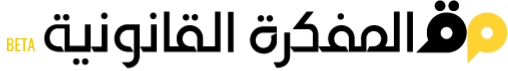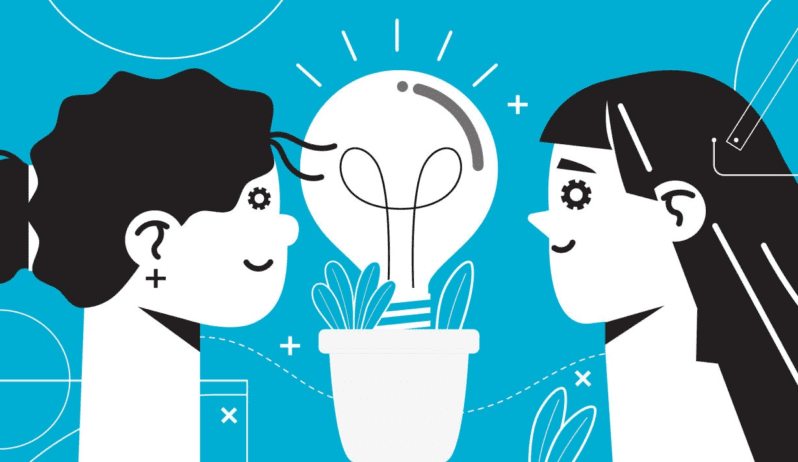استهل تلاميذ الباكالوريا في تونس، صبيحة الخامس من جوان، سلسلة الاختبارات بمادة الفلسفة. إلاّ أنّ هذه المادة التي تعتبر من ركائز ولبنات التفكير المنهجي والنقدي لدى التلميذ في السنوات النهائية من الدراسة الثانوية، لا تزال تكابد تهميشا متواصلا ضمن المنظومة التعليمية وبالأخصّ النظام البيداغوجي القائم على “الكفايات”. كما تُساهم محدودية استيعاب المتخرجين من شعبة الفلسفة ضمن “سوق الشغل”، في ظلّ سياسات التقشّف العمومية وتهميش “الإنسانيّات”، وسيطرة الخطاب النيوليبرالي الذي يختزل الجامعة في دور مصنع لليد العاملة التي يطلبها “الاقتصاد” ويرتّب الشعب والاختصاصات وفقا لـ”طاقتها التشغيلية”، في إبعاد الفلسفة من دائرة الشعب “المُفضلة” خلال عملية التوجيه الجامعي للتلميذ، لتتحوّل تدريجيّا إلى “سلّة مهملات” التوجيه. أزمة الفلسفة هي إذن جزء من أزمة أشمل، تمس كافة فروع العلوم الإنسانية والإجتماعية التي لا تلبي حاجيات رأس المال، والتي تدفع أكثر من غيرها ثمن استقالة الدولة من أدوارها.
تدريس الفلسفة في التعليم الثانوي: مشاكل منهجية
أثار تصريح أحد المسؤولين في وزارة التعليم العالي عن العلوم الإنسانية والاجتماعية باعتبارها “مهارات مرنة” (soft skills) انتقادا أكاديميا جديا[1] حول ما آلت إليه المكانة الاعتبارية لهذه العلوم وكأنها قد أضحت مجرد عنصر مكمل ضمن ثقافة المؤسسات الاقتصادية وليس كاختصاصات علمية ذات شأن في التطور الروحي والفكري والإنساني للمجتمعات. ليست هذه الأزمة خصوصيّة تونسيّة، بل أثارت ولا تزال نقاشا واسعا في أماكن عديدة، حول ضرورة تدريس هذه العلوم المفيدة في إدراك الذات وفهم الآخر وسط تفاقم الأزمات النفسية ومظاهر الاكتئاب المرتبطة بسيطرة القيم النيوليبرالية على المجتمعات خلال العقود الأخيرة. فالإنسانيات تلعب دورا أساسيّا في إحياء قيم العدالة والتضامن الاجتماعي والاندماج وفي التحفيز على النقاش والنقد، على نقيض قيم الخضوع والتنميط التي تُراهن الثقافة النيوليبرالية في المقابل على ترسيخها لضمان تواصل سيطرتها ورقابتها على المجتمع[2]. وإذا كانت الفلسفة، نظريا، هي أكثر التخصّصات إذكاءً للملكة النقديّة، فإنّها أيضا، حتى داخل العلوم الإنسانية، الأكثر تهميشا ضمن الهامش.
بيداغوجيا، تكمن أهمية الدراية بالمدارس الفلسفية والإنتاج الفلسفي لدى التلميذ بتكوين معرفة شاملة تهدف إلى توعيته بمفاهيم الاختلاف وتعدد الأفكار في اتجاه أن تثير عددا من التساؤلات والإشكاليات لديه، ويلعب الأستاذ هنا دورا محوريا في توجيه وإرشاد هذه التساؤلات. ومن هذا المنطلق تتكون فرادة منهج تدريس الفلسفة في ابتعادها عن المنهج التلقيني الذي تتسم به معظم المواد الدراسية الأخرى، لتعتمد على مناهج الرصد المفاهيمي للسند الفلسفي عبر تلمس المفاهيم الأساسية للنص وتطويرها ثم البحث عن الإشكاليات المرتبطة بها وصولا إلى الحجاج الذي يُعد من ضمن المراحل الرئيسية في تحليل النصوص الفلسفية وتتبع المواقف التي تتأسس عليها مع العناية بمعرفة الإنتاج الفلسفي والتمكن من أهم مدارسه.
ومنذ سنة 1997 انخرطت تونس في نظام المقاربة بالكفايات الذي شمل أيضا مناهج تدريس مادة الفلسفة. وتعود أسس نظام المقاربة بالكفايات البيداغوجية إلى أعمال عالم النفس والابستيمولوجيا السويسري-الفرنسي جان بياجي (Jean Piaget)، وفي تدريس الفلسفة خصوصا إلى الديداكتيكي الفرنسي ميشيل طوزي (Michel Tozzi)[3]. وقد عوض هذا المنهج طريقة التعليم بالأهداف التي تم اعتمادها منذ فترة ما بعد الاستقلال. ويتميز نظام المقاربة بالكفايات بتغليبه لدور المهارة على حساب تملك المعرفة الأصلية، مما أنتج خللا واضحا في دور المدرسة أو المعهد كمصدر للمعرفة وسط كم المعلومات المتأتية من وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قد تشكل تشويشا كبيرا على ذهن التلميذ حول مصداقيتها. ويتمثل أحد المشاكل المرتبطة بتطبيق نظام الكفايات في المدارس والمعاهد العمومية في العدد الكبير من التلاميذ داخل الأقسام الموجودة، حيث يهدد هذا العائق تعزيز مهارات الحوار والنقاش التي يستوجبها الدرس الفلسفي وإيصال المعلومات التي تتطلب لدى دارس المادة حدا أدنى من التركيز والاجتهاد، مما يدفع العديد من المدرسين إلى اعتماد المنهج التلقيني مع ما يصحب ذلك من تراجع المستوى العام للتلاميذ خلال السنوات الأخيرة. ولا يقتصر الخلل البيداغوجي على هذا الجانب لوحده، إذ ينبغي كذلك مراجعة منظومة إصلاح الامتحانات وإخضاعها لأقصى قدر ممكن من الموضوعية والتقييم العلمي لمجهود التلميذ، في اتجاه تحقيق “مصالحته” مع المادة وترغيبه في إيلاءها ما تتطلبه من اهتمام.
الفلسفة في الجامعة: هامش الهامش؟
على المستوى الوطني، وفي سياق رصد المحاولات الأولى لتدارُس الفلسفة في تونس خلال العصر الحديث، يمكننا الإشارة إلى دروس مجموعة من المفكرين الإصلاحيين، الذين تميز من بينهم محجوب بن ميلاد في القرن العشرين. لكن التراث الفلسفي في تونس يظل أعرق من ذلك بكثير، فقد استوعبت الفلسفة القرطاجية القديمة جملة من المفاهيم الفلسفية المتعلقة بالجوانب القانونية وبفنّ الخطابة وتطورت لدى بعض العلماء في القيروان الإسلامية عديد الممارسات الفكرية، التي وإن لم ترتق إلى مستوى النقاش في علم الكلام وتحليل الفلسفة الإغريقية كما كان عليه الحال في المشرق، إلا أنها امتلكت فرادتها الخاصة في تقديم بعض الإنتاجات الفكرية، دون أن ننسى إسهامات ابن خلدون التي يعتبرها الفيلسوف التونسي فتحي التريكي “البداية الحقيقية للفلسفة الاجتماعية”[4]. لكن التنظيم الأكاديمي لدراسة الفلسفة يعود خاصة إلى مرحلة ما بعد الاستقلال مع مجموعة من الأساتذة الفرنسيين من ذوي التوجه اليساري، حيث ترأس قسم الفلسفة الذي تم تأسيسه في الجامعة التونسية سنة 1964 الفيلسوف الفرنسي جيرار دلدال (Gérard Deldal) وبرزت من بين أولئك الأساتذة كوكبة بارزة[5]، أبرزهم ميشال فوكو. . ثم شغل الفيلسوف التونسي عبد الوهاب بوحديبة منصب رئيس قسم الفلسفة بالجامعة خلفا لدلدال وقد اختص بالأساس في الفلسفة الاجتماعية. وبدأت النواة الأولى من الفلاسفة التونسيين في البروز خلال تلك الفترة لتتلوها أجيال أخرى. وقد تميز تدريس الفلسفة في المراحل الأولى بتركيزه على المنهج العقلاني قبل أن تتوسع مجالات المعالجة الفلسفية إلى عديد الفروع والمناهج الأخرى مع إحداث عديد الأقسام والمخابر الأكاديمية المختصة. ويجدر كذلك التنويه بدور عديد الجمعيات المختصة في النهوض بالإنتاج الفلسفي في تونس وفي تطوير طرق التدريس ومن بينها أساسا الجمعية التونسية للدراسات الفلسفية التي تم تأسيسها سنة 1979 والجمعية التونسية للجمالية والإنشائية.
وتُجابه تدريس الفلسفة جامعيا بعديد المشاكل الناجمة عن توجهات الدولة واستتباعاتها على المستوى الأكاديمي في ظل هيمنة نيوليبرالية على الخيارات التعليمية حسب ما يظهر من خلال الوثائق البيداغوجية للإصلاح التربوي التي ركزت على منح الأولوية للشعب العلمية أو ذات القدرة التشغيلية الأعلى. ومن أهم هذه التحديات محدودية الآفاق الشغلية للمتخرجين من هذه الشعبة التي تحصر معظم المتخرجين من هذه الشعبة في مهنة التدريس فقط، على عكس الدول الغربية التي تولي اهتماما كبيرا بإدماج المتخرجين من الفلسفة في المناصب الإدارية ومراكز القرار بل تتجاوز ذلك إلى ربط التفكير الفلسفي بمختلف الفروع الفكرية والمعرفية. وتؤثر مثل هذه العوامل وغيرها على مستوى جودة الطلبة المتوجهين لهذه الشعبة ضمن المستوى الوطني. ونجد في سنة 2023 كذلك غيابا للمتوجهين إلى شعبة الفلسفة من بعض الشعب العلمية على غرار شعبة الرياضيات وشعبة العلوم التقنية. كما شهد مجموع نقاط آخر موجه إلى شعبة الفلسفة في كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس أدنى مستوى له في السنوات الأخيرة، بـ 95.61 مقابل 100.06 في سنة 2020، مما يُفرز إحالة ضمنية على التراجع المستمر لجاذبية هذه المادة في خيارات التوجيه لدى الطالب. وقد برزت في السنوات الأخيرة محاولات لغلق بعض أقسام الفلسفة في بعض المؤسسات الجامعيّة على غرار دار المعلمين العليا في أكتوبر 2022 بعد قبول طالبين فقط بها على إثر الاختبار الشفاهي، حيث تحججت الإدارة بضعف الموارد المالية وعدم إمكانية توفير إطار تدريسي لهما للتوجه نحو غلق قسم الفلسفة وإلحاق الطالبين بقسم الفلسفة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. وعلى إثر ذلك دخل عدد من الطلبة في إضراب مفتوح لمساندة زملائهم أمام التضييقات التي استهدفتهم من الإدارة.
إذا عُرّبت… هُمّشت؟
يبقى أنّ المقارنة بين الشعب العلمية “النبيلة”، والشعب الأقلّ حظوة في التوجيه، تُبرز وجها آخر مرتبطا في أحيان كثيرة بلغة التدريس. فالشعب الأكثر نخبوية، هي في الوقت ذاته الأكثر تصديرًا للكفاءات إلى دول الشمال، وهي التي يقوم فيها التدريس عموما على اللغة الفرنسيّة، على عكس العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة التي تعدّ من أكثر الشّعب التي تمّ تعريبها، وإن بدرجات مختلفة.
يحمل النقاش حول تعريب العلوم والتدريس في تونس زخما أيديولوجيا وسياسيّا قويّا. وقد مثّل تعريب الفلسفة سنة 1976 حدثا إشكاليا في تاريخ تدريس هذه المادة بين مؤيد للعملية لميزاتها البيداغوجية في توظيف اللغة الأم للتلميذ أو الطالب مما يسهل عملية الاستيعاب المعرفي، ودورها كذلك في فتح آفاق الترجمة العربية للمؤلفات الفلسفية العالمية، وبين ناقد لهذا التوجه بزعم أن التعريب يعيق نفاذ الطالب إلى دراسة الآثار الفلسفية الرئيسية باللغات الأجنبية. وضمن نفس التوجه، يقتفي البعض حمولة إيديولوجية في عملية التعريب، حيث يفسر أستاذ الفلسفة الطاهر بن قيزة بأن هنالك تخوفات قد حصلت تجاه العملية باعتبارها تتجه نحو نزع الجرعة النقدية التي كانت تحتويها المناهج السابقة باللغة الفرنسية وبوابة نحو “أدلجة” للفلسفة[6]. إذ صاحبت عملية التعريب مغادرة عديد من الأساتذة الفرنسيين للمعاهد التونسية مقابل إدماج عدد مهم من أساتذة الفلسفة المتكونين في المشرق، المتأثرين طبعا بالمدارس الإيديولوجية المنتشرة هناك في تلك الفترة مثل الناصرية والبعثية والإسلامية. وقد اعتُمد كذلك على بعض المدرسين المختصين في الفلسفة والفكر الإسلامي في تدريس المادة والذين لم يكن أغلبهم متمكنا بما فيه الكفاية من المدارس الفلسفية الغربية وإنتاجاتها. ويُنظر إلى عملية تعريب الفلسفة أحيانا على أنها نتاج لآراء وشخصية محمد مزالي نفسه زمن توليه لوزارة التربية، الذي سبق له أن تحصل على شهادة الدراسات العليا في الفلسفة الإسلامية عبر بحث تناول دراسة مقارنة بين كتاب تهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي وتهافت التهافت لابن رشد، ثم لم يتمكن من تدريس مادة الفلسفة في المرحلة الاستعمارية ودرس اللغة العربية بسبب تقييد الإستعمار لتدريس التونسيين مادة الفلسفة (باستثناء الفلسفة الإسلامية). لذا كان التعريب جزءا من فلسفة مزالي نفسه حول إصلاح التعليم عبر الربط بين اللغة والهوية الوطنية واعتباره اللغة بمثابة “الوطن العقليّ والإطار الوجدانيّ والرُّكْن الركين للشّخصية الوطنيّة”. وينبغي الإشارة كذلك إلى أن عملية التعريب والموقف منها قد أذكى صراعا في ما بعد داخل المدارس الفلسفية في تونس، حيث ظلت المدرسة التأويلية والهرمنيوطيقية مرتبطة لدى الكثيرين بتيار التعريب في حين حافظت المدرسة التجريبية المنطقية على التواصل مع الجامعات الغربية والعناية باللغات الأجنبية.
غير أنه لا يمكن حشر عملية التعريب لوحدها كعامل منفرد لتفسير تحولات تدريس مادة الفلسفة أو الرهانات المتعلقة بتطوير دورها داخل المنظومة المعرفية أو التربوية. بل إنّ التعريب عموما يحتوي على عديد الجوانب الإيجابية، حيث فتح المجال أمام نخبة واسعة من الأساتذة للإنتاج والبحث بعيدا عن ضرورة التمكن من اللغات الأجنبية و بالتالي تكريس “دمقرطة” لمادة الفلسفة بأفق منفتح للأفكار لا يقف عند حاجز اللغة. فالتعريب مثلا كان من بين أهم الأسباب في إعادة الاعتبار لدراسة آثار الفلسفة العربية القديمة بمناهج بحثية معاصرة بعد أن كان التركيز طوال المرحلة الأولى بحثيا وتعليميا على أفكار الفلسفة الحديثة نظرا لغلبة الأساتذة الفرنسيين في التعليم الثانوي والأكاديمي.
انطلاقا من هذه الملاحظات العامة، يستدعي تجديد دراسة الفلسفة في تونس حزمة شاملة من الإصلاحات ضمن أفق إصلاح العملية التربوية ككل ومراجعة منهجية المقاربة بالكفايات خصوصا. وفي هذا الإطار طُرح مشروع طموح لتدريس الفلسفة للأطفال عبر ورشات تفاعلية للتفكير النقدي في المدرسة التونسية بمبادرة من معهد تونس للفلسفة سنة 2021، وهو مشروع يحتاج إلى رؤية مفصلة ومراعية للخصوصية العمرية للتلميذ بالأساس. غير أن الخطوات الإصلاحية تبقى أعمق من ذلك، وينبغي لها أن تتمثل روح الفلسفة التحررية والنقدية والدفاع عن سيادة الفرد إزاء أشكال السطوة الاجتماعية والسياسية، فمثل هذا التوجه التحرري العقلاني يبقى اليوم من أوكد الأولويات في ظل الانزلاقات الاستبدادية الراهنة وهيمنة الفكر الشعبوي المسنود بروافعه السياسية والاتصالية على المجال العام.
[1] حياة عمامو، قضايا جامعية: العلوم الإنسانية والاجتماعية في منظومة التعليم العالي في تونس: كفاءات أفقية أم علوم مؤسسة، جريدة المغرب، 17 ماي 2021.
[2]Trevor Aleo, the silent crisis: humanities,pedagoy and neoliberalism, www.humanrestorationproject.org, March 14, 2023.
[3] محمد بوحجلة، تعليم الفلسفة في البلدان العربية: الواقع والأهداف والتحديات”، مجلة مقاربات فلسفية، المجلد 10 العدد الأول 2023 ص 196
[4] فتحي التريكي، الفلسفة في تونس: مقدمات أولية، دار كلمة، 2024، ص. 150.
[5] الطاهر بن قيزة، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس: الفلسفة والمدينة، نُشر في موقع الأوان بتاريخ 22 أوت 2020.
[6] الطاهر بن قيزة، المصدر السابق.