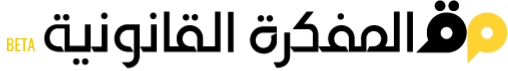ماهية المحاماة العامة
مؤسسة المحاماة العامة، هي مؤسسة دولة متفرعة من النظام القضائي الليبي، ولعلها تضمن الحق في المحاكمة العادلة المتوجب لاستعانة المتخاصمين أمام القضاء بمحام. ويراها البعض من تجليات مبدأ مجانية التقاضي؛ لأنها تقدم للمواطنين بدون مقابل. يحيل مصطلح المحاماة إلى مصطلح الحماية، وهو مصطلح لافت لأنه إقرار بأهمية دور هذه المؤسسة وأعضائها؛ فهم حماة للساعين للعدالة، ولعلهم حماة للعدالة القضائية نفسها؛ فميزانها سيكون مختلاً حال غياب من يمثل المواطنين تمثيلا أمثل أمام القضاء، ولذلك يقال إنهم أعوان للقضاء. أما عن مصطلح “العامة” فهو من أجل تمييز هذه المؤسسة عن المحاماة الخاصة المعروفة قبلها والتي كانت لغاية أوائل ثمانينات القرن المنصرم هي المؤسّسة الوحيدة التي تتكفّل بمهمة حماية الساعين للعدالة القضائية. إلا أنّ مصطلح “العامّة” تم اعتماده مؤخرا في 2013، حيث كان النظام السياسي القائم عند إنشائها في 1981، قد اعتمد مصطلح “الشعبية” تماشيا مع أيدولوجيته المهيمنة القائمة على “الشعبوية” وذلك على غرار الجماهيرية الشعبية، المؤتمرات الشعبية، اللجان الشعبية، محكمة الشعب ..إلخ.
المحاماة العامّة فكرة تبناها النظام السابق. وقد اختلف المحللون بشأن الفلسفة الكامنة وراء استحداثها، فمنهم من قال إنها أحد أوجه تطبيق الاشتراكية التي نادى بها الكتاب الأخضر وأن أفكار الرئيس الراحل معمر القذافي بشأن التأميم طالت حتى المحاماة الخاصة.، ويميل أنصار ذلك الرأي للقول بوجوب إلغاء هذه الفكرة المستحدثة على النظام القضائي الليبي والعودة لما كان عليه الحال قبل ثمانينات الألفية المنصرمة من اعتماد تام على المحاماة الخاصة مع تفعيل العمل بنظام المساعدة القضائية[1]. ومنهم من قال[2] إنها ليست نظاماً للمساعدة القضائية بل هي نظام أوسع نطاقاً من حيث الخدمات والمستفيدين منها. ويرى هذا الرأي بأن المحاماة العامة تتفق مع ما انتهت إليه مجامع فكرية تؤصل حقّ التقاضي وضرورات الدفاع أمام المحاكم والجهات ذات الطابع القضائي وتذود عن محدودي الدخل. ولذا، فإن وجودها خصوصية مهمة في القطاع العدلي في ليبيا وأن المحافظة عليها مع تطويرها يضمن تحصينها من أي إلغاء مع ضمان تكاملها مع آليات الدفاع القانوني الأخرى.
ولعل ذلك ما تبناه صناع القرار بعد 2011، فقد غيروا مسمى تلك الإدارة من المحاماة الشعبية إلى “المحاماة العامة”، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 14 لسنة 2013، في إعلان مهم عن إبقائها بعد فصلها عن أيديلوجية النظام السابق.
أعضاء المحاماة العامة
العاملون بالمحاماة العامة هم المحامون العموميون من حملة الليسانس والحاصلون على تدريب إضافي عقب قضاء عامين في المعهد العالي للقضاء[3]، إضافة لبعض الموظفين المتخصصين في الإدارة أو التقنية يتولى قيادتهم رئيس القلم التابع لرئيس الفرع. يلتحق بالإدارة أيضاً عدد كاف من رجال الضبطية القضائية. وفي بداية الإنشاء 1981 وصف المنتمي لمؤسسة المحاماة، التابعة للدولة، بالمحامي الشعبي، وبعد تعديل 2013 سمّيت بالمحاماة العامة ووصف المنتمي إليها بالمحامي العام، إلا أن مصطلح المحامي العام يتقاطع في النظام القضائي الليبي مع مصطلح أقدم منه لوظيفة أخرى بعيدة عنه في المعنى؛ حيث أن مساعد النائب العامّ على مستوى محاكم الاستئناف يطلق عليه مصطلح المحامي العام[4]. ومنعا للبس، نستخدم مصطلح “المحامي العمومي” للتعبير عن المحامي التابع لإدارة المحاماة العامة وهو موظف عام يعين بدرجة محامٍ تحت التمرين وصولا إلى رئيس إدارة وهو ما يعادل درجة رئيس محكمة استئناف. ويصنف المحامون العموميون بالتدرج من الأدنى درجة إلى الأعلى: محامٍ تحت التمرين، ومحامٍ من الدرجة الرابعة، ثم الثالثة، ثم الثانية، ثم الأولى، وبعدها محامٍ من الفئة ج، والفئة ب، والفئة أ، وأخيرا وكيل إدارة، ورئيس إدارة.
وعلى الرغم من الاعتقاد الشائع بكثرة عدد أعضاء إدارة المحاماة العامة مما يجعلهم يتقاسمون العمل القليل، فيما يعدّ بطالة مقنعة ويجعل من المحاماة العامة ملاذا آمنا لمن يرغب في الحصول على مزايا الهيئات القضائية من دون أن يرهق في العمل، إلا أن بعض المحامين العموميّين يؤكدون أنّه بمراعاة الوضع الحالي وارتفاع معدل الجريمة وارتفاع عدد طالبي الخدمة بكافة الأقسام يعتبر عدد الأعضاء قليلا، وهو ما يؤدي لإرهاق المحامي بسبب كثرة القضايا المسلمة إليه؛ أما إذا زاد عدد المحامين لأصبح بالإمكان أن يأخذ المحامي عددا معقولا حتى يتمكن من أداء عمله على أكمل وجه.
وهناك معايير عدة تراعى في تقييم كفاءة هؤلاء المحامين ومنها[5]:
- عدد القضايا والمنازعات التي باشرها في فترة التفتيش وأنواعها وما أجراه بشأن كل منها.
- مدى اهتمامه بعمله من حيث حضوره الجلسات وتقديم تقرير عن مجريات كل منها لرئيس القسم المختص ومدى متابعته للأحكام وبحث أوجه الطعن فيها، وذلك من خلال اطلاع المفتش على ملفات الدعاوى.
- متابعة العضو للقضايا والاطلاع عليها وتجميع عناصرها وكتابة المذكرات فيها ومدى حرصه على إرفاق المستندات اللازمة بملف الدعوى، وحرصه على تبادل المذكّرات وإيداعها في مواعيدها المحدّدة وعدم طلبه تأجيل الدعوى من دون مقتضى.
- مدى سلامة تقدير العضو للوقائع المعروضة عليه وتكييفها التكييف القانوني السليم، ومتابعة التطورات التشريعية والسوابق القضائية، ومدى استعداده للمرافعة ومقدرته للرد عما يثار من دفاع ودفوع قانونية.
- مدى التزامه بمواعيد العمل الرسمية.، ومدى حرصه على الاحتفاظ بمفكرة قضائية وتدوين الأعمال المسندة إليه وتقديمها للمفتش القضائي عند الطلب.، إضافة لمدى حرصه على إرسال إحصاءاته الشخصية في الأسبوع الأول من كل شهر.
المحامون العامون أعضاء هيئة قضائية وهم زملاء في النظام القضائي لأعضاء السلطة القضائية (القضاة ووكلاء النيابة) ويقال في بيان مزية هذه المؤسسة إنها مدرسة يتعلم فيها المنتمون إليها باعتبارهم أهم رافد للقضاة ويدعمون القضاء لاحقا بقضاة مؤهلين، فالقاضي المنقول من النيابة لا يبرع سوى في الجنائي والقاضي الآتي من إدارة القضايا لا يبرع سوى في الإداري بينما القاضي الآتي من المحاماة العامة يبرع في كل تخصصات القانون.
ومن جهة أخرى، يعدّ النقل إلى المحاماة العامة عقوبة غير مقنّنة لأعضاء السلطة القضائية؛ فالقاضي الذي تحصل على تقدير أدنى من جيد أو يخالف مدونة السلوك القضائي يحول إلى المحاماة العامة. ووكيل نيابة الذي يخالف تعليمات رؤسائه أو يخطئ في تطبيق القانون نتيجة لعدم التأهيل الجيد يُنقل للمحاماة العامة. ولا يمكن أن يعتبر النقل للمحاماة العامة إلا على أنه عقوبة، لأن النقل من القضاء إلى المحاماة هو عزل، عقوبة لأنه أخل بالعمل القضائي، وهي عقوبة مخففة هو مفروض أن يفصل نهائيا أو يحال للخدمة المدنية[6]. ومن الملاحظة الدقيقة يتبين أن هذا النقل ذاي الطبيعة العقابية يكون في الأغلب للرجال من القضاة وأعضاء النيابة وهو ما يرسخ تمييزا سلبيا في اتجاه مؤسسة المحاماة العامة.
هذ الممارسة السائدة عملياً من الجهة الرقابية “إدارة التفتيش” والإدارة العليا “المجلس الأعلى للقضاء” سبق أن انتقدت ونادت الأصوات بضرورة إنهائها[7]، ولعل الطريق الأنجع لإنهائها هو تعديل القانون المجيز لهذه الممارسة غير الرشيدة، سواء المادة 15 من قانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن المحاماة الشعبية، وكذلك المادة 51 من قانون رقم 14 لسنة 2013 بشأن تعديل نظام القضاء.
قيل[8] في سبيل تحسين هذا الخلل البنيوي بوجوب إخراج المحاماة وإدارة القضايا من المجلس الأعلى للقضاء وأن تقتصر السلطة القضائية على النيابة والقضاة فقط، بيد أن أعضاء المحاماة العامة يرفضون فصل الهيئات القضائية ويريدون أن تكون المحاماة داخل المجلس الأعلى للقضاء طمعاً في الحركة العكسية التي تنقلهم من المحاماة للنيابة أو القضاء.
السياقات المؤثرة في عمل المحاماة العامة
ثمة سياقات عدة تؤثر في عمل المحاماة العامة. أبرزها الآتية:
التغيرات السياسية والأطر التشريعية
نشأتْ المحاماة العامة مرتبطة بالنظام السياسيوأن تغيير هذا النظام قد أفسح المجال واسعا للدعوة إلى إلغائها مما أثّر على شعور المحامين العموميين بالقلق على مصير المؤسسة وانعدام الأمن الوظيفي لديهم. إن السياق الدستوري مؤثر جدا حيث تبين أثناء صياغة مشروع الدستور الليبي كيف طالب المحامون العموميون بدسترة المؤسسة حماية لها من السلطة التشريعية التي قد تهددها بالإلغاء.
وتشي صياغة مجمل القوانين المنظمة لعمل المؤسسة ( قانون النظام القضائي/ قانون المحاماة العامة وتعديله/ قانون المحاماة الخاصة/ لائحة التفتيش القضائي/ قرارات المجلس الأعلى للقضاء/ توجيهات النيابة العامة) برؤية ضبابية بشأن المحاماة العامة. وقد أحدثت هذه الرؤية خللا بنيويا في النظام العدلي، تمظهر في هذا التصنيف غير الرسميّ لمؤسسة المحاماة العامة على أنها عقوبة ضمنيّة لرجال القضاء. كما تمظهر في تلك الأعراف العملية الجارية داخل المؤسسة لجهة إنها وظيفة عدلية يمكن للنساء العمل فيها من دون التزام أو إرهاق مع الحفاظ في الوقت ذاته على المزايا الوظيفية للهيئات القضائية.
الفساد الإداري
يتعين علينا التساؤل حول أثر السياق الإداري في الدولة الليبية على فاعلية عمل إدارة المحاماة العامة. وهو سياق يحيط بالمؤسسات العدلية كلها، بل بمؤسسات الدولة الليبية كافة. فالسياق الإداريّ العامّ للدولة الليبية بما فيه من مظاهر فساد إداري يحيط بكل مؤسسات القطاع العام فيها. ومن أمثلتها وهن أنظمة الرقابة، وتفشي ظاهرة البطالة المقنعة، وعدم الاستقلالية المالية والمركزية فيما يتعلق برسم السياسات وصنع القرار، وازدواجية الوظائف، وعدم الانضباط في العمل، ضعف التكوين وعدم التدريب والتطوير.
الاضطرابات الأمنية
السياق العام للبلاد بعد 2011 يتميّز بالانفلات الأمني، والوهن في إنفاذ القانون، وانتشار السلاح، مما يعرض أعضاء الهيئات القضائية للتهديد، ولا تحميهم حتى حصانتهم الوظيفية. وقد شهدت ليبيا حالات اعتداء شهيرة على أعضاء نيابة، وعلى القضاة وعلى أعضاء من المحاماة الخاصة، ولكنها لم تسجل حالات مماثلة على أعضاء المحاماة العامة. لعل السبب في ذلك يرجع لكون أغلبهم نساء، أو لأن قراراتهم وآراءهم ليست مؤثرة على أرض الواقع. ناهيك عن تأثير مرحلة النزاع على سلامة المقرّرات الخاصّة بالمؤسسات العدلية بصفة عامة مما عرضهم لتجربة العمل في مكان غير لائق.
السياق الأمني يحيل المحامي العام والمحامي بصفة عامة للقلق من فكرة أن يكلّف للدفاع عن متهم سياسي أو متهم رأي فهو يعرض نفسه في هذه الحالات لخطر أن يلاحق شخصيا.
الانفلات الأمني يجعل لدى بعض المحامين يقينا أن “قانون القوة” هو المبدأ المحترم لا “قوة القانون”.
هيمنة أدوات ضبط اجتماعي تقليدية
سطوة أدوات الضبط الاجتماعي التقليدية، العائلة والقبيلة، بمنظومتها العرفية المحافظة تؤثر على عمل الإدارة العدلية، في ظلّ تدنّي الوعي بالحقّ في التقاضي، والشعور الدائم بأنّ اللجوء للتقاضي وصمة عار؛ بالذات في القضايا العائلية والقضايا الأخلاقية، وبالذات للنساء. والد إحدى الزوجات فضّل أن تضيع حقوق أبنته وتسلم أولادها على أن يدخلها المحكمة أو يأتي بها لإدارة المحاماة العامة لمحاولة الانتصاف من الزوج. جرائم الإيذاء والقتل العمد والخطأ يتدخل فيها العرف أكثر مما يتدخل فيها القانون. وبالتالي شيوخ القبيلة أكثر فاعلية من المحامين في حسم هذه القضايا.
كما نلحظ تغلغلا سلطويا لتيّار دينيّ متشدّد من أشهر تطبيقاته تلك الرؤية للعلاقة بين نساء العائلة ورجالها وبالذات الأزواج. فهو يرى أن للزوج حق تأديب زوجته وأن المرأة لا يجوز لها الشهادة منفردة ومن باب أولى لا يجوز لها تولي القضاء. وبالتالي فإن هذا التيار يؤثر على فاعلية عمل المؤسسة على العدلية؛ فنجد أن حقّ الزوج في تأديب زوجته من الموروث الثقافي ذي السند الديني وله سند قانوني في المادة 14 من قانون العقوبات الليبي، وتطبيقات قضائية للمحكمة العليا، مما يجعل المحامي الكفوء يدفع به مستندا إلى آيات قرآنية فسرت بأنها مبيحة له، لضمان الفوز في قضية الزوج المتهم بالعنف الزجي ضد الزوجة المعنفة سواء كان المحامي رجلا أو امرأة، في غياب ملحوظ للدفع بالقواعد الدستورية المتضمنة للحقوق والحريات، ومن باب أولى للاتفاقيات الدولية الحقوقية.
ثقافة المحامي العام
القصور اللغوي، حيث أن مذكرات الدفاع المثالية تستلزم الاستشهاد بتجارب مقارنة قانونية وقضائية بالذات اللاتينية لأنها مصدر تاريخي للنظام القانوني الليبي. وهذا يتوجب معرفة جيدة باللغات الأجنبية “الإيطالية الفرنسية”. ناهيك عن مثول جنسيات كثيرة أمام القضاء الليبي في قضايا الهجرة اللا شرعية، وهو ما يتطلب معرفة جيّدة باللغة الإنجليزية باعتبارها لغة عالمية. كل هذه المعرفة اللغوية مفتقدة لدى المحامي العمومي، والعاملين في القطاع العدلي عموما.
نقطة أخرى يمكن أن تشكل سياقا مؤثرا في الأداء العدلي للمحامين العموميين؛ وهي ضعف إجادتهم للغة العربية الفصحى. فاللغة العربية هي اللغة الرسمية المحاكم. فإذا عبّر الساعي عن مظلمته وطلباته بلهجة محلية، فعلى المحامي تحويلها للغة العربية. ويجب أن تعمل مذكرات الدفاع على حسن صياغة السرد اللغوي للوقائع والتفسير اللغوي للقانون والاستشهاد اللغوي بالأحكام القضائية. فإذا عرفنا أن اللغة العربية الفصحى تعاني من إهمال على المستوى العام، وعلى المستوى الأكاديمي في كليات القانون والمعهد العالي للقضاء، وحتى على مستوى الدورات التدريبية للمحامين العموميين، فيمكننا استنتاج معوق مهم في سبيل تحقيق أمثل للعدالة. ولعل دلائل ذلك شكاية القضاة والمفتشين القضائيين من سوء خطّ المحامين وعدم قدرتهم على التعبير عن دفاعهم بطريقة صحيحة. وكذلك يشتكي المحامون من رداءة الخط الذي تكتب به الأحكام.
غياب الهوية الاقتصادية
القاعدة العامة تقتضي أن المحاماة العامة مؤسسة لخدمة محدودي الدخل، والمحاماة الخاصة للمقتدرين. ولكن الواقع يقول أن المحاماة الخاصة تترافع عن محدودي الدخل تحت بند المساعدة القضائية، وتترافع المحاماة العامة عن المقتدرين بحجة أن القانون لا يمنع ذلك صراحة؛ حيث يفترض أن تقدم الخدمات المجانية لمستحقيها فقط، فهذا يساعد في تقليل عدد العملاء، مما يزيد من كفاءة خدمة المحامي.
وفي ظل الفارق الكبير بين ما يكسبه المحامي الخاص وما يتقاضاه المحامي العام، يمكننا تصور خلل اقتصادي قد يؤدي لمظاهر فساد إداري وإن كانت من المظاهر المخفية؛ الطمع في أخذ عطايا من الموكلين الموسرين، الصرف من ماله الخاص على الموكلين المعسرين.
كما يغيب عن ليبيا تنظيم عام للعلاقة بين القطاع العام والخاص، وما يتبعه من غياب لتنظيم قانوني أمثل للعلاقة بين المحاماة العامة والخاصة والتي يفترض أن تقوم على الشراكة والتعاون، وغياب تنظيم وتأطير للمسؤولية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية وتجلياتها في المجال العدلي “المساعدة القانونية المجانية”.
تقييم جودة الأداء الحالي
- تقتصر المحاماة العامة على تيسير العدالة القضائية دون غيرها، فلا تقدم استشارات قبل النزاع القضائي، رغم توجيه القانون بذلك، وقد عمل فرع بنغازي على استحداث مجلس لفض المنازعات وتسجل له بعض النجاحات.
- أغلب العملاء من ذوي الدخل المحدود، بيد أن بعض ميسوري الحال لجأوا للمحاماة العامة لقدرتها على التأثير في القضاة.
- المحاماة العامة وظيفة عامة لا يؤثر كسب القضية أو خسارتها في مردود المحامي العام، والمحامي لا يختار قضيته، والعميل لا يختار محاميه، ولكنهما يجدان في كثير من الأحيان أدوات تواصل اجتماعي ويصنعان معا فريقا متضامنا.
- يحتاج المحامي العامّ لدورات مكثفة بشأن علم النفس التنظيمي وعلم نفس العمل، وذلك لضمان تعامل أفضل مع الموكلين، ولتلافي الأضرار النفسية للمحامين جراء التفاعل مع وقائع القضايا.
- الغالب الأعم من المحامين العموميين يعانون من غياب الكفاءة المهنية والاحترافية المهنية وغياب التطوير والتدريب المستمر، مع وجود نخبة من الأكفّاء يتميزون باحترافية عالية.
- مكانة المحامي العمومي في “المجال الاجتماعي” للنظام القضائي الليبي، تتأرجح بين الاحترام من القضاة والازدراء من الشرطة والنيابة، مما ينقص شعوره بالفخر التنظيمي. أما التنافس مع القطاع الخاص فيؤثر في رضاه الوظيفي. والرؤية التشريعية الضبابية بشأن المحاماة العامة ما بين إلغاء وإبقاء تهدد شعوره بالأمن الوظيفي.
- المحامون العموميون أقل مالا وشهرة من المحامون الخواص، وأقل جاها وسلطة من أعضاء السلطة القضائية، وهذا الوضع من المعوقات الخطيرة لعمل المحاماة العامة لأنها قد تفتح الباب لنوعين من الفساد الإداري لا يقل أحدهما خطورة عن الآخر: الكسب غير المشروع والإهمال الجسيم.
- ثمة خلل ما في نظام المحاماة العامة من خلال الرقابة اللاحقة وليست السابقة، واهتمام المحاميين بعدد القضايا للترقية أكثر من اهتمامهم بنوعها، وما تحتويه من دفوع حقوقية مستندة على أحدث الآراء الفقهية وعلى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة الليبية. فالترقية كحافز يربطها التفتيش القضائي عمليا بمعدل الأداء وليس بكفاءة الأداء، وبربطها بما أنجز وليس بأسباب ما لم ينجز، وبما يختاره العضو من قضايا لتقديمه وليس بما يطلبه المفتش وفقا لمعايير معينة.
- يوجد عرف عملي غير رسمي في الإدارة العدلية بأن تخصص المحاماة العامة للنساء من العاملات في الهيئات القضائية، إلا إنه استثناء يحدث أن تكافأ المميزة منهن بالنقل للقضاء، ويحدث أن يعاقب الرجال من أعضاء السلطة القضائية بالنقل للمحاماة العامة.
مقترحات تعزز من جدوى المآل
من أهمّ المسائل التي يجدر التفكير فيها، الآتية:
- تحسين القوانين المنظمة للمؤسسة العدلية بالتركيز على إلغاء النقل ذي الطابع العقابي المستتر لأعضاء النيابة والقضاة إلى مؤسسة المحاماة العامة
- تعديل قانون الإجراءات الجنائية الليبي لمعالجة عدم توازن القوة بين سلطة الاتهام من جهة ومحامي الدفاع من جهة أخرى.
- إدراج الإدارة العليا للمحاماة العامة في خططها الإصلاحية القادمة للنظام القانوني بأكمله، وبخاصة من خلال التركيز على التدريب وهيكلة عمل المؤسسة، وتعزيز استقلالها المهني.
- العمل على تبني مدونة سلوكيات” أخلاقيات” خاصة بمهنة المحاماة العامة يعمل على إعداداها المحامون أنفسهم، تعمل على تعزيز الضمير المهني لهم باعتبارهم من ركائز مرفق العدالة.
- الدعوة لمبادرات محلية أو دولية لتقليل الصعوبات وتعزيز الفرص لنجاح المحاماة العامة شرط أن تكون مبادرات منسق لها وذات رؤية واستراتيجية ومنسقة، تتضافر الجهود لأجلها.
- العمل الأكاديمي على تقويم دقيق للآراء المتعارضة “الناقدة والمؤيدة” بخصوص المحاماة العامة من خلال الأبحاث ذات الطابع الاجتماعي القانوني.
- تحسين السياسات العامة بشأن المحاماة العامة من خلال التركيز على موضوعين:
- الأنسنة؛ وبالتالي الدعوة لتبني سياسات تضمن معاملة حقوقية يراعى فيها الجانب النفسي والاجتماعي لطرفي العلاقة الإدارية العدلية: الساعي للعدالة والمحامي العمومي، ولعل أهم مظاهر تلك السياسات المثلى؛ الاهتمام الكافي بعلم النفس التنظيمي “علم نفس العمل” في هيكلية المؤسسة وفي خططها التأهيلية، كما أن الاهتمام بالمنظومة القانونية الحقوقية العالمية والوطنية يجب أن يعد سياسة أولية.
- الفاعلية؛ وبالتالي الدعوة لتبني سياسات تركز على ضمان الجودة ولعل أهم مظاهرها تبني الحوكمة الرشيدة والرقابة الشاملة، بما يقلل من بطء العدالة القضائية ويضمن نجاعة الزمن القضائي للرحلة العدلية.
[1] أغلب المحامين الخواص يميلون لهذا الرأي؛ ومنهم السيد النقيب العام للمحامين الخواص في ليبيا فقد أشار إلى ذلك في دورة تدريبية للمحاميات الخواص بمدينة طرابلس حضرتها الباحثة بصفة مدرب بتاريخ: 3 أكتوبر2023
[2] القاضي خالد الشريف على صفحته الشخصية في موقع الفيسبوك بتاريخ: 21/1/2023 ونشر أيضاً في: Libyan Law and Society
[3] هذا يمثل القاعدة ولكن يوجد استثناء عليها: فهناك حملة ليسانس وعملوا بالمحكمة موظفين وبعد قضاء مدة معينة واجتياز دورة أعوان القضاء مكنوا من أن يلتحقوا بالإدارة محامون تحت التمرين. وهناك من جاء للإدارة أثر حركة نقل قضائية حيث كانوا أعضاء القضاء؛ أما وكلاء نيابة مثل أو قضاة.
[4] أشار المستشار جمعة بوزيد لهذا اللبس ودعي لرفعه من خلال تغيير مصطلح المحامي العام واعتماد مصطلح “مساعد النائب العام بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف” أو مصطلح “المدعي العام بمحكمة الاستئناف” . نشر على صفحته الشخصية بموقع الفيسبوك بتاريخ: 5 أغسطس 2021.
[5] المادة 9 من لائحة التفتيش القضائي.
[6] علي بورأس ، مستشار قضائي ، ورشة عمل تونس ديسمبر 2023
[7] جيسيكا كارلايل، “آلية اللجوء للعدالة والمساعدة القضائية في ليبيا: مستقبل إدارة المحاماة الشعبية”، إحدى الدراسات في مشروع ” البحث عن العدالة في ليبيا ما بعد القذافي”، مؤسسة فان فولينهوفن، جامعة ليدن، هولندا،2013، ص:77 وما بعدها
[8] علي بورأس، مستشار قضائي، ورشة عمل تونس ديسمبر 2023