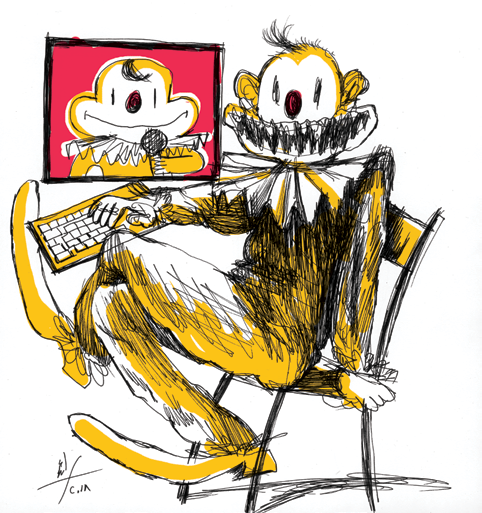لنقل إنّ هارفي واينستين “قبيح ويستحقّ الخصي كعقاب عادل على سنوات من ترويع الممثلات اللواتي اعتدى عليهنّ”. الحديث هنا عن شخصيّة استخدمت نفوذها لسنوات للتحرّش بنساء أقلّ نفوذاً وسطوة، وإيذائهنّ مهنيًّا ونفسيًّا وجسديًّا. جرائم واينستين تبرّر بالنسبة لكثيرين تعييره بالقبح والدعوة لإنزال عقوبات شنيعة به.
لنقل أيضًا إنّ “دونالد ترامب بدين، وبرتقاليّ البشرة، ومريض نفسيًّا، وغبي”. الحديث هنا عن رئيس أميركيّ يعتبره كثيرون في بلاده وخارجها غير صالح لقيادة قوّة عظمى تحكم العالم، ويقول معارضوه إنّه “المتنمّر الأكبر”، ما يبرّر بالنسبة لبعضهم تعييره بشكله أو اضطرابه العقليّ.
كي لا نبتعد كثيرًا، وبالنظر إلى الحالة اللبنانيّة مثلًا، من “الطبيعي” والمعتاد في معجم التخاطب السياسيّ، أن يستخدم المتناحرون عبارات مهينة ومذلّة لتحقير الخصم، سواء كان فردًا أو جماعة. لا يحتاج الأمر إلى جهد كبير لنلاحظ أنّ التخاطب على مواقع التواصل بين اللبنانيين، تخاطب سامّ، ويمتدّ ذلك إلى النطاق العربيّ، حيث لا مجال للحديث عن حريّة تعبير بمفهومها الحقوقيّ أصلًا.
رويدًا رويدًا، تتحوّل وسائل التواصل في مجالها العربيّ واللبنانيّ، إلى ساحة تعبير تحرّك السلطة خيوطها (سواء سلطات دينيّة أو سياسية أو حزبيّة أو مجتمعيًّا)، بعدما عوّل باحثون وناشطون على دورها كإعلام بديل مع بداية الثورات العربيّة قبل سبع سنوات. كأنّ كافّة أنواع الرقابة التي تحاصر الأفراد والصحافيين والفنانين في المجالين العام والخاص، جاءت لتضيّق الخناق على كتاباتهم عبر “تويتر” و”فايسبوك” أيضًا.
إشكالية النقد بين الاحتجاج والتعيير
لنعد إلى وصف واينستين “بالقبيح”، أو ترامب “بالمريض”، أو لنقل إلقاء أوصاف مهينة على الرئيس اللبناني ميشال عون تعيره على خلفية تقدمه بالسن. تعيير عون بكبر سنّه أثار جدلًا على مواقع التواصل في الفترة التي تلت انتخابه عام 2016. رأى البعض أنّ ذلك لا يخرج عن حدود الانتقاد السياسي المباح، خصوصًا أنّ شيخوخة الرئيس قد تؤثّر على أدائه، وتعطي نفوذًا أكبر لفاعلين من فريقه أو لأفراد عائلته. في حين رأى آخرون أنّ هناك عشرات الانتقادات الراجحة التي يمكن توجيهها لرئيس الجمهوريّة، من دون تبنّي تمييز سلبيّ تجاه كبار السنّ.
في الأوصاف الواردة أعلاه، مستوًى أوّل، يعنى بانتقاد رمز سلطة، أو شخصيّة في موقع مسؤولية، أو مشتبه به بارتكاب جرائم، أو خصم سياسي. المستوى الآخر، يعنى باستخدام الصحّة النفسيّة أو الشكل أو السنّ كوسيلة للتقريع، وكأنّها عيوب “إراديّة”، تستدعي التعيير، وليست حالات قد تطال أيّ بشري سواء كان في موقع مسؤولية أم لا.
في المستوى الأوّل، حقّ تكفله القوانين لكلّ مواطن في الدول “الحرّة” (وكلمة حرّة عبارة فضفاضة وتستخدم باستنسابيّة في أحيان كثيرة)، حيث تقارب حريّة التعبير كصنو أساسيّ في النشاط السياسي والحياة العامّة، ولا شيء، في العلن على الأقلّ، يحرم مواطنًا أو صحافيًّا أو ناشطًا أو مغرّدًا من السخرية أو النقد أو التشكيك أو المساءلة.
قد تكون الشتيمة والسخرية سلاح احتجاج سياسيّ، باعتبارها أسلوب الطبقات الأقلّ حظًّا، أو ناس الهامش، في استرداد جزء من السطوة على الفضاء العام، وعلى الكلمة، وعلى الخطاب والسرديات التي تؤطرهم أو تقمعهم. ومن أشكال القمع “الناعمة”، الدعوات لتأديب لغة الشارع، ومحاسبة ما “يخدش الحياء” وما “يمسّ بالمقدّس”، وتحريم السخرية أو قوننتها بما يتناسب مع محاذير الطبقات الحاكمة، بداعي “اللباقة” أو “احترام القوانين”. هذا النوع من “الرقابة باسم اللباقة”، ذريعة لعدم مساءلة السلطة بأي شكل، ولتكريس مفاهيم تقليديّة تجرّد الناس من حقهم بالغضب.
في المستوى الثاني، تعيير بالشكل أو بالاضطراب العقلي، بما يحمله ذلك من تنميط تجاه كلّ من يحمل الصفات ذاتها، ووصمه بوصمة سلبيّة. في هذا المعنى، ينطلق من يستخدم تلك النعوت للتعيير، من خلفيّة تنظر إلى القبح أو التقدّم في السنّ أو البدانة، كأنّها عيوب تحطّ من قيمة الفرد، وتستدعي تمييزه سلبًا عن الآخرين. فهل يندرج هذا النوع من تعيير الخصوم في إطار الحقّ بالتعبير المكفول في شرعة حقوق الإنسان؟ ألا يتنافى مع حقوق أخرى؟ فعند وصف رئيس تعارضه بالبدين أو الخرف، ألا يعني ذلك حرفًا للنقاش عن مكمن الخلل (جرم أو سوء أداء)؟
هل يكون التنمّر على شكل رئيس مقبولًا إن كان هو بدوره متنمّرًا، فقط لأنّه الممثل الأعلى للسلطة، ولأنّ حريّة التعبير لا تستوي إلّا إن كانت مطلقة، ومن دون قيود، خصوصًا في الفعل السياسي؟ وهل يمكن الموازاة بين رفض التعيير بالمطلق باعتباره إهانةً واعتداءً على هويّة أيّ فرد وخصوصيّته وكرامته، وبين الخطوط الحمر التي تفرض على حريّة التعبير، والرقابات المتعدّدة على القول والفنّ والاحتجاج، تارةً تحت عنوان احترام المقدسات، وطورًا ضمن التأويلات الواسعة لتشريعات القدح والذمّ و”خدش الحياء”؟ هل تتحوّل الصوابيّة السياسيّة القائلة برفض التعيير والتنمّر وخطاب الكراهيّة إلى رقابة ذاتيّة من نوع جديد، إلى سلطة أخلاقيّة تأديبيّة قمعيّة، إلى ظلاميّة جديدة؟ أم أنّ رفض التسامح مع التعيير التنميطي على أنواعه، سواء كان موجّهًا لأذية أفراد (التنمّر) أو لاستهداف جماعات (خطاب الكراهية) وسيلة ناجعة لتفادي التطبيع مع تمييز معمّم وراسخ وعنيف؟ تمييزٌ من ذلك النوع الذي قد يدفع شرطيًّا أميركيًّا إلى اعتبار أيّ رجل أسود يسير في الشارع هدفًا مشروعًا لنيرانه، أو ذلك الذي يؤدّي إلى ولادة كلمات بمعانٍ دونيّة في بعض اللهجات مثل كلمة “سيرلنكية” للإشارة إلى عاملة الخدمة المنزليّة في اللهجة اللبنانية.
رصاصة شارلي إيبدو
ليس البحث في “حدود” حريّة التعبير بحثًا مستجدًّا، خصوصًا أنّ كلّ التشريعات في العالم لحظت عقوبات للقدح والذمّ والتشهير والتحقير والتهديد سواء كان كلاميًّا مباشرًا، أو مكتوبًا.
في حالات كثيرة يخشى المدافعون عن حريّة التعبير أن تستخدم تلك التشريعات كأداة لقمع الأصوات المغايرة، أو المعارضة، أو لارتكاب ملاحقات كيديّة بحقّ مجموعات. في المقابل، يتخذ بعض المروجين لخطاب كراهيّة ما، من حقهم المطلق بالتعبير، وسيلةً للتحريض على جرائم ذات طابع عرقيّ أو طائفيّ (أو على الأقلّ التسامح معها وتبريرها).
تشكّل مجزرة قتل صحافيي ورسامي مجلّة “شارلي إيبدو” الفرنسيّة العام 2015، محطة مفصليّة في النقاش حول إشكاليّة حريّة التعبير وخطاب الكراهيّة في العصر الرقميّ. فمن أطلق النار على رسامين مثيرين للجدل اتهمت مجلّتهم في مناسبات عدّة بتبنّي خطاب عنصري أو كاره للمسلمين والمهاجرين، فتح برصاصته الباب على نقاش الحقّ بالسخرية مهما علا سقفها. كما دفع المعنيين للتفكير بأبعاد تلك السخرية حين تحدث على التقاطع بين ثقافات تقارب المقدّس والواقع والسياسة والرقابة بطرق مختلفة، لا بل متناقضة أحيانًا.
بموازاة هذا النقاش، تصاعد تأثير مواقع التواصل على تشكيل الخطاب العام (الانتخابات الأميركيّة الأخيرة، حركة “أنا أيضًا”، …)، لينقل الأمور إلى المستوى التالي. فإن كان التنمّر الجسديّ أو التحرّش اللفظي يطال بالأذى شخصًا أو مجموعة محدودة في المدرسة أو الشارع، فإنّ حصر الأذى أمر شبه مستحيل على الإنترنت. وإن كان خطاب الكراهية في الإعلام التقليدي ضيّق التأثير لناحية توقيت العرض أو الطباعة أو حيّز الانتشار الجغرافي، فإنّ البيكار يتسع كثيرًا على مواقع التواصل، حيث يمكن لصورة تدعو مراهقةً بدينة للانتحار أن تستمرّ بالانتشار لأيّام، وأن تنتقل من مستخدمي بلد ما، إلى مستخدمي بلد آخر، وتختفي لمدّة ثمّ تعود لتطفو من جديد على الشبكة.
واكتشفنا التنمّر!
عند الحديث عن التنمّر، ينظر إلى المصطلح كأنّه مفهوم جديد ولد من رحم فورة التعبير على الإنترنت، وربما استوحاه بعض الناشطين من أفلام المراهقين في الثانويات الأميركيّة. بغضّ النظر عن جدّة المصطلح أو قدمه، وإمكانيّة الاستعاضة عنه بمصطلحات أخرى مثل البلطجة والتعيير والاعتداء اللفظي أو الترهيب، فإنّ التعاطي مع مفهوم “التنمّر” كأنّنا اكتشفناه للتوّ، نكران لظاهرة شائعة جدًّا في المدارس اللبنانيّة وخارجها (انظر العنف اللفظي الشائع خلال زحمة السير مثلًا). لا يحتاج الأمر إلى دقّة ملاحظة لنفهم أنّ الاعتداء اللفظي على أشخاص افتراضيًّا، أو توجيه تهديدات بالأذى لهم، أو ابتزازهم بواسطة تطبيقات المراسلة، ليس إلا انعكاسًا لمشكلة موجودة أساسًا في الواقع -إن كان الفصل بين حقيقتين، واحدة واقعيّة، وأخرى افتراضيّة، لا يزال يدرج في خانة المعايير الصالحة لفهم عالمنا المعاصر.
من ناحية ثانية، مع الاستدعاءات المتتالية لناشطين بسبب مناشير على “فايسبوك” وتغريدات تنتقد هذا السياسي أو ذاك، ومع تكدّس الغرامات والأحكام في محكمة المطبوعات ضدّ صحافيين ومؤسسات إعلاميّة، يمكن القول إنّ ما بقي من حريّة التعبير في لبنان، مجرّد أثر على الرمال.
خلال الأشهر الماضية، ومع استدعاء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة لمواطنين على خلفيّة مناشير على مواقع التواصل، استدعيت إشكاليّة تعريف ماهيّة “حريّة التعبير في العصر الرقميّ”. هنا جماهير تحلّل وتحرّم تحت شعار “هيدي مش حريّة تعبير” تبعًا لمضمون القول، ولدرجة القدسيّة التي يتمتع بها هذا الزعيم أو ذاك عند أتباعه. وهناك جماهير تستهل إطلاق دعوات للقتل والسحل والضرب والاغتصاب على كلّ من يتجرأ على إعطاء رأي مغاير لقناعاتها.
في هذا السياق، كان ملفتًا السؤال عمّا إذا كانت كتابة تهديدات أو شتائم على مواقع التواصل تجاه سياسيين أو وزراء، أمرًا يندرج في نطاق حريّة التعبير كحقّ وقيمة يتوجّب الدفاع عنها، أم يندرج في نطاق التنمّر والتحريض، بموازاة الحديث عن قوانين المطبوعات البالية التي تقيّد النشر خصوصًا في الإعلام الالكتروني. ولأن الموقف من أيّ حدث يتبع لانحياز طائفي أو سياسي، فإنّ كلّ هجوم على الخصم في قاموس المعلقين اللبنانيين، هو حريّة، وكلّ هجوم على ما أو من يمثلهم يندرج في خانة التنمّر والتحقير والقدح والذمّ.
لا مجال هنا لذكر كافة المحطّات التي استخدم فيها النفوذ السياسي لاستدعاء ناشطين للمثول أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة بمبررات واهية. ولا مجال لاستعادة الأحكام بالسجن في قضايا نشر على “فايسبوك” أو “تويتر”، ولا للحديث عن مدى تأخّر التشريعات اللبنانية في فهم كنه وسائل التواصل الاجتماعي، والتعاطي معها بانغلاق وريبة. كلّ ذلك يحتاج بحثًا معمّقًا. لكن إن نظرنا فقط في لائحة الكلمات الأكثر استخدامًا بشكل يوميّ على “تويتر” مثلًا، سنلحظ أنّها لا تعدو كونها امتداداً لخطابات الكراهية السائدة، وللتمييز والإقصاء المتبادلين على أساس طائفي، طبقي، أو مناطقي. يضاف إلى ذلك، كمّ كبير من الأذى اللفظي المتعمّد، وانتهاك الخصوصيّة، وتعيير النساء وتوجيه طاقة كراهيّة جارفة ضدّهن، وصولًا حدّ التهديد العلنيّ بالقتل أو الاغتصاب أحيانًا.
ازدواجيّة معايير
لا يعني التنمّر الالكتروني الاختلاف في وجهات النظر، أو تبادل وجهات نظر سياسيّة أو فكريّة متعارضة، بنبرة عالية. تمامًا كالتنمّر في “الواقع”، فإنّ التنمّر على الإنترنت نوع من البلطجة، يستخدمه فرد أو مجموعة، من موقع قوّة، لإذلال فرد آخر، وإقصائه، وتشويه صورته، وعزله، ما يسبّب أذىً نفسيًّا كبيرًا، قد يتحوّل إلى أذى جسديّ مباشر.
ينطبق ذلك تمامًا على ما تعرّض له الناشط شربل خوري من اضطهاد معنويّ، بعد نكتة كتبها عن القديس شربل على “فايسبوك”، ومعه الصحافية جوي سليم، بسبب تعليق كتبته على منشور خوري، في تموز (يوليو) الماضي. حدّة الهجوم الذي تلا نشر النكتة والتعليق عليها، كافٍ لنتخيّل أن من تنمّروا على خوري وسليم، كان يمكن أن يطالوهما بأذى جسدي عنيف، لو قرّروا تنفيذ الاعتداء على “أرض الواقع”. عشرات الرسائل تلقاها خوري وسليم تهدّد بالضرب، والسحل، والاغتصاب، والقتل. عبارات نابية كتبت لهما عبر الرسائل الخاصة، وشتائم وجّهت لأفراد عائلتيهما علنًا، إلى جانب نشر عناوين منزليهما. التنمّر الإلكتروني تحوّل إلى تنمّر من عناصر في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث تم استدعاؤهما للتحقيق، وقد انتهت النيابة العامة إلى الطلب إلى خوري تعليق حسابه على “فايسبوك” لمدة شهر.
أرست هذه الحادثة معايير مزدوجة في تعاطي السلطة اللبنانية مع فعلين مشابهين. فبخلاف تأديب خوري وسليم والحجر على حريتهما في التعبير، تحت غطاء “قانوني”، لم يحاكم أحد ممّن “عبّروا” عن نيّتهم بارتكاب الفظائع بهما، بالرغم من أنّ مضامين ما تلقوه يحتوي تهديدًا وتحقيرًا ووعيدًا يحظره قانون العقوبات. كما أنّ ما تعرّضا له، لا يتناسب أصلًا مع حجم “الإساءة”، إن وجدت، في المنشور محور الموقِعة.
في مثال بلطجة إلكترونيّة فاقع آخر، نشرت المذيعة في قناة LBCI ديما صادق عبر حسابها على “تويتر”، صورة لابنتها في أوّل يوم مدرسيّ، في أيلول (سبتمبر) الماضي، فإذا بالتعليقات على شكل الطفلة تنهال عبر حساب الأمّ. ربما وجد بعض من يختلفون مع صادق المناسبة سانحة لممارسة “حقّهم في التعبير”، من خلال تعيير طفلة بنظارتيها، أو بشكلها، أو بلون بشرتها. إن استطاع الأهل هنا حماية الطفلة من قراءة التعليقات المؤذية عنها، فلنا أن نتخيّل حجم الأذى المعنوي الذي لحق بوالديها وهما يقرآن ما يكتب عن ابنتهما من دون سبب.
يلجأ أهل السلطة إلى تطويع التشريع بغية إسكات أيّ انتقاد، تحت خانة القدح والذمّ. في الممارسة، يبدو أنّ قوانين القدح والذمّ والتحقير والتهديد تطبّق فقط في حال كان “المعتدى عليه” في السلطة. في هذه الحالة يتحرّك القضاء دفاعًا عن المشاعر والكرامات الشخصيّة. أما إن تعرّض مواطنون آخرون لإساءة مماثلة، فإنّ الاستجابة تختلف. لا نورد هذه المقارنة للقول إنّ الاستدعاء إلى مكاتب أمنيّة غير واضحة الصلاحيّات “مطلوب”، ولكن فقط لإظهار الاستنسابيّة، والمعايير المزدوجة في تطبيق قوانين ربما من الأفضل تحديثها، للتناسب مع حاجات الناس، وليس مع حاجات من هم في الحكم، لتحمي الضعفاء، وليس لتطوّعَ لصالح الأقوياء سواء كانوا سلطة دينية أم سياسيّة أم مدنيّة أم مجموعة من مناصري الأحزاب الغاضبين.
كراهيّة النساء أوّلًا
يأخذ التنمّر والتعيير في الفضاء الافتراضي أبعادًا على درجة عالية من القسوة، إذ يمكن لأيّ حساب تجهل مصدره، أن يهاجم شكلك، عرقك، أفكارك، أن يشتمك، أن ينشر أكاذيب تطال حياتك، أن يدعو إلى قتلك أو رجمك أو اغتصابك. ولكنّه يأخذ أبعادًا أكثر خطورة، حين يتعلّق الأمر بالنساء، والأمثلة في الفضاء اللبناني مزعجة إلى حدّ لا يوصف.
كلّ أسبوع تقريبًا، نجد أنفسنا على موعد مع “سمفونيّة تعيير” جديدة، تطال إحدى العاملات في الشأن العام، وخصوصًا الصحافيّات. هناك شخصيّات تعدّ مغنطيسًا للتنمّر الذكوري، مثل مراسلة MTV نوال برّي، وديما صادق، والحديث هنا بعيد عن مناقشة أو تقييم أدائهما المهنيّ. شتائم شخصيّة تطال السيدتين بشكل دوريّ، ولا نعرف كم مرّة في الشهر تسمعان عبارة “غبيّة” أو “شر..طة”. مذيعات ومراسلات أخريات يتعرّضن لأذىً مماثل، ومن بينهنّ على سبيل المثال مراسلة “فرانس 24” في لبنان كارمن جوخدار التي كتبت تعليقًا عبر حسابها حول تقرير تلفزيوني على قناة محليّة قبل شهرين، فإذا بسيل من التهديدات والشتائم والدعوات للاغتصاب تطالها على “تويتر”.
ثقافة “التعيير بالعهر” من أبرز سمات خطاب كراهيّة النساء والتحرّش اللفظي السائدة على مواقع التواصل اللبنانية. لا نبحث هنا في انتقادات مهنيّة توجّه لهذه الزميلة أو تلك، ولا نتناول بالسؤال إشكالية العقليّة الذكوريّة التي تعتمد معايير لا علاقة لها بالكفاءة في التوظيف خصوصًا في المؤسسات الإعلاميّة المحليّة. الحديث هنا عن التكرار المتعمّد لبعض التعابير والمفردات الهادفة إلى وصم العاملات في المجال الإعلامي بالغباء، والتشكيك بأهليّتهنّ “الأخلاقيّة”، وتشويه سمعتهنّ، وذلك ما لا يتعرّض له بأيّ شكل زملاء رجال يرتكبون هفوات مهنيّة، أو يعبّرون عن انحيازهم على مواقع التواصل.
التنمّر على شخصيّات بعينها، يندرج في سياق أوسع، هو سياق خطاب الكراهيّة السائد تجاه النساء عمومًا، في الثقافة اللبنانيّة. نتذكّر في هذا السياق الحملة التي أطلقتها مجموعة مؤثرين على “تويتر” لدعوة النساء لالتزام المطبخ خلال عرض مباريات كأس العالم الصيف الماضي. الحملة على سخافتها، ومع مشاركة نساء فيها على اعتبار أنّ النكتة “لا تضرّ”، ما هي إلا رأس جبل الجليد في إظهار لاوعي اجتماعي تنميطي وكاره للنساء، مهما حاولنا تبريره، أو تجميله.
ينطبق الأمر ذاته على حملات الكراهية التي تقودها مجموعات طائفية أو حزبيّة على “تويتر” ضد بعضها البعض، وتصل أحيانًا حدّ السخرية من طريقة كلام أحد السياسيين، أو تعييره بمقتل أفراد عائلته، أو تعيير صحافي بلثغته. ومن الأمثلة الفاقعة في الآونة الأخيرة الشتائم المتبادلة بين ناشطَيْن على “تويتر”، على خلفيّة نكات تنميط مناطقيّة وطائفيّة أقلّ ما يقال فيها أنّها تافهة ومقزز: يبدأ الأول بتعيير أهل الجنوب بلفظهم للغات الأجنبيّة، فيردّ الثاني بسؤال الأوّل عن موعد عودة شقيقته من السهرة.
قوانين تحمي السلطة فقط
يكفل الدستور اللبناني “حرية الاعتقاد المطلقة، والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى، تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على ألا يكون في ذلك اخلال بالنظام العام، وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية”.
كما يكفل الدستور “حرية إبداء الرأي قولًا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات ضمن دائرة القانون”.
وفي القانون، يخضع ما يكتب على مواقع التواصل، حتى اليوم، للقانون الجنائي أو قانون المطبوعات، والأخير محطّ سجال مزمن، لما يتضمنه من ثغر تحدّ من حريّة التعبير، مع مئات الأحكام بسجن صحافيين أو تغريمهم أموالًا في قضايا تعبير، توضع تحت خانة القدح والذمّ والتشهير.
من ناحية أخرى، يفرد قانون العقوبات مساحة لجرائم التهديد كتابةً أو قولًا، والتي يمكن أن تطال أيّا كان عبر مواقع التواصل.
كلّ ما سبق للقول أنّه، بعكس السرديّة السائدة، فلا الدستور يحتوي على ما يكفل حريّة التعبير صراحةً، ولا التشريعات. وفي الغالب، لا تستخدم قوانين القدح والذمّ إلا لحماية من هم في السلطة. وهذه إشكاليّة تؤدّي للقول، أنّ حماية حريّة التعبير، وضمان استخدام آمن للإنترنت، لا يمرّان بالضرورة بالمزيد من القوننة.
حماية الجماعات من تبعات خطاب الكراهيّة على الإنترنت، أو تجنيب الأفراد الأذى الناتج عن التنمّر أو التحرّش اللفظي الإلكتروني، معضلة تواجه الشركات المسؤولة عن تشغيل مواقع التواصل أساسًا. بعيدًا عن قوانين قد تضيّق أفق حريّة التعبير أكثر في دول مثل لبنان، يمكن استخدام خاصيّات الحماية عبر “تويتر” أو “فايسبوك” للتبليغ عن أذى، إذ تتشدّد المواقع في وقف أيّ حساب ينشر شتائم أو تهديدات مباشرة، كما تستجيب بسرعة لوقف أيّ حساب ينشر خطاب كراهية موجّهًا ضدّ النساء مثلًا. ولكن، تمثّل تلك الإجراءات بدورها خطرًا على حريّة التعبير، مع اعتماد مواقع التواصل لمعايير غير حياديّة أحيانًا في تقييم المنشورات. لذلك قد يكون الحلّ لمواجهة البلطجة الالكترونيّة على أنواعها، خارج منظومة التشريع. ربما يكون بإقناع الأفراد بأن كتابة “عاهرة” أو “خرف” أو “خنزير” على “تويتر”، بشكل متكرّر، لتعيير الآخرين، اعتداء ومسّ بحقوق الإنسان، وليس رأيًا؟
* تعريف التنمّر الإلكتروني:
بحسب تعريف جمعيّة Ditch The Label يعني التنمّر الإلكتروني (أو التسلّط أو البلطجة على الانترنت)، استخدام التقنيات الرقمية بهدف الإساءة إلى شخص ما، أو إهانته، أو تهديده، أو مضايقته، أو الاعتداء عليه.
* تعريف خطاب الكراهيّة:
بحسب تعريف معجم كامبريدج يعني خطاب الكراهيّة أيّ خطاب عام ]باختلاف الوسيط، سواء كان الانترنت أو أيّ وسيلة تعبير أخرى[ يعبّر عن الكراهية أو يشجع على العنف تجاه شخص أو مجموعة، بناءً على العرق، أو الدين، أو الجنس، أو الميل الجنسي.
* حريّة التعبير بحسب الأونيسكو:
تمثّل حرية التعبير حقًّا أساسيًا من حقوق الإنسان تنص عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتماشيًا مع الحريات الأخرى الملازمة لها من حرية المعلومات وحرية الصحافة، فإن حرية التعبير تسهم بالحصول على سائر الحقوق. وتسلّم المنظمة بأن حقوق الإنسان تطبّق عبر الوسائل الشبكية وغير الشبكية على السواء. الأونيسكو ملتزمة بدراسة القضايا الخاصة بحرية التعبير، وحرمة الأمور الشخصية، والانتفاع بالمعلومات، والأخلاقيات (ethics) عبر الإنترنت.
نشر هذا المقال في العدد | 57 | تشرين الثاني 2018، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:
القمع ليس حيث تنظر: نظام المقامات