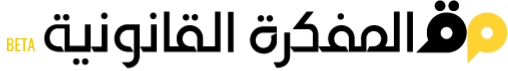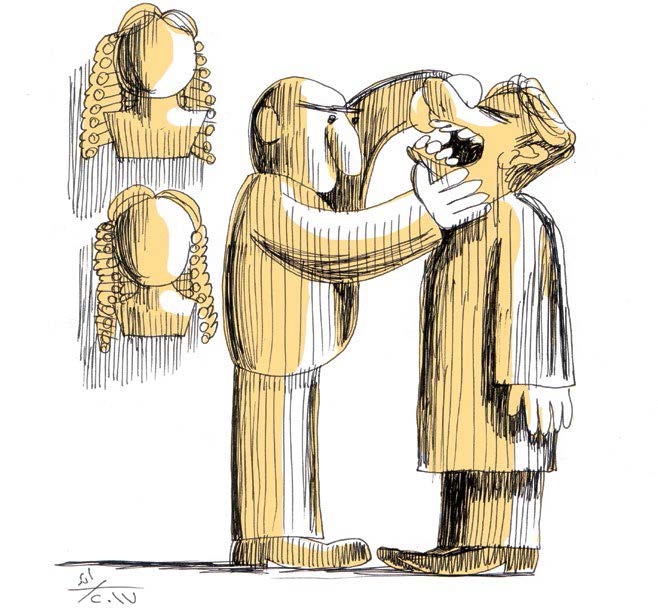يشكل تنظيم الدخول إلى القضاء عاملا أساسيا في إصلاحه، لما قد يوفره من حيوية متجددة فيه. وهذا ما ينطبق بشكل خاص في المراحل الانتقالية، التي تتوفر فيها نية سياسية حقيقية في توفير استقلال القضاء. والمسألة لا تتصل فقط باعتماد معايير تسمح باختيار المرشحين على أساس الكفاءة والنزاهة، إنما أيضا في تحقيق أمر متلازم وإن كان الأصعب، وهو استقطاب العناصر الأكفأ والأنزه، بحيث يشكل الدخول إلى القضاء بالنسبة إليهم هدفا يطمحون إليه. ويهدف هذا المقال إلى استعراض آليات الدخول إلى القضاء قانونا وفي الممارسة، سعيا إلى رسم ملامح القاضي الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أن الإحاطة بهذه المسألة تتطلب ليس فقط درس الأحكام القانونية الأكثر ملاءمة، ولكن أيضا درس كيفية توفير عوامل الجذب للمهنة، وهي مسائل تفترض إنجاز دراسات اجتماعية واقتصادية تتجاوز إطار هذا المقال.
طرق الدخول إلى القضاء العدلي:
في هذا الصدد، سنتناول تباعا المداخل الممكنة قانونا إلى القضاء العدلي. ويجدر منذ البداية التمييز بين نوعين من المداخل:
- المداخل التي تؤدي إلى القضاء من خلال التدرج في معهد الدروس القضائية، بمعنى أن الأشخاص الذين يلجون القضاء من خلال هذه المداخل يعينون أولا قضاة متدرجين في معهد الدروس القضائية، ويصبحون قضاة أصيلين بعد انتهاء فترة تدرجهم التي تستمر ثلاث سنوات، وفقط في حال إعلان أهليتهم من قبل مجلس القضاء الأعلى. ويتم الدخول إلى المعهد عموما عن طريق مباراة أو عن طريق التعيين المباشر من بين الحائزين على شهاداة دكتوراه دولة في الحقوق،
- والمداخل التي تؤدي إلى اكتساب صفة القاضي الأصيل مباشرة. وإذ يتم ذلك عموما من خلال مباراة محصورة بأصحاب الخبرة (محامين، مساعدين قضائيين، موظفين عامين..)، فقد تم في 1994 تعيين مباشر ل 39 قاضيا من بين هؤلاء، من دون تنظيم أي مباراة.
|
جدول 1: عدد القضاة الأصيلين والمتدرجين الحاليين والمعينين قضاة أصيلين وفق طريقة دخولهم إلى القضاء
في الفترة الممتدة من 1991 حتى 2017
|
|
دخول أصحاب الخبرة من دون مباراة
|
39
|
|
دخول أصحاب الخبرة بمباراة
|
44
|
|
دخول الحائزين على دكتوراه من دون مباراة ومن خلال التدرج في المعهد
|
30 ( من بينهم متدرج واحد)
|
|
دخول بمباراة ومن خلال التدرج في المعهد
|
467 (من بينهم 73 متدرجا)
|
|
المجموع
|
580
|
وبمراجعة هذا الجدول، نلحظ أن مباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائية شكلت وما زالت الباب الرئيسي لاستقطاب القضاة، بحيث أنها تستحوذ على ما لا يقل عن نسبة %80 (أو ما يزيد عن أربعة قضاة من كل خمسة) من مجموع القضاة الأصيلين والمتدرجين الذين تم تعيينهم في الفترة الممتدة من 1991 حتى 2017.
مباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائية:
يتضمّن قانون تنظيم القضاء العدلي موادّ تفرض التنسيق والتعاون بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى للدعوة إلى مباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائية. ففيما يكون لوزير العدل صلاحية تقدير الحاجة إلى تعيين قضاة متدرجين بالعدد الذي يراه مناسبا بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى، فإن هذا الأخير يتولى بطلب من وزير العدل تنظيم مباراة لهذه الغاية. ويترك القانون تاليا لوزير العدل تقدير توفر الحاجة، بمعزل عن حجم الشغور في ملاك القضاء. وللمشاركة في المباراة، حدد القانون عددا من الشروط كشرط السن (أن يكون المرشح دون الخامسة والثلاثين من العمر بتاريخ بدء المباراة الخطية) وحيازة إجازة في الحقوق، إضافة إلى وجوب كونه لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة وسلامته من الأمراض والعاهات التي من شأنها منعه من القيام بوظيفته. وفيما لا يوضح النص أنواع العاهات، أشار بحث سابق أنه تؤخذ في الاعتبار السلامة الجسدية والنفسية للمرشح، كسلامة الحواس والعقل والخلو من الأمراض المعدية. وهذا النص يحتاج إلى مزيد من التحديد منعا لسوء استخدامه، على نحو يؤدي إلى حرمان الأشخاص المعوّقين من ممارسة وظيفة القضاء. ويشار إلى أن المادة 69 من قانون حقوق المعوقين تنص على أن “الإعاقة لا تشكل بحد ذاتها حائلا دون الترشيح لأي عمل أو وظيفة”.
كما يضع القانون أنه على المرشح أن يتقن اللغة العربية وإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية (المادة 61). وإلى تلك الشروط، ثمة شرط آخر يتمثل في وجوب قبول أهلية المرشح للاشتراك في المباراة الخطية من قبل مجلس القضاء الأعلى. ويكون لهذا الأخير حق استبعاد أي مرشح عن خوض المباراة الخطية، بعد مقابلته أو حتى من دون مقابلته، ومن دون أن يكون ملزما بتعليل قراره أو بأي ضوابط أخرى. وما يزيد الاستنساب خطورة في هذا الخصوص، هو أن القانون يحصن القرارات المتعلقة بأهلية الاشتراك في المباراة الخطية بحيث يضعها بمنأى عن أي طريق من طرق المراجعة، بما فيه طلب الإبطال لسبب تجاوز حد السلطة (المادة 95 من قانون تنظيم القضاء العدلي).
وقد أناط القانون تنظيم المباراة بمجلس القضاء الأعلى، سواء لجهة تحديد المواد التي تجري على أساسها ومعدل علامات القبول، أو بتعيين اللجان الفاحصة. وفي الفترة الممتدة بين 1991 و2016، جرت 20 دورة بمعدل دورة واحدة كل سنة وأربعة أشهر. وقد أدت هذه الدورات إلى تخرّج 380 قاضياً أصيلا و73 قاضيا ما يزالون يتدرجون في المعهد كما سبق بيانه.
وبالنظر إلى ما تقدم، سجلت المفكرة القانونية مجموعة من الممارسات الضارة بالعمل القضائي، أبرزها الآتية:
- أن الأزمة السياسية الممتدة من 2005 حتى 2008 أدّت إلى وقف هذه الدورات لأكثر من ثلاث سنوات وأنها منذ ذلك الحين تجري بشكل غير منتظم، خلافا لمصلحة تنظيم القضاء حيث ما يزال هنالك 270 مركزا قضائيا شاغرا أي ما يزيد عن ثلث المراكز القضائية،
- أنه طلب من المرشحين على الدورات الأخيرة ملء استمارة هي بمثابة طلب اشتراك في المباراة. ومن مراجعة استمارة مباراة 2016، نلحظ أنها اشتملت على مجموعتين من المعلومات التي يصعب تبريرها أو ربطها بمقتضيات الوظيفة القضائية. فمن جهة، يطلب من المرشح معلومات جدّ خاصة مثل السفرات الخاصة التي قام بها إلى الخارج والهدف من الزيارة واسم المناطق التي أحبها. كما يطلب منه معلومات تتصل بأفراد العائلة على نحو مبالغ به. ومن هذه المعلومات، معلومات عن العمل السابق والحالي والسكن والبريد الإلكتروني لكل من الوالدين والأشقاء والشقيقات والزوجة. ويجدر التساؤل من جهة عن الفائدة المرجوة من هذه المعلومات لقبول الترشيح من عدمه، ومن جهة أخرى، لخطورة استخدامها كأداة للتمييز الطبقي والاجتماعي بين المرشحين،
- أن شروط تأهل المرشح تتوقف على إجادة اللغة العربية وإحدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية. وقد تم مؤخرا رفع علامة التأهيل إلى النصف، فلا يحق لمن لم ينل هذا المعدّل الانتقال إلى المرحلة التأهيلية الثانية. ويلقى هذا الأمر انتقاد البعض على خلفية أن اشتراط اتقان اللغة الأجنبية لقبول الترشح يشكل أداة تمييزية أخرى لصالح خريجي الجامعات الخاصة.
- أنه لا يتسنى لجميع الناجحين في امتحان اللغة خوض المباراة، بحيث يتم استبعاد عدد كبير منهم بعد إجراء مقابلة معهم من قبل مجلس القضاء الأعلى. كما تمّ رصد عدد من الممارسات المقلقة التي تبين أن عملية الانتقاء هذه تحصل على أساس معايير غير موضوعية أو على الأقل غير شفافة. وتعتمد عملية الانتقاء هذه من جهة على التقارير الأمنية المرفقة بملفات المرشحين. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد كشف لـ “المفكرة القانونية” أن المجلس لا يطلب معلومات من جهاز أمني محدد، بل من جميع الأجهزة الأمنية. كما هي تعتمد من جهة ثانية على المقابلة الشفهية مع مجلس القضاء الأعلى أو مع لجان يعينهم. وتبعا لما يراه مناسبا، يعلن مجلس القضاء الأعلى في ختام هذه المرحلة لائحة المقبولين للتقدم للإمتحان الخطي. وعليه، تحصل عملية الإنتقاء هنا على أساس معايير تنتقص إلى حد كبير إلى الشفافية والموضوعية. وتؤشر أرقام نشرت مؤخرا على موقع معهد الدروس القضائية إلى أهمية عملية الاختيار التمهيدية هذه وإلى ارتفاع نسبة المرشحين المستبعدين بفعلها لتصل إلى ما يقارب 60%. ويلحظ أن نسبة المرشحين المقبولين في المرحلة التأهيلية الثانية قاربت الثلث، في تراجع واضح عما كانت عليه قبل حرب 1975-1990 حيث بلغت 67,2% في العام 1974. وهذا الأمر يعني تزايد أهمية المعايير غير الموضوعية وغير الشفافة لاستبعاد نسبة هامة من المرشحين. ومن أشهر الدورات التي تم فيها استبعاد مرشحين عن خوض المباراة الخطية، دورة 1993/1994 حيث تم استبعاد جميع النساء فقط لأنهن نساء، بعدما أخذ مجلس القضاء الأعلى قرارا بحصر المباراة الخطية على الذكور. وقد انحصر آنذاك عدد المرشحين الذين خاضوا المباراة الخطية ب 78 من أصل 350 مرشحا أي بما يقارب 22% من مجموع المرشحين.
- فيما كانت علامات النجاح تأتي من المسابقات الخطية التي يتم فيها تجهيل المرشح، شهدت اجراءات المباريات تعديلا مقلقا في مباراتي 2014 و2016 بفعل زيادة نسبة العلامة المخصصة للامتحانات الشفهية إلى ربع العلامة الإجمالية في 2014 وسدسها في 2016. وما فاقم من تأثير هذه الامتحانات الشفهية، هو توقيتها بعد الامتحانات الخطية على نحو يسمح بالواقع بجعلها وسيلة ممكنة لحسم نجاح المرشح أو رسوبه في المباراة. ومن شأن ذلك أن يؤدّي إلى تقليص ضمانات المباراة المحايدة من خلال تعزيز هامش تأثير أعضاء اللجان الفاحصة في النتائج النهائية، بناء على الاعتبارات التي يجدونها مناسبة والتي قد لا يكون لها أي صلة بكفاءة المرشحين، وفي مقدمها طبعا الاعتبارات الخاصة بهوية المرشح وعلاقاته وانتماءاته.
“كنا نفاخر أننا نجحنا بكفاءتنا في مباراة القضاة ومن دون أي واسطة.
بعد دورتي 2014 و2016، لم يعد بإمكان القضاة أن يقولوا الشيء نفسه”
قاض عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2016
تعيين من دون مباراة وبمعهد (الدكتوراه)
تتمثل هذه الطريقة في تعيين قضاة متدرجين من بين حملة شهادة دكتوراه دولة في الحقوق وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. وقد استخدمت هذه الطريقة 11 مرة منذ 1993، وتم تعيين 32 قاضيا متدرجا بموجبها. ويلحظ هنا أن ثمة استنسابا في قبول المرشحين من دون الاستناد إلى أي معايير موضوعية.
تعيين قضاة أصيلين من بين أصحاب الخبرة
هنا، نتناول تعيين قضاة أصيلين مباشرة من دون المرور بمعهد الدروس القضائية، وذلك من بين المحامين والمساعدين القضائيين والموظفين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والذين لديهم خبرة معينة. وباستثناء حالة واحدة (1994) تم فيها تعيين 39 قاضيا أصيلا من دون مباراة بموجب قانون استثنائي (وهو استدعى الكثير من الانتقادات لجهة اعتماد المحاصصة)،ـ تم تعيين سائر القضاة على هذا الوجه من بين الناجحين في مباراة منظمة على أساس أحكام قانون تنظيم القضاء الأعلى. وقد تم اللجوء إلى آلية التعيين هذه في ثلاث مناسبات: 1993 و1996 و2010.
|
جدول 2: القضاة الفائزون من بين أصحاب الخبرة في مباراة الدخول الى القضاء
|
|
|
محامون
|
مساعدون قضائيون
|
موظفون في إدارات ومؤسسات عامة
|
قضاة متدرجون
|
المجموع
|
|
1993
|
7
|
6
|
1 (وزارة عدل)
|
3
|
17
|
|
1996
|
11
|
|
|
|
11
|
|
2010
|
13
|
|
2 (ضابطان في الأمن العام)
|
1
|
16
|
|
المجموع
|
31
|
6
|
1 3
|
4
|
44
|
وفي عامي 1996 و2013، نظمت مباراة لأصحاب الخبرة، لكن أدت إلى رسوب جميع المرشحين.
أي مكان للاعتبارات الطائفية والجندرية والعائلية في تعيين القضاة؟
في هذا الصدد، سعينا إلى مقارنة التوزيع الجندري والطائفي للداخلين إلى القضاء بموجب مباراة الدخول إلى المعهد مع التوزيع الجندري والطائفي للداخلين إلى القضاء على أساس ملفاتهم تبعا لحيازتهم لشهادة الدكتوراه أو على أساس خبرتهم المهنية (سواء حصل ذلك بمباراة أو من دون مباراة). والسعي إلى هذه المقارنة إنما انبنى على فرضيتين:
الأولى مفادها أن ثمة تفاوتا في تأثير المحسوبية والوساطة في تعيين القضاة وفق الطريقة المعتمدة لذلك: ففيما تقلّ نسبة هذا التأثير بخصوص التعيين عن طريق مباراة الدخول إلى المعهد، أقله قبل زيادة علامة الشفهي في 2014، تبلغ أقصاها بالنسبة إلى التعيينات الحاصلة من دون مباراة (كما حصل في 1994 بخصوص أصحاب الخبرة أو بخصوص الحائزين على شهادة الدكتوراه). وهي تكون متوسطة بخصوص التعيينات نتيجة مباراة لأصحاب الخبرة، وخاصة في 2010 حيث بلغت نسبة الشفهي في مجمل العلامة 50%.
الفرضية الثانية ومفادها أنّ من شأن أي زيادة في تأثير المحسوبية والوساطة أن يؤدي مبدئيا في ظل النظام السياسي الاجتماعي الحالي إلى زيادة الاعتبارات الطائفية أو الجندرية أو العائلية في تحديد القضاة المعينين. ومن الأسئلة التي تفرض نفسها هنا: على فرض أن حيادية مباراة الدخول إلى المعهد أدت إلى خلل في التوزيع الطائفي أو توجه (قد يكون غير مرغوب به من القيمين على الدخول إلى القضاء) إلى زيادة نسبة النساء في القضاء أو إلى إقصاء أبناء القضاة، هل يتم العمل على تصحيح هذه النتيجة غير المرغوب بها من خلال اللجوء إلى وسائل تعيين أخرى؟ وبكلمة أخرى، هل يمكن القول أن من شأن وسائل التعيين الأخرى أن تشكل أدوات لتصحيح نتائج التعيينات في القضاء، بمعنى أن تصبح الدعوة إلى تعيينات من دون مباراة أو إلى زيادة علامة الشفهي على نحو مؤثر أو على أساس الدكتوراه دعوة مبطنة إلى إعادة تحقيق التوازن الطائفي أو إلى تعيين ذكور أو إلى توريث القضاء؟ وفيما يصعب الوصول إلى إجابات جازمة، فإن مقارنة كيفية توزيع القضاة وفق طريقة دخولهم تظهر تفاوتا كبيرا فيما بينها على نحو يعزز الفرضيتين المشار إليهما في هذه الفقرة، ويعطينا إضاءة بليغة حول السياسات المعتمدة أو التي يقتضي ربما اعتمادها مستقبلا. ففيما أدت نتائج المباريات للدخول إلى المعهد إلى تفاوت طائفي (174 مسيحي مقابل 206 مسلم)، تظهر التعيينات وفق آليات التعيين الأخرى نتائج معاكسة على الصعيدين الطائفي (66 مسيحي مقابل 46 مسلم) أو الجندري. وعليه، وبنتيجة إعمال الآليات الأخرى، يضيق التفاوت في التوزيع الطائفي ليصبح (240 مسيحيا مقابل 252 مسلما). وفيما زادت نسبة النساء المعينات بنتيجة المباراة للدخول إلى المعهد (200 مقابل 180) وذلك على رغم حرمانهن من المشاركة في المباراة الحاصلة في 1994، فإن الذكور المعينين وفق آليات التعيين الأخرى يبلغون ما يقارب أربعة ثلاثة أضعاف النساء المعينات وفق هذه الآليةات (85 مقابل 27). وعليه، عاد عدد الذكور ليتفوق على عدد الإناث بفعل آليات التعيين هذه ليصبح (265 مقابل 227). وعليه، جاز القول بأن مقارنة كيفية توزيع القضاة وفق طريقة دخولهم تظهر أن التعيينات من بين أصحاب الخبرة أو الحائزين على شهادة دكتوراه غالبا ما استخدمت كآليات لإعادة التوازن المطلوب طائفيا أو جندريا.
وإلى ذلك، يجدر تسجيل مؤشرات مقلقة على حصول تطور سلبي في السنوات الأخيرة، لجهة إعادة إدخال الحسابات الطائفية في تحديد الفائزين في هذه المباريات، وخصوصا بعد اعتماد امتحان الشفهي وتخصيصه بنسبة عالية من العلامة الاجمالية. وهذا ما أكدته مجموعة من الوقائع الحاصلة بعد إعلان نتائج مباراة 2014-2015 والتي فاز بنتيجتها 33 مرشحا (20 منهم مسيحيون و13 مسلما). فمن جهة أولى، تمّ تأخير إصدار مرسوم تعيين القضاة المتدرجين على خلفية الاحتجاج ضدّ نجاح مسيحيين أكثر من مسلمين بل ربما وفق بعض المؤشرات بهدف تصحيح هذا الوضع. وقد تأكد ذلك من خلال تسجيل سابقة في التنظيم القضائي، قوامها الدعوة إلى دورة ثانية لتعيين 30 قاضيا متدرجا قبل إصدار مرسوم بتعيين الفائزين في مباراة 2014/2015، وتعيين لجنة فاحصة غلبت عليها توجهات طائفية وحزبية معينة. والأهم نتائج مباراة 2016 والتي بدت وكأنها تعكس وتوازن نتائج 2015، بحيث نجح 15 مسيحيا مقابل 25 مسلما وفق إحدى الصحف. وقد خلصت صحيفة الأخبار إلى القول بأن “أولي الأمر في القضاء قد أدّوا قسطهم في عدم المس بـآية 6 و6 مكرّر حرصاً على التوازن الطائفي”. والأخطر من ذلك هو ما نقلته الصحيفة نفسها لجهة أن إحدى شركات خدمة الرسائل العاجلة أرسلت “رسالة مشبوهة تحدثت عن اتصالات بين الأفرقاء المسيحيين تحضيراً لمواجهة جديدة” تبعا لهذه النتائج، على نحو يوحي بوجود مواجهة طائفية في مجال دخول القضاء.
أخيرا، تجدر الإشارة إلى أن التدقيق في أسماء الفائزين في مباريات الدخول إلى المعهد، يبيّن أن 50 من أصل 453 هم أبناء قضاة أي ما يعادل 1/9 وهي نسبة مرتفعة نسبيا. وقد برز الحديث عن توريث القضاء في عدد من المناسبات، وبخاصة في أعقاب الإعلان عن نتائج مباراة 2016 والتي برز فيها فوز 6 من أصل 17 مرشحا من أبناء القضاة في الدورة. وما فاقم الحديث في هذا الشأن هو أن ثلاثة من هؤلاء كانوا أبناء لأعضاء في مجلس القضاء الأعلى.
للاطلاع على النسخة الفرنسية للمقال، انقر/ي هنا
نشر في العدد الخاص عن القضاء في لبنان، للاطلاع على العدد انقر/ي هنا
,”القضاء في الدول العربية”، المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، يروت 2007، ص321 .
يراجع المفكرة القانونية، الأوراق البحثية عن إصلاح القضاء في لبنان، كيف تصبح قاضيا عدليا؟
خطأ مطبعي؟ أعتقد أن الرقم يجب أن يكون 3.