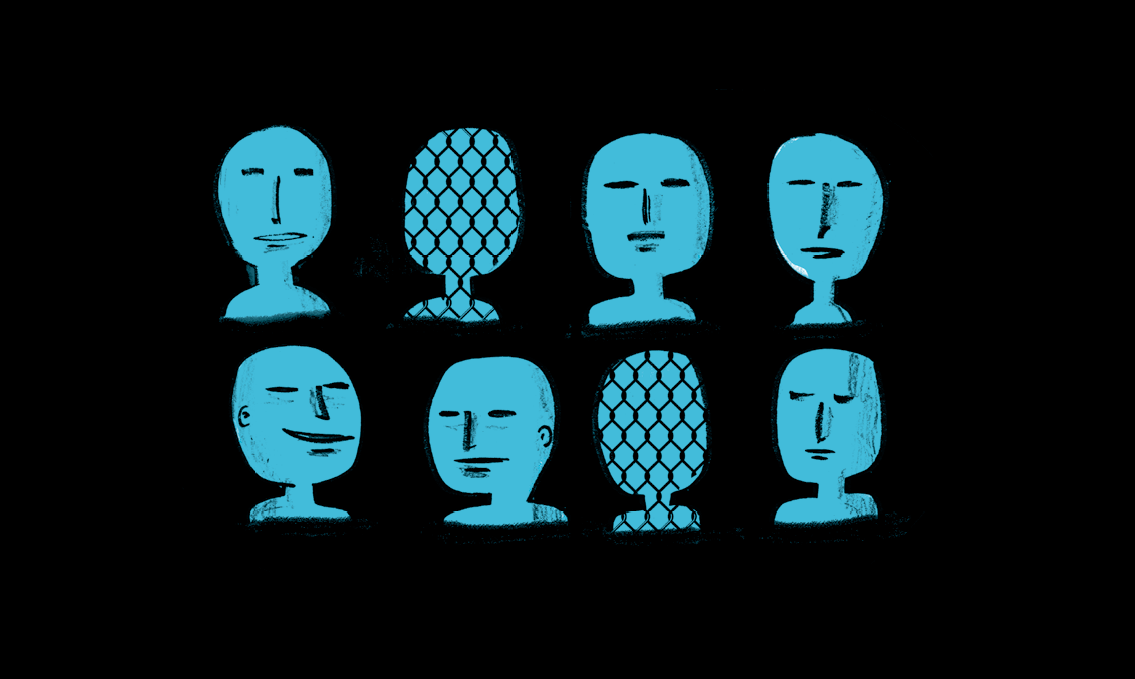بتاريخ 31/1/2019 أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا جوزف تامر حكماً لافتاً قضى بإبطال التعقبات بحق مدعى عليهما أحدهما قسّ، أحيلا أمامه من قبل النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بتهمة إقدامهما على إثارة النعرات الطائفية وتحقير الشعائر الدينية.
وبالعودة إلى تفاصيل القضية، يسجل أن المدعى عليه الأول (وهو لاجئ فلسطيني) عمد إلى تغيير دينه الإسلامي واعتناق المذهب الإنجيلي بعد تعرّفه على مبشّر في الكنيسة الإنجيلية وتردّده على الإحتفالات التي تقيمها. وفي أواخر العام 2001، تعرّف المدعى عليه الأول بالمدعى عليه الثاني وهو قسّ انجيلي، عرّفه بدوره على قسّين نمساوي وسويدي خلال زيارة لهما إلى لبنان، حيث قاما بدعوته إلى السويد للإدلاء بشهادته في حفلٍ تقيمه الكنيسة الإنجيلية لمؤمنيها هناك. إلا أنه وبعد عدم حصوله على تأشيرة لدخول السويد، صوّر شريط فيديو بالتعاون مع المدعى عليه القسّ اللبناني، يوثّق تجربته والأسباب التي دفعته إلى تغيير دينه، لعرضه على المؤمنين العرب في السويد. وبعدما عمدت شركة البريد السريع التي أرسل الشريط من خلالها إلى إحالته إلى المديرية العامة للأمن العام، جرى استدعاء المدّعى عليهما للتحقيق معهما.
وبتاريخ 17/6/2003 أوقف المدعى عليهما بناءً لإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وأحيلا أمام قاضي التحقيق العسكري للتحقيق معهما. وفي 20/6/2003، وتبعا لإعلان قاضي التحقيق العسكري عدم اختصاصه للنظر بالدعوى، أحيل الملف مجددا إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان التي قررت ترك المدعى عليهما بسندي إقامة، والإدعاء عليهما أمام القاضي المنفرد بجنحتي المادتين /317/ و/474/ من قانون العقوبات أي إثارة النعرات الطائفية وتحقير الشعائر الدينية.
وبالتدقيق في الحكم، فإنه يستدعي ملاحظات عدة أبرزها الآتية:
1- إن الحكم عدّد المراجع التي استند إليها والتي من شأنها تكريس حرية المعتقد. وأكثر ما يلفت في هذه المراجع هو تعددها، بحيث أنها شملت ليس فقط الدستور والمواثيق الدولية والعربية التي أقرها لبنان (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان) بل أيضا أسنادا دولية وأوروبية أخرى، كالإعلان العالمي بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. فضلا عن ذلك، فإن الحكم أسند أيضا حرية المعتقد إلى المبادئ الدينية نفسها (الإسلامية والمسيحية) والتي تفترض أن الإنسان يولد حرا وله كامل الحرية في اختيار دينه ومعتقده. ومنها ما جاء في القرآن الكريم الآية 98 من سورة يونس “لو شار ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين” والآية 117 من سورة هود “لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين” والآية 255 من سورة البقرة “لا إكراه في الدين…”. ومنها ما جاء في الإنجيل بشأن حرية أبناء الله الذين خلقهم على صورته ومثاله ومنحهم عطية الحرية في سلوك الطريق المؤدي إلى الحقيقة والحياة الأبدية. وقد بدا القاضي من خلال ذلك وكأنه يسعى إلى إعطاء حكمه مرجعية حقوقية ودينية على حد سواء.
2- أن هذه القضية تشكل شاهدا آخر على ميل أجهزة الدولة، وبخاصة الأمن العام والنيابات العامة، إلى زجر أي مفاضلة بين الأديان، تحسّبا لما قد يسببه هذا الأمر من ردود أفعال في بلد متعدد الأديان. وهذا ما يفسر ربما موقف الأمن العام بإرسال الشريط المصوّر إلى النيابة العامة العسكرية. وقد بلغت حساسية هذا الجهاز إزاء المفاضلة بين الأديان حدّ التوجه إلى القضاء العسكري، بما يعكس حجم المخاوف لديه في هذا المجال. وقد أتى حديث المدعى عليه الأول عن تجاوز ميوله الإرهابية بفعل اعتناقه الدين المسيحي ليعطي الأمن العام سندا لتبرير إحالة الفيديو للمحكمة العسكرية المختصة بمحاكمة الإرهاب. وكان الرقيب الأمني على الأفلام المصوّرة (الأمن العام) اتخذ سابقا عددا من المواقف التي تعبر عن حساسيته إزاء هذه المفاضلة، على نحو يعكس سياسة رسمية قوامها التمسك بأعلى درجة من الحيادية السلبية إزاء الأديان، وهي الحيادية التي تفرض على الدولة أن تبقى على مسافة واحدة من جميع الأديان وأن لا تقدّم ديناً على آخر والأهم… أن تحظر على الأشخاص التعبير عن مفاضلتهم لدين على آخر.
3- على نقيض موقف الأمن العام الذي باشر الملاحقة والنيابة العامة التي أوقفت وادّعت بتحقير الأديان، جاء الحكم ليوسع مدى حرية المعتقد. وقد تم ذلك من خلال أمرين: الأول توسيع تعريف حرية المعتقد بما تفترضه أو تشمله، والثاني، تضييق الضوابط الواجب احترامها في ممارسة هذه الحرية. وقد جاء الحكم انطلاقا من ذلك بمثابة تصويب للنقاشات الاجتماعية حول الواجبات المتأتية عن احترام الأديان، ومنها النقاش الذي بلغ مستويات فائقة في ما سمي قضية شربل خوري، والأهم بمثابة نقد لتصورات الرقابة الأمنية (الأمن العام) ووزارة الثقافة والنيابات العامة. وهذا ما ندركه من خلال الزاوتين الآتيتين:
- الزاوية الأولى تمثلت في التوسع في تعريف حرية المعتقد. فقد اعتبر الحكم أن إقرار الدولة بحرية الدين والمعتقد، يفرض عليها ليس فقط الحياد السلبي وفق التصور الحالي لأجهزة الدولة والنيابة العامة في هذه القضية وبشكل عام، بل أيضا الحياد الإيجابي الذي يتمثل بتأمين حرية المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية ما لم تنطوِ على إخلالٍ من قبلهم بالنظام العام”. وعملا بهذا المفهوم، يتعين على الدولة حماية الممارسات الخارجية (أو أيضا الجماعية) التي تعبّر عن الإيمان، ومنها “حرية الإنسان في إظهار إيمانه إلى العلن (liberté de manifester sa foi) عبر التعبّد، وممارسة شعائره وطقوسه الدينية (liberté de suivre les rites et de pratiquer son culte)، والعمل على نقل إيمانه إلى الغير(propager sa foi)”. بمعنى آخر، يتعين على الدولة الإلتزام بالحيادين السلبي والإيجابي، وذلك بخلاف الأفراد الذين يكون لهم حقّ المفاضلة بين الأديان واختيار الدين الأكثر توافقا مع معتقداتهم: فالتسليم بحرية المعتقد للأفراد يعني ضمنياً التسليم بحقهم بتفضيل عقيدة معينة على جميع العقائد الأخرى وصولا إلى التبشير بها.
ووصولا إلى ذلك، استند الحكم في هذا المجال بشكل خاص إلى المادة السادسة من الإعلان الصادر عن الهيئة العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد الصادر بتاريخ 25/11/1981، والتي اعترفت بحرية نشر القناعة الدينية، وإلى الإجتهاد المقارن، وتحديداً اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي وضعت ضمن حريّة التعبير عن الإيمان (المنضوية ضمن الوجه الإيجابي للحرية الدينية) “حق محاولة إقناع الغير بعقيدته (droit de convaincre son prochain) بواسطة التعليم لأنه بدون الاعتراف بهذا الحق تصبح حرية الإنسان في تغيير دينه حرفاً ساقطاً”(CEDH, affaire Kokkinakis c. Grece, Req. no 14307/88, parag. 31). وقد ذهب الحكم في هذا الإطار إلى حد الإاشرة إلى الشهادة التي “هي من الطقوس المتعرف عليها في الديانة المسيحية على وجه عام وتعتبر إحدى وسائل التبشير ونشر الإيمان المسيحي منذ القدم ذلك أن أحد أوجه ممارسة المؤمن المسيحي لدينه هو أن يشهد لوجود الله في حياته وأن ينقل للغير اختباره في تطبيق كلمة المسيح بين عائلته ومجتمعه وعلى كافة الأصعدة..”.
- أما الزاوية الثانية التي تميز بها الحكم فهي التضييق في تعريف الضوابط على حرية المعتقد، بما يشكل هنا أيضا تصويبا لعمل الرقابة ووزارة الثقافة والنيابة العامة. فبعدما سلّم الحكم بأن “الأصل أن الإنسان حرٌّ في إظهار إيمانه ونشر قناعته الدينية”، رأى أن لا قيد على هذه الحرية سوى احترام النظام العام الذي يشكّل تجريم إثارة النعرات الطائفية وتحقير الشعائر الدينية، بحسب الحكم، بعضا من تجلياته. ولم يكتفِ الحكم هنا بتحديد القيود المقبولة، إنما ذهب أبعد من ذلك في اتجاه إعطاء تعريف ضيق لمفهوم تحقير الشعائر الدينية (Diffamation Religieuse)، والذي لا يكون متوفرا إلا في حال تسبب الفعل المشكو منه بـ “جرح المشاعر الدينية للشخص العادي ذات الحساسية الدينية الطبيعية (l’indignation doit être de nature à blesser les sentiments religieux d’un personne moyenne dotée d’une sensibilité religieuse normale).”
وعليه، نلحظ هنا تحسّب الحكم إزاء أي قراءة مبالغ بها لتصرفات الأشخاص، وذلك من خلال اشتراط أن يتم تقييم الفعل على أساس معيار موضوعي قوامه الشخص العادي ذات الحساسية الدينية الطبيعية، أي الشخص الذي يختزل التصورات الاجتماعية العامة في هذا المجال، بمنأى عن أي تضخيم أو تعصب أو تزمت. وانطلاقا من ذلك، يكون الأخذ بالتصورات المجافية لهذا المعيار بمثابة مبالغة في حماية بعض المعتقدات وعمليا بمثابة تقييد تعسفي وغير مبرر لمعتقدات الآخرين.
ومن هذه الزاوية، يأتي الحكم بمثابة موقف من النقاش الذي دار مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وطال شخصين على خلفية نشر طرفة حول تخيّلات المؤمنين للعجائب التي قد تنتج عن زيارة ضريح أحد القديسين. وفيما هو يناقض في توجهه سلسلة طويلة من مواقف الرقابة والنيابات العامة والتي تميل إلى التوسع في تعريف تحقير الدين ومراعاة الحساسية الدينية، فإنه يلتقي بالمقابل تماما مع مجموعة أحكام قضائية أدّت إلى ردّ ادّعاءات النيابة العامة وعمليا إلى تعزيز حرية المعتقد، وبخاصة من خلال التضييق من تعريف حرية المعتقد.
ومن أبرز هذه الأحكام، الحكم القضائي الذي أبطل التعقبات بحق الفنان مارسيل خليفة على خلفية إنشاده لآية قرآنية من قصيدة: “أنا يوسف يا أبي” لمحمود درويش” (القاضية المنفردة الجزائية في بيروت غادة بو كروم، 1/12/1999). وقد جاء في الحكم آنذاك “أن كل المجتمعات عرفت أنماطاً من السلوك طاولت مختلف نواحي الحياة ولم تراعَ فيها القواعد الدينية، وأنه لا يمكن عدّ أي فعل مخالف أو غير متوافق مع أحكام الدين فعلاً جزائياً إلا إذا كان كذلك وفق قانون العقوبات، (و) أن إنشاد القصيدة تم بوقار ورصانة ينمّان عن إحساس عميق بالمضمون الإنساني، ما ينفي أي مس بقدسية النص القرآني أو يسيء إليه أو الى مضمونه، ولا يحمل إطلاقاً تحقيراً للشعائر الدينية أو ازدراءً بها تصريحاً أو تلميحاً”.
كما يجدر التذكير بشكل خاص بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس منير سليمان (9-5-2007) في دعوى أقامتها النيابة العامة بناءً على شكوى مجموعة طلابية إسلامية في طرابلس ضد جوزيف حداد على خلفية كتابة عدد من المقالات، منها «الإله المخطوف». فبعدما استعرض القاضي مختلف المعتقدات المعنية بالملف (معتقدات اسلامية ومعتقدات علمانية)، أعلن وجوب إخضاع تفسير عبارتي تحقير الدين وإثارة النعرات الطائفيّة (أي ما يمثّل حدوداً لحرية التعبير) لمعايير التسامح وإلّا أدّت الى أغراض مناقضة تماماً لما ترمي إليه. فـ«ليس ما يثير النعرات الطائفية أكثر من تقويض حرية المعتقد وإبداء الرأي وتسليط الضوء على بعض العبارات ذات الدلالات الدينية وإخراجها من سياق ومضمون المفهوم العام لما كتب والقصد منه وما رمى إليه، ووضع تفسيرات ضيّقة لها وحرفية يخرجها عن المعنى المقصود منها». وهذا ما قد يحصل مثلاً في حال سيادة التزمّت والتعصّب في تفسير أقوال الآخرين، بحيث يصبح التوسّع في تعريف الأفعال والأقوال المسيئة أو المثيرة للنعرات وتالياً في اتهام الآخرين بإثارة النعرات الطائفية أوسع باب ليس فقط الى الحدّ من حريّة الرأي والمعتقد، بل أيضاً إلى «إثارة النعرات ومضاعفة أسباب التنازع والتخاصم والفتنة”.
وعلى هدي ذلك، وبعدما سجل الحكم أن المدعى عليه عمد إلى “إجراء مقارنة متواضعة فيما بين آيات من القرآن الكريم وأخرى من الإنجيل المقدس”، وهي مقارنة “قد تكون بنيت على فهمٍ خاطئٍ من قبله للدين الإسلامي الحنيف”، فإنه انتهى إلى القول بأن هذه المقارنة قد خلت “من دون أدنى شك … من أي عباراتٍ جارحةٍ أو مسيئةٍ تنّمُ عن ازدراءٍ أو تحقيرٍ للإسلام بمفهوم المواطن العادي ذات الحساسية الدينية الطبيعية”.