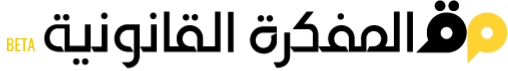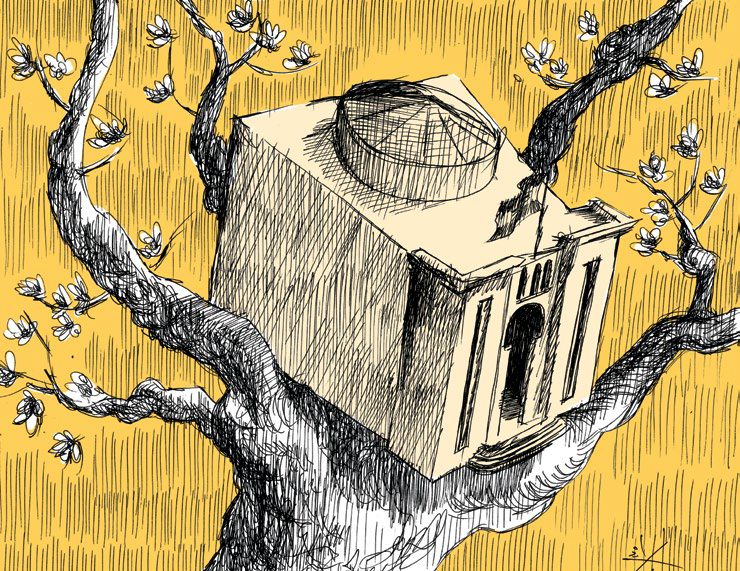في 12 حزيران 2020 صدر قانون “تفسير بعض أحكام المادة 67 من قانون الرسوم القضائية” وقد جاء في أسبابه الموجبة أن دوائر التنفيذ لم تتوافق على تفسير موحد حول كيفية تحديد قيمة العقار المتوجب استيفاء على أساسه الرسوم القضائية الضرورية لذلك كان لا بد من تدخل المشترع لتفسير النص القانوني موضع الإشكال. ومن دون الدخول في مضمون هذا القانون، يجدر التنبيه بأهمية هذا القانون التفسيري[1] كونه يعكس مسيرة طويلة من الجدل النظري حول الجهة المخولة بتفسير القوانين وهو يكرس بشكل غير مباشر عدم صلاحية مجلس النواب لإعطاء التفسير الملزم للدستور.
فقد كرر رئيس الجمهورية في كتابه الذي شرح فيه أسباب رفضه توقيع مرسوم التشكيلات القضائية مطالبته مجلس النواب بتفسير الدستور إذ اعتبر أنه “لن تكون هناك استقلاليّة للسلطة القضائيّة إن لم يتحرر القضاء من القيد الطائفي بتطبيق دقيق للمادة 95 من الدستور”، وقد بادر فخامة الرئيس إلى الطلب من مجلس النواب تفسير هذه المادة للوقوف على مندرجاتها ومراحلها ومستلزمات إلغاء الطائفيّة من حياتنا العامة”. وكان رئيس الجمهورية قد أرسل في 31 تموز 2019 رسالة إلى مجلس النواب يطلب فيه من هذا الأخير تفسير الدستور لجهة شرح “الوفاق الوطني” وما يستتبعه على التمثيل الطائفي في الوظائف العامة، أي أنه أقر أن مجلس النواب يحق له خلال جلسة مناقسة عامة تفسير الدستور وهو الموقف الذي كرره دائما رئيس مجلس النواب.
يشكل صدور قانون تفسير قانون الرسوم القضائية إقرارا صريحا لا لبس فيه من مجلس النواب بأن تفسير القوانين هو صلاحية تعود له لكن ليس بوصفه هيئة سياسية تتولى مراقبة أعمال الحكومة ومناقشة الوضع العام في البلاد بل باعتباره السلطة التشريعية التي خولها الدستور سن القوانين وفق شروط محددة. فمجلس النواب لا يمكنه الإكتفاء بعقد جلسة عامة يناقش خلالها النواب النص القانوني المبهم ومن ثم يتفقون على إعطائه التفسير الضروري بحيث يظل تفسيرهم محصورا في محضر الجلسة، بل لا بد لهم أن يسلكوا المسار الذي حدده الدستور لإقرار القوانين العادية كي يتحول تفسيرهم إلى نص ملزم للجميع، أي أن يتقيدوا بأصول التشريع لجهة النصاب وكيفية التصويت والأكثرية المطلوبة ومن ثم قيام رئيس الجمهورية بإصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية. عندها فقط تتحول إرادة مجلس النواب إلى إرادة السلطة التشريعية الملزمة عملا بالمبدأ التالي: «Eius est interpretari legum cuius est condere» أي إن السلطة التي تسن القانون (إقرارا أو تعديلا) هي المخوّلة بتفسيره.
وقد عبر الفقيه الفرنسي الكبير جان دوما (1625-1695) عن هذا الموضوع، حين اعتبر أن غموض النص واستنفاد القاضي لكل وسائل التفسير الفقهية تحتم إحالة الأمر إلى الملك صاحب السلطة التشريعية حينها كي يحسم الخلاف من خلال إظهار إرادته الحقيقية التي تشرح النص المعني:
«Que si le vrai sens de la loi ne peut être assez étendu par les interprétations qui peuvent s’en faire selon les règles qu’on vient d’expliquer, ou que ce sens étant clair, il en naisse des inconvéniens (sic) contre l’utilité publique, il faut alors recourir au prince, pour apprendre de lui son intention sur ce qui peut être sujet à interprétation, déclaration ou modération, soit pour faire entendre la loi, ou pour y apporter du tempérament»[2].
وقد كرست المادة الأولى[3] من الباب الخامس من مشروع القانون المدني الفرنسي الذي تم إعداده في سنة 1799 التفريق بين تفسير القاضي وتفسير المشترع. فقد اعتبر أن الأول هو تفسير فقهي محصور بالقضية التي تفصل فيه المحكمة، بينما الثاني هو أمر عام يوجهه صاحب السلطة التشريعية على أن يكون ملزما للجميع. ومن هنا نفهم لماذا نصت المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الصادر سنة 1983 على أنه “لا يجوز للقاضي أن يضع أحكامه في صيغة الأنظمة” أي لا يحق له تحويل تفسيره الفقهي للقوانين إلى تفسير عام إلزامي كون ذلك يعتبر خرقا لمبدأ فصل السلطات وتعديا على اختصاص مجلس النواب التشريعي.
ويصبح الأمر أكثر وضوحا في الدساتير التي تنيط السلطة التشريعية ببرلمان مؤلف من غرفتين. فالسلطة التشريعية مثلا في الجمهورية الثالثة الفرنسية كان يتولاها برلمان يتكون من مجلس للشيوخ ومجلس النواب ما طرح مسألة كيفية تفسير القوانين وهل يمكن لمجلس واحد فقط أن يفسر القانون من دون موافقة المجلس الثاني. وبالفعل أثير الموضوع سنة 1883 في جلسة لمجلس النواب كانت نتيجتها أن تفسير القوانين لا يمكن أن يتم إلا بقانون جديد يتم اقراره في مجلسي الشيوخ والنواب[4] أي وفقا للآلية التشريعية التي نص عليها الدستور.
فإذا كان لا يحق لمجلس النواب أن يفسر القوانين العادية إلا من خلال صدور قانون جديد كما حصل مع قانون تفسير قانون الرسوم القضائية، فكم بالحري الدستور الذي لا يمكن لمجلس النواب أن يفسره ليس فقط من خلال نقاش عام يتم تكريس نتيجته في محضر “جلسة التفسير”، بل أيضا من خلال قانون عادي بوصفه السلطة التشريعية إذ ان الدستور يسمو على كل التشريعات ولا يمكن تعديل أحكامه إلا عبر آلية خاصة أكثر تشددا لحظتها صراحة المواد 76 و77 و78 و79 من الدستور.
جراء ما تقدم، يتبين لنا أن تفسير الدستور كي يصبح ملزما للجميع لا يمكن أن يتم إلا عبر قانون دستوري يتم إقراره وفقا للشروط التي فرضها الدستور من أجل تعديله أي عبر إتباع الآلية الدستورية المعقدة التي تفرض نصابا مشددا وأكثرية مشددة على مجلس النواب من أجل إقرار التعديل. فمجلس النواب في هذه الحالة لا يعدل الدستور بوصفه السلطة التشريعية بل بوصفه السلطة التأسيسية التي خولها الدستور تعديل أحكامه.
لذلك، وخلافا لما يعلنه رئيس الجمهورية وما يكرره رئيس مجلس النواب، لا يحق للبرلمان تفسير الدستور في جلسة عامة بنصاب عادي وأكثرية عادية ليس فقط للأسباب التي أدلينا بها أعلاه، لكن أيضا من أجل تحصين الدستور من التفسيرات التي تهيمن عليها المصالح السياسية الآنية والتوازن المتقلب بين زعماء الطوائف.
[1] يشار هنا ان مجلس النواب سبق له وأن أصدر قبل 1990 قوانين تفسيرية كالقانون الصادر في 24 حزيران 1971 والمتعلق بتفسير قانون مزاولة مهنة الهندسة، والقانون الصادر في 27 أيار 1939 بتفسير قانون المختص بالديون المدنية المحررة بعملة غيبر العملة اللبنانية.
[2] Œuvres complètes de J. Domat, Tome 1, Paris, 1828, p. 89.
[3] Il y a deux sortes d’interprétation; celle par voie de doctrine et celle par voie d’autorité. L’interprétation par voie de doctrine consiste à saisir le véritable sens d’une loi, dans son application à un cas particulier. L’interprétation par voie d’autorité consiste à résoudre les doutes par forme de disposition générale et de commandement.
[4] « Dans la séance de la Chambre des députés du 29 mai 1883, il a été reconnu qu’il n’appartient à aucune des deux Chambres d’interpréter isolément la loi et qu’il n y a pas d’autre manière de l’interpréter que d’en faire une nouvelle ». Eugène Pierre, Traité de droit politique électoral et parlementaire, p. 95.