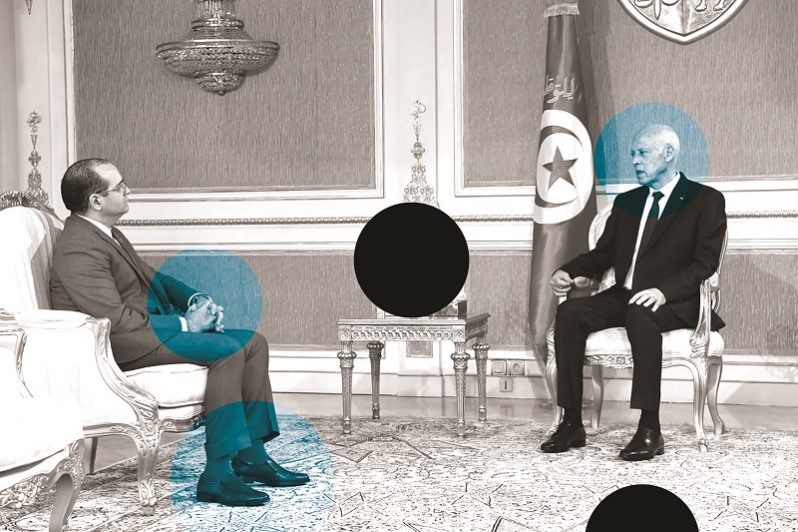تمّ تحيينه بتاريخ 08/09/2022
لا ينفكّ الرئيس قيس سعيّد عن اتهام كلّ من يعارض مساره بأنّه “يخافُ الإرادة الشعبية”. أليس الشعب هو الذي “سيقول كلمته” في الاستفتاء؟ ألا يكفي ذلك لاعتبار دستور 2022، بغضّ النظر عن المحتوى، أكثر ديمقراطيّة من دستور 2014 الذي صادق عليه نواب المجلس الوطني التأسيسي؟
إنّ هذه الحجة، التي لا يتردّد أنصار الرئيس في استعمالها، تقوم على مغالطة كبرى تعتبر الاستفتاء في جوهره آلية ديمقراطيّة. مغالطة لم تكن أبدا خافية على مدرّس القانون الدستوري قيس سعيّد، الذي سبق وأن عبّر في مناسبات عديدة على معظم الانتقادات والشكوك التي توجّه إلى آلية الاستفتاء، ثمّ تنكّر لها بمجرّد استوائه على عرش السلطة المطلقة.
فالاستفتاء لا يضمن في حدّ ذاته الديمقراطية، وإنما يبقى ذلك رهين توفّر عدد من الشروط التي تغيب عن استفتاء 25 جويلية 2022. لا يتعلّق الأمر فقط بالسياق غير الديمقراطي، حيث يحتكر فاعل سياسي واحد كلّ السلطات، ويتحكّم في القواعد المنظمة للاقتراع ويغيّرها كما يشاء أسابيع قبل الموعد، بالإضافة إلى تدجين مختلف الفاعلين المتدخلين في العملية الانتخابية. حتّى لو كان هذا السياق ديمقراطيّا، وكانت العملية الانتخابية شفافة، وهذا غير متوفّر، فإنّ الطابع الديمقراطي للاستفتاء ليس مضمونا أبدا، خصوصا عندما يتعلّق الأمر بالدساتير.
المخاطر اللا ديمقراطية للاستفتاء
لا نكاد نحصي الأدبيات الموجودة في النقد الديمقراطي للاستفتاء[1]، والتي عاد الاهتمام بها بصفة كبيرة في السنوات الأخيرة بعد البركسيت. ما يميّز هذا النوع من النقد، هو أنّه يستهدف مباشرة الادّعاء الديمقراطي للاستفتاء، ليبيّن قصوره في كثير من الأحيان عن التعبير عن الإرادة الشعبيّة. فهو لا يعبّر عن موقف نخبوي معاد لجوهر الديمقراطية المتمثّل في حكم الشعب، الذي ينعكس في ما يسميه روسانفالون “النقد الأرستقراطي للاستفتاء”[2]، وإنّما على العكس، يضع الأصبع على المخاطر اللا ديمقراطية التي قد تتأتى عن الاستفتاء. يلخّص أستاذ النظرية الدستورية ستيفن تيرناي هذه المخاطر بثلاثة: تلاعب صاحب المبادرة بالإرادة الشعبية، وافتقار الاستفتاء للتداول، والخطر الأغلبي على الأقليات[3]. استفتاء سعيّد، بغضّ النظر عن إشكال شرعيّة الانقلاب على الدستور وعن الشكوك حول نزاهة العمليّة الانتخابيّة، هو مثال جليّ على الخطريْن الأول والثاني.
يمكن أن نلخّص الخطر الأول في مقولة آرنت ليبهارت: “معظم الاستفتاءات خاضعة للسيطرة وداعمة للهيمنة”. هي خاضعة للسيطرة عندما تتحكم السلطة التنفيذية في قرار الاستفتاء وموعده وصياغة المشروع والسؤال، وداعمة للهيمنة، بمعنى أنّ نتائجها تكون لصالح من دعا إليها. فهي “ليست لإقرار أيّ شيء، وإنما لشرعنة أمر واقع”[4]. لذلك فإنّ الاستفتاءات “أداة من أدوات الدكتاتوريّة المتنكّرة”، حسب قيس سعيّد نفسه حين كان خبيرا في القانون الدستوري.
فالاستفتاءات الدستوريّة تهدف في أحيان كثيرة إلى تقوية السلطة التنفيذية، وخصوصا الرؤساء، على حساب البرلمان والقضاء[5]. كما هي عادة محبّذة لدى الرؤساء الشعبويين، الذين يضيقون ذرعا بالسلطات المضادّة. حصل ذلك منذ سنوات قليلة في تركيا، حيث مرّر أردوغان استفتاء دستوريا بغية الانتقال إلى نظام رئاسي والسماح لنفسه بالبقاء في الحكم حتّى 2029، وهو أيضا ما حصل في تونس في التعديل الدستوري لسنة 2002 الذي سمح لبن علي بالترشح لولاية رئاسية رابعة ثمّ خامسة، والذي لم يعارضه حينها خبير القانون الدستوري قيس سعيّد[6]، على عكس أساتذة آخرين. فما يعيبه البعض على دستور 2014، الذي حصر إمكانيّة اللجوء إلى الاستفتاء، سواء الدستوري أو التشريعي، في حالة مصادقة البرلمان على التعديل، ليس تكريسا ل “دكتاتورية الأحزاب”، وإنّما ضمانة ديمقراطية كي لا يقع التلاعب بالإرادة الشعبيّة. إذ نكاد لا نجدُ دولة ديمقراطيّة واحدة تسمح بتعديل دستورها مباشرة عبر الاستفتاء، من دون المرور عبر مجلس منتخب. فتح هذه الإمكانية أمام الرئيس في مشروع دستور سعيّد ليس مكسبا كما يروّج له أنصاره، وإنما على العكس، انتكاسة ديمقراطية.
نكاد لا نجدُ دولة ديمقراطيّة واحدة تسمح بتعديل دستورها مباشرة عبر الاستفتاء
شرط المرور عبر هيئة منتخبة ليس فقط حدّا من الديمقراطية المباشرة لصالح الديمقراطية التمثيلية، وإنّما تكمن أهميّته في فرصة التداول الديمقراطي التي يمنحها، حيث يناقش النصّ وتتقابل وجهات النظر وهو ما يسمح بالوصول إلى نتيجة أكثر مشروعيّة ومقبوليّة. أمّا الاستفتاء، فيحصر في معظم الأحيان العملية الديمقراطية في جواب بنعم أو لا، ويفرغها من جوهرها التداولي، وهذا هو الخطر الثاني. “فالاستفتاء على دستور به 123 أو 180 فصلا… لا يعني أيّ شيء ولا يحقّق الديمقراطية المطلوبة”، على حدّ تعبير قيس سعيّد سنة 2011[7]. بل أنّ التصويت في الاستفتاء يكون في معظم الأحيان ليس على المشروع الموضوع على الاستفتاء، وإنّما على شخص المبادر إليه[8]. قيس سعيّد كان هو نفسه يحذّر من هذا الخطر الذي تحوّل اليوم إلى فرصة.
معظم الاستفتاءات لا تهدف لإقرار أيّ شيء وإنما لشرعنة أمرٍ واقع
الاستفتاء لا يغسل عيب لا ديمقراطية الإعداد
من هنا ندرك أهمّية مرحلة الصياغة أو الإعداد، التي تساوي إن لم تكن تفوق، من وجهة النظر الديمقراطيّة، أهمّية مرحلة الإقرار. واعتماد آلية ديمقراطية في الظاهر للإقرار لا يغسل عيب استفراد طرف واحد بالصياغة. فالإعداد الديمقراطي، أي الذي يمرّ عبر مجلس منتخب وتداول ديمقراطي، هو الذي يضمن أن “يكون الدستور معبّرا بالفعل عن إرادة صاحب السيادة”، دائما حسب سعيّد[9]. فدستور 25 جويلية 2022 هو بذلك أقرب إلى أسلوب “المنح”، حين يمنّ الحاكم بدستور على الرعيّة، على عكس دستور 2014، الذي نتج عن مجلس تأسيسي منتخب، ومخاض مجتمعي شاركت فيه مختلف القوى الحيّة في المجتمع، استطاع أن يفرض تنازلات عديدة على حركة النهضة، وصولا إلى توافق واسع لم يتخلّف عنه سوى بعض نواب أقصى اليمين احتجاجا على عدم التنصيص على الشريعة. فإذا كان التداول الديمقراطي سمح بين 2012 و2014 بمناقشة مستفيضة لمضامين الدستور والتصدّي للفصول الخطيرة وفرض ضمانات ديمقراطية عديدة، فإنّ استفراد رئيس بسلطة التأسيس انعكس أيضا في المضامين، فأنتج دستورا يكرّس حُكم الفرد، ويجعل الرئيس فوق الجميع، يحكمُ ولا يحاسبُ، ولو أتى خرقا جسيما للدستور.
هل تجوز المقارنة مع الجمهورية الخامسة الفرنسيّة؟
يبقى أنّ المدافعين عن المسار الحالي يستشهدون بمثال الجمهورية الخامسة الفرنسيّة، التي قامت على أنقاض عدم استقرار النظام البرلماني في الجمهورية الرابعة، والتي كتبت دستورها لجنةٌ بإشراف رئيس مجلس الوزراء آنذاك شارل ديغول، قبل أن يقرّه الشعب عبر الاستفتاء. ليس المجال هنا مناسبا للعودة إلى أسباب سقوط الجمهورية الرابعة، والراجعة على الأخصّ إلى السياسة وليس إلى القانون الدستوري، وأبرزها معضلة الجزائر وموقف الجيش منها، من جهة، وعدم استيعابها أكبر قوتين سياسيّتين حينها وهما أتباع ديغول والشيوعيين. لكنّ ما يهمّنا هو أنّ المرور إلى الجمهورية الخامسة جاء بتفويض برلمانيّ، عبر القانون الدستوري المؤرخ في 3 جوان 1958، الذي حدّد ضوابط مضمونية لا يمكن الخروج منها، كالفصل بين السلط ومبدأ مسؤولية الحكومة أمام البرلمان. أي أنّ الصياغة، وإن تولتها لجنة أشرف عليها ديغول، فإنّها خضعت إلى حدود واضحة وضعها البرلمان، وهي التي أنتجت التوليفة الفرنسيّة التي تصنّف ضمن الأنظمة البرلمانية المعقلنة (parlementarisme rationalisé).
حتى استفتاء 1962 الذي فرض به ديغول الانتخاب العامّ والمباشر لرئيس الجمهورية، والذي وصفه معارضوه بالانقلاب الدائم الذي أرسى “ملكيّة رئاسيّة”، فإنّه لا يقارن بحالة الاستفراد بالسلطة ووضع دستور جديد لا يعبّر سوى على إرادة صاحبه ويضع أسس حكم الفرد. فإذا كانت للمجتمع الفرنسي قوى سياسيّة وتقاليد ديمقراطية سمحت بالحفاظ على حدّ أدنى من التوازن، فإنّ من شأن تغيير النظام الدستوري في تونس بالشكل الذي يريده سعيّد باسم الاستجابة إلى روح الثورة، أن يعيدنا إلى ما قبلها، بل وقد يعيدنا، على عكس النموذج الذي يحنّ إليه بعض أنصار النظام الرئاسي، إلى ما قبل الدولة الوطنيّة.
لو كان هدف سعيّد هو فعلا الوصول إلى دستور يعبّر عن الإرادة الشعبيّة، لكان دعا لانتخاب مجلس تأسيسي، أو حتّى لتكوين مجلس من مواطنين عبر القرعة كما حصل في إيسلندا، لصياغة دستور جديد. فحتى فوجيموري، رئيس البيرو الأسبق الذي استعمل الحالة الاستثنائية للتخلص من كلّ السلط المضادة وتغيير الدستور، مرّ عبر انتخابات تأسيسيّة. بل أنّ مشروع البناء القاعدي الذي يحمله سعيّد منذ السنوات الأولى للثورة، صيغ هو ذاته كطريقة لانتخاب مجلس تأسيسي. لكنّ سعيّد يريد فرض دستوره هو، وهو بذلك يسقط في منطق “الوصاية على الشعب” التي طالما عابها على النخب الحاكمة.
“عرس (لا)ديمقراطي” يعود بنا عقدين إلى الوراء
إذا كان الاستفتاء، نظريا، لا يضمن الديمقراطيّة، فإن استفتاء 25 جويلية هو أبعد ما يكون عنها. ليس فقط لأنّ الهدف منه هو شرعنة أمر واقع ومشروع شخصي لرئيسٍ أقسمَ على احترام دستور 2014 ثم انقلب عليه، وإنما أيضا لأنّ الشروط الديمقراطيّة للاقتراع لا تتوفّر. فالثقة في مصداقيّة الجهة المنظّمة ضعيفة جدّا، بعد أن عوّض سعيّد الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بهيئة جديدة عيّن أعضائها. ولعلّ حصيلة الأشهر الأولى من عمل الهيئة تعطي مؤشرات جدّية على عدم استقلاليتها. من ذلك قبولها منذ البداية بموعد 25 جويلية الذي حدّده الرئيس وعدم مساءلته رغم إقرارها بصعوبة المهمّة. أو حفاظها على الموعد رغم تقدّم الرئيس في 8 جويلية بنسخة جديدة لنصّ مشروع الدستور، تضمّنت تعديلات مضمونيّة كان يفترض أن يعاد معها احتساب الآجال وبالتالي تأجيل الاستفتاء، واكتفاؤها بفتح المجال للمشاركين في الحملة لتغيير رأيهم. أو اعتمادها مذكّرته التفسيريّة للدستور رغم ورودها بعد فوات الآجال وانحرافها عن وظيفة التفسير في اتجاه الدعاية التي بلغت حدّ المغالطة في المضامين. أو قبولها فتح مكاتب الاقتراع من السادسة صباحا إلى العاشرة مساء، وهو ما لم يكن أبدا معهودا خلال الاستحقاقات السابقة ولا في الديمقراطيات المقارنة، والذي من شأنه فتح الباب أمام التزوير، إذ يستحيل توفير مراقبين في كلّ مكاتب الاقتراع لمدّة 16 ساعة كاملة. نحن إذن أمام هيئة “مطيعة“، خاضعة تماما لإرادة الرئيس. رئيسٌ اختار أن لا يضع حدّا أدنى للمشاركة، مرّة أخرى على عكس تصريحاته السابقة، لأنّ هدفه هو تمرير المشروع مهما كان الثمن. رئيسٌ يستعمل موقعه وأجهزة الدولة للترويج لمشروعه، من تدشين إنجازات لا أثر لها في الواقع إلى صرف جرايات التقاعد قبل موعدها. رئيسٌ لا يحتكر فقط وضع قواعد الاقتراع وتغييرها حسب مشيئته، وإنما لا يكلّف نفسه عناء احترامها، في غياب أيّ رادع أو حسيب.
لا يقتصر غياب الشروط الديمقراطية على الهيئة المشرفة على الاقتراع، وإنما يشمل بقيّة المتدخّلين في المنظومة الانتخابيّة، وأبرزهم القضاء والإعلام. إذ يأتي الاستفتاء في سياق نسفِ ما تبقى من استقلالية القضاء، بعد عزل الرئيس 57 قاضيا جلّهم لم تتعلق بهم ملفات تأديبيّة، ومنهم من كان ذنبه الوحيد عدم تطبيق تعليمات السلطة التنفيذية، من دون منحهم حقوق الدفاع ولا فرصة الطعن في القرار. فكيف يمكن أن نثق بعد ذلك في القضاء في النزاعات الانتخابيّة؟ أمّا الإعلام، فيخضع إلى ضغوطات عديدة كي لا يفسح المجال للمعارضين والمقاطعين، والشهادات في هذا المجال تكاد تكون يوميّة. كما يتمّ التضييق على المعارضين لمنعهم من تنظيم اجتماعات في الجهات، وصولا إلى قرار والي تونس منع المظاهرة التي كان الحزب الدستوري الحرّ يعتزم تنظيمها قبل يومين من الاستفتاء. نحن إذن إزاء حملة فولكلورية، لا يسمع فيها سوى صوت “النعم”، تذكّر بالاستفتاء الدستوري الذي أجراه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي سنة 2002 لكي يفتح لنفسه باب الترشح مجدّدا لرئاسة الدولة.
إذا كان الاستفتاء، نظريا، لا يعني الديمقراطية، فإنّ استفتاء سعيّد يثبت يوميّا في اختبار الواقع، أنه “أداة من أدوات الدكتاتورية المتنكرة”. فهو لا يهدف إلى إعطاء الكلمة للشعب كي يمارس سيادته، وإنما لشرعنة أمر واقع مفروض بقوة السلطة، وإسباغ دستور الحكم الفردي بطلاء ديمقراطي باهت لن يتأخر عن الانقشاع. لينكشف حينها الوجه القبيح للبناء التسلطي، حتى على الّذين لا يزالون، إلى اليوم، يكابرون ويصرّون على عدم رؤيته.
نحن إزاء حملة فولكلورية، لا يسمع فيها سوى صوت “النعم”
نشر هذا المقال في العدد 25من مجلة المفكرة القانونية – تونس. لقراء مقالات العدد اضغطوا على الرابط ادناه
جمهوريّة الفرد أو اللاجمهوريّة
[1] Laurence Morel, “Référendum et volonté populaire : la critique démocratique du référendum”, in Participations, 2018/1, pp. 53-84.
[2] Pierre Rosanvallon, Le siècle du populisme, op. cit. , p. 210.
[3] Stephen Tierney, Constitutional referendums: the theory and practise of republican deliberation, Oxford university press, 2012, p. 23.
[4] David Butler, “The world experience”, in Austin Ranney (ed.), The Referendum Device: A conference, Americain Entreprise Institute, 1981.
[5] Zachary Elkins & Alexander Hudson, “The constitutional referendum in historical perspective”, in David Landau & Hanna Lerner (ed.), Comparative constitution making, Edward Elgar, 2019, p. 145.
[6] جريدة الصباح، 4 ديسمبر 2001.
[7] مع الأستاذ قيس سعيّد أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية، ورد في عبد الجليل التميمي (إش.)، مرصد الثورة التونسية، الجزء الأول، ص. 245.
[8] Laurence Morel, “The democratic criticism of referendum”, in Morel & Qvortup, The Routledge handbook to referendums and direct democracy, op. cit., p. 159.
[9] مع الأستاذ قيس سعيّد، سبق ذكره، ص. 245.