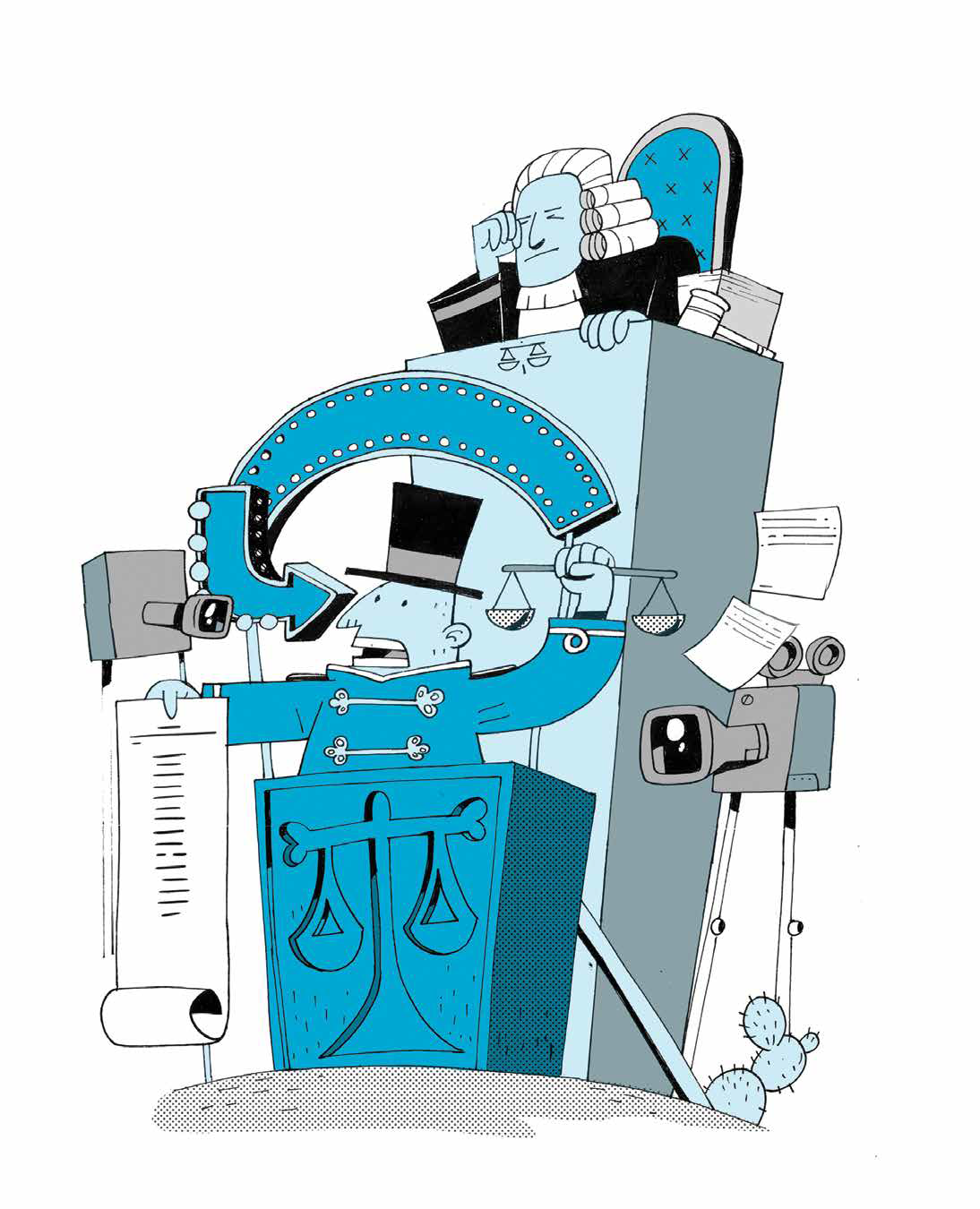“
في أعقاب ثورة الياسمين، برز مفهوم العدالة الانتقالية في تونس بشكل لافت. وقد أدى بروز هذا المفهوم إلى إنشاء هيئة الحقيقة والكرامة وإلى تكريسه في الدستور الجديد (2014). بالمقابل، بقي مفهوم “الذاكرة” كمفهوم فلسفي وسوسيولوجي والاشكاليات التي تحيط به هامشيا[1]. فلماذا نتذكر؟ لحاجات تتصل بإنصاف الضحايا أو بمحاسبة الذين أفلتوا من العقاب؟ لتعزيز الوعي العام إزاء بشاعة انتهاك حقوق الإنسان؟ لتركيز ذاكرة وطنية جامعة تكون بمثابة مناعة إزاء تكرار جرائم الماضي، ومدخل لبناء مستقبل أكثر إنصافا؟ وبكلام آخر، ما هي الذاكرة التي نأمل من أعمال هيئة الحقيقة والكرامة تركيزها في الوجدان التونسي؟
هذا السؤال أصبح أكثر إلحاحا بعدما انحصر مسار العدالة الانتقالية في الدوائر المتخصصة للنظر في القضايا المحالة إليها من هيئة الحقيقة والكرامة. فبذلك، أصبحت المحاكمات “المخاض” الذي ينتظر أن تنصهر فيه ذاكرة التونسيين بشأن ماضيهم ما قبل 2011. فالذاكرة هي بالنسبة إلى كل منا كهف كبير تتكدس فيه الأحداث وفهمنا المحدود بطبيعته أو المُوجّه لها، ليعود كل منا بنتيجة تجاربه أو معارفه أو حساسيته أو التفاعلات لا الواعية لديه، إلى إبراز بعض منها وطمس بعضها الآخر. وعليه، يشكل “عمل التذكّر” إعادة زيارة لهذه الكهوف الجاثمة في وجدان كل منا، بحيث تعود بعض المعطيات المكدسة فيها (وقد تكون بارزة أو مطموسة) إلى الواجهة ليعاد التحقيق والتفكّر بشأنها تمهيدا لإبرازها في حلتها الجديدة. ومن هذه الوجهة، يتبدى عمل التذكر على أنه ليس بالضرورة استعادة لذاكرة مفقودة أو مطموسة، بل قبل كل شيء إثارة اضطراب ضميري تفاعلي بشأنها، تمهيدا لإعادة تكوين الأحداث العالقة سابقا في أذهان التونسيين بدرجة أو بأخرى وإعادة ترتيبها من حيث حضورها. ولعل أهم ما في عمل التذكر هو إخراج القضايا من طابعها الشخصي البحت، في اتجاه فهم خلفيات العوامل الإنسانية والاجتماعية وأبعادها، سواء منها ما يتصل بوجع الضحايا ومعاناتهم أو ما يتصل بجشع المرتكبين (أو الجلادين) واستبدادهم.
والتذكر لا ينطبق فقط على الأجيال التي عايشت الأحداث، إنما أيضا على الأجيال اللاحقة التي تتكون لديها بنتيجة ذلك تصورات بشأن ماضي تونس. ومن الطبيعي أن ينبني عمل التذكر هذا على خيارات معينة، إذ يستحيل أن يقوم أي مجتمع بمراجعة شاملة لمجمل الأحداث المتراكمة في ماضيه. وهذا ما يتبدى بشكل واضح في عمل هيئة الحقيقة والكرامة. ففيما بلغت عدد الشكايات 62713 شكاية وتناولت السماعات السرية 49654 من الضحايا المشتكين[2]، اقتصرت السماعات العلنية على عدد محدود منها، ليتدنى عدد القضايا المحالة حتى آخر يوليوز 2018 إلى الدوائر المتخصصة إلى 19 قضية فقط (ارتفع العدد فيما بعد قليلا). وكانت الهيئة اكتفت في غالبية القضايا بالإستماع إلى الضحايا، فيما انحصرت الأبحاث والتحقيقات في عدد جدّ محدود منها.
فما هي القضايا التي قررت هيئة الحقيقة والكرامة إحالتها إلى الدوائر المتخصصة؟ يتلازم هذا السؤال، مع حصر عمل التذكر في القضايا المعروضة أمام الدوائر المتخصصة، بأسئلة أخرى لا تقل أهمية وتتمحور حول هدف التذكر والمعايير المعتمدة منها في اختيار هذه القضايا لتحقيقه. فما هو الهدف؟ ما هي هذه المعايير؟ وما هي مدى ملاءمتها في تحقيق الهدف المرجوة من عمل التذكر؟ وبمراجعة معايير الهيئة المعلنة وماهية القضايا المحالة[3]، نلحظ أنها لم تنبنِ على معايير حقوقية (مفهوم الجرائم الأكثر خطورة مثلا)، بل بالدرجة الأولى، على توازنات معينة بين مختلف الانتماءات والمناطق الجغرافية والحقبات التاريخية ومختلف الانتهاكات. وعدا عن أن التدقيق في ماهية القضايا المحالة يظهر إخلالا في هذه التوازنات، فإن الهيئة بدت وكأنها بنت خياراتها قبل كل شيء على النمْذجة والتمثيلية (بناء عينة تمثيلية للقضايا وفق نسب حصولها). وقد ترافقت هذه النمذجة مع إعطاء الأولوية للملفات التي تحتوي على قرائن وإثباتات، على نحو يخفف من احتمال انتهاء التحقيق في هذه القضايا إلى طريق مسدود أو مخيب للآمال.
وفيما بالإمكان تبرير النمذجة بإرادة إشراك العدد الأكبر من المناطق والتيارات في هذا العمل، فإن خطورة اعتمادها تكمن في حبس الضحية بهويتها الحزبية أو المناطقية مما يحول دون نشوء هوية “للضحية” بحد ذاتها. وعليه، تصبح قضية الضحية المنتمية إلى فئة معينة بابا لإنصاف هذه الفئة (وربما تعزيز مشروعيتها). وقد يؤدي ذلك إلى إعادة إنتاج الذاكرة الفئوية والمتعددة، أكثر من أن يؤدي لتعزيز الوعي حول الاعتبارات الإنسانية والوطنية الجامعة المتصلة بهذه الانتهاكات وصولا إلى ذاكرة وطنية جامعة. ومن شأن توجه مماثل أن يؤدي إلى منزلقات عدة، أبرزها الآتية:
- إشعار الضحايا الذين لم تسلك ملفاتهم طريقها إلى المحاكمة بحصول تمييز ضدهم، وتاليا بتحول مسار العدالة الانتقالية إلى مناسبة جديدة لانتهاك حقوقهم. فالنمذجة (بناء عينة تمثيلية) مفيدة ربما بيداغوجيا أو علميا، ولكنها قد تصطدم بأسس العمل الحقوقي حيث يقتضي أن يكون كل اختلاف في الوضعية مبررا باعتبارات الصالح العام، خارج حالات التمييز على أساس الصفات الملازمة للأشخاص. ولا يخفف من ذلك ادعاء الهيئة بأنها استبعدت الملفات التي لا يوجد فيها أدلة أو اثباتات كافية. فعدا عن أنه من البدهي عدم جواز تحميل الضحية أي عبء لتوفير الإثبات في أي عمل تذكّر جدي[4]، فإن ثمة أسئلة ملحة حول مدى جدية وسائل الاستقصاء التي نجحت الهيئة في توفيرها للتحقيق في الشكايات المقدمة إليها. فألا يشكل عدم توفر أي إثبات في ملف معين في الكثير من الأحيان دليلا إضافيا على حجم الطمس الذي طال الانتهاك الحاصل بحق الضحية وتاليا خطورته؟ وخير دليل على ذلك هو اشتراك جمعيات ممثلة لضحايا الحقبة الاستبدادية في تنظيم حملة تحت مسمى “ملفي آش صار فيه”، هدفها تسليط الضوء على تقصير الهيئة في التعاطي مع ملفات الضحايا.
- تعزيز خطر انزلاق عمل التذكر إلى عمل فئوي من حيث التصورات المحيطة به.وهذا ما قد يتحصل في حالأدى عمل الهيئة ومن بعدها الدوائر عن قصد أو غير قصد، بفعلها أو بفعل عوامل خارجة عنها، إلى إبراز الهوية الفئوية للضحية على حساب هويتها ك “ضحية”. ففي هذه الحالة، قد تؤدي النمذجة إلى تقسيم عمل التذكر وتجزئته، بحيث تصبح كل فئة مهتمة بالقضايا التي تخصّها وبالمعاناة التي تعرّض لها أتباعها من دون أن تعير أي انتباه للقضايا الأخرى. ولا يُستبعد أن تلجأ بعض الفئات السياسية إلى تحويل ضحاياها إلى أيقونات شهداء تشهرها في صلب مشروعها السياسي. وما يزيد المخاوف في هذا المضمار هو أن ما يقارب ثلثي القضايا المحالة حتى نهاية يوليوز تخص إسلاميين، الأمر الذي يخشى معه نشوء شعور عامّ بتحوّل التذكر والعدالة الانتقالية بالدرجة الأولى إلى مناسبة لرفع شأن هؤلاء وتعزيز مشروعيتهم.
- الأخطر ربما، هو إفساح المجال أمام خطاب حقوقي قد يقوده المحامون أمام دوائر العدالة الانتقالية، بشأن انتقائية الملاحقة الحاصلة ضد موكليهم. فلماذا هذه القضايا بالذات؟ هل يصح اختزال محاسبة جرائم النظام بملاحقة عدد قليل منها؟ وألا يشكل ذلك تجاوزا لمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء؟ وبالطبع، قد تكتسي هذه الحجة قوة سياسية فائقة في حال نجح هؤلاء المحامون في صبغ الانتقائية بصباغ الانحياز لفئة ضد فئة (كأن يرون أن ثمة انحيازا للإسلاميين في اختيار القضايا ضد الحداثيين مثلا). وما يعزز هذا الاحتمال هو أن أغلب الحالات تعلقت بجرائم سبق إجراء محاكمات فيها ولم تقدم الهيئة اي أدلة جديدة بشأنها إنما اكتفت بالمنازعة في تناسب العقوبة مع خطورتها. بمعنى أن الهيئة حيّدت من أفلت من العقاب تماما بحجة النقص في الإثبات، فيما تمسكت بإعادة محاكمة الذي أدينوا للمطالبة بتشديد عقوباتهم.
بالطبع، لا نقصد بحال من الأحوال أنه يقتضي أن يكون عمل التذكر شاملا، بالنظر إلى استحالة استعادة مجمل الانتهاكات الحاصلة خلال عقود. ولا نقصد أن بإمكان العدالة الانتقالية أن تؤدي دوما إلى تجاوز تهديد التحول إلى عمل فئوي، وخاصة في ظل حدة الانقسامات الاجتماعية. لكن ما نقصده هو أن تعزيز حظوظ نجاح التذكر يفرض اتخاذ أعلى تدابير الحيطة لتبرير كيفية انتقاء الملفات، على نحو يبدد أي شكوك جدية بارتكازها إلى اعتبارات فئوية أو سياسية. ولعل المدخل الأساسي لذلك هو اعتماد معايير حقوقية واضحة، ترتكز على مدى خطورة الانتهاك والمسؤولية الجرمية، على أن تزيد خطورة الانتهاك بقدر أهمية القيم التي وقع انتهاكها. هذا ما نتبينه مثلا في نظام محكمة روما للعدالة الجنائية الدولية حيث شمل اختصاصها الجرائم الأكثر خطورة (جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية) حصرا، على أساس أنه ليس بإمكان المحاكم الدولية بفعل كلفتها أن تتصدى إلا لعدد محدود من الجرائم، وهي الجرائم الأخطر من وجهة نظر أممية. وهذا ما نتبينه في صلاحيات عدد من المحاكم الدولية الخاصة (كمبوديا، يوغوسلافيا السابقة، …).
وعليه، كان من المنتظر من الهيئة، تعزيزا لحظوظ نجاح مسار العدالة الانتقالية، أن ترفق إحالة الملفات بتقرير معمق يشرح خياراتها بشكل واضح بمنأى عن أي نمذجة، تقرير من شأنه أن يثبت لماذا ميزت الهيئة هذه الجرائم عن سواها، وما هي القيم الخطيرة التي تم انتهاكها بفعلها، وبكلمة أخرى القيم التي يعتبر المس بها جرما لا يغتفر رغم انقضاء سنوات أو ربما عقود عليها؟كما ينتظر منها أن تعمل جاهدة لبناء هوية الضحية بمعزل عن أي انتماء سياسي أو مناطقي أو طبقي لها، وذلك حماية للتذكر إزاء أي مسعى لزجه في متاهة السياسة والمصالح.
وانطلاقا من ذلك، وفيما جاز انتقاد الهيئة لإعراضها عن اتخاذ تدابير كافية وواضحة لحماية منجزها في تذكر الماضي، فإن مخاطر إخفاق هذه العدالة والتشويش عليها قد تعززت مؤخرا بنتيجة عوامل خارجة عنها.وهذا ما يتأتى عن بروز خطاب آخر حول الرؤى الإصلاحية للمستقبل، بدفع من رئيس الجمهورية باجي قائد السبسي، والذي تزامن زخمه مع إحالة الملفات إلى الدوائر المتخصصة. وكما أن الهيئة لم تسند اختيار الملفات المختارة منها على “معايير الخطورة”، فإن السبسي جعل العمل على الحريات الفردية والقيم الليبرالية أولوية “حداثية” أراد تتويج بها رئاسته، من دون أن يشرح الأسباب أو الأوضاع الاجتماعية التي قادته إلى اعتبارها كذلك. فمن دون التقليل من أهمية بعض عناوين الحريات الفردية المتصلة بكرامة آلاف المواطنين (مثلا: إلغاء تجريم المثلية – )، فإن الكثير من العناوين الأخرى تبقى قابلة لنقاش جدي حول طابعها الملحّ ومن غير الحكيم سياسيا بحال من الأحوال إعطاؤها نفس الزخم الواجب لمعالجة العناوين الملحة، أو حتى وضعها في سلة واحدة معها.
وما يزيد من خطورة الأمر، هو أن السبسي كان حصر مبادرته في بدء انطلاقتها في مسألة ضمان المساواة في التوريث بين الجنسين. وقد ظهر وضع هذه المسألة في الواجهة بالنسبة إلى كثيرين وكأنه مجرد مسعى منه إلى إعادة تظهير تمايزه كقوة حداثية بعدما كادت النهضة تلغي هذا التمايز من خلال اجتهادها في تطوير خطابها الحقوقي؛ فكان لا بد إذا لإماطة اللثام عن إسلاميتها المتجذرة من وضعها أمام استحقاق (مأزق) الاختيار بين التزامها بنص قرآني والتزامها بمبدأ المساواة بين الجنسين.
وهذا ما تردد صداه بقوة في خطاب 13 أوت 2018، حيث تجاهل السبسي مجمل النقاط التي وافقت عليها حركة النهضة على صعيد ضمان الحقوق الفردية (وبعضها مهم جدا ويشكل مكسبا حقيقيا لتونس)، ليعيد إبراز بند واحد أوحد هو البند الأكثر إحراجا للنهضة بفعل اصطدامه بنص قرآني.
من هذه الوجهة، وبمعزل عن حقيقة نوايا رئيس الجمهورية أو ما قد يصنعه حقوقيو تونس أو المنطقة العربية من التقرير، فإن توجه السبسي في تحديد أولويات المستقبل بدا لأي مراقب معقول تكتيكا سياسيا في منطلقه وأهدافه، فيما بدت الاعتبارات الحقوقية مجرد مطية أو أداة في سياق اللجوء إلى هذا التكتيك. فكأن المراد ليس إنجاز الإصلاح الحقوقي، بل شدّ عصب الحداثيين تثبيتا لمرجعية ممثليهم السياسية في مواجهة الإسلاميين وفي مقدمتهم النهضة والذين يتم تظهيرهم مجددا على غرار ما كان يحصل في فترة الاستبداد، على أنهم العائق الأكبر أمام لحاق تونس بركب الحداثة. فبخلاف مسعى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبه إلى صياغة مقترحاته بشأن مجلة الأحوال الشخصية على نحو يجعلها متوائمة مع الإسلام تحقيقا لوفاق وطني حولها، فإن السبسي سعى على العكس من ذلك تماما إلى تظهير تمايز مقترحاته إمعانا في إحراج النهضة، وبما يعسّر امكانية الوصول إلى أي وفاق بشأنها.
وعليه، وبمعزل عن النوايا أو المقاصد، بدت خيارات التذكر كما الإصلاح، أمام منزلق التحول إلى خيارات فئوية، بمعنى أنها تعني فئات من المجتمع دون الأخرى وأنها تعزز الهويات الفئوية أكثر مما تتعزز الوعي التوحيدي الجامع. فكأنما أولويات التذكر تتمحور حول قمع الإسلاميين باسم الحداثة، فيما أولويات الإصلاح تتمحور حول تطلعات الحداثيين في مواجهة الإيديولوجيات الإسلامية. وعليه، وبدل أن يكون الهدف من التذكر جزءا لا يتجزأ من عملية بناء الغد، فإن الأمور تتجه بفعل كل ما تقدم في اتجاه معاكس تماما، أي في اتجاه استيلاد التناقض بين تذكر الماضي وتطلعات المستقبل. فمن شأن الانقسام الاجتماعي الحاد حول تطلعات المستقبل أن يعيد إلى الواجهة مخاطر الإيديولوجيا الإسلامية، وأن يعزز بالتالي الانقسام الاجتماعي بشأن الماضي. فيظهر المجتمع منقسما ومشوشا في مقاربة ماضيه كما في مقاربة مستقبله. فتخرج الذاكرة مشوشة وتتضاءل امكانيات الإصلاح.
- نشر هذا المقال في العدد | 12 | أغسطس 2018، من مجلة المفكرة القانونية | تونس |. لقراءة العدد انقر/ي على الرابط ادناه:
العدالة المشوّشة بصراع الإيديولوجيات: ذاكرة فئوية لغد فئوي؟
- للإطلاع على النص مترجما الى اللغة الإنكليزية يمكنك/ي الضغط هنا
[1] يحدد الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية ” حفظ الذاكرة الجماعية وتوثيقها ” كأحد أهداف مسارات العدالة الانتقالية . ويفرض الفصل الخامس من هذا القانون أن يتم حفظ الذاكرة الوطنية على اعتبار أن ذلك “حق لكل الأجيال المتعاقبة من التونسيات والتونسيين وهو واجب تتحمله الدولة وكل المؤسسات التابعة لها أو تحت إشرافها لاستخلاص العبر وتخليد ذكرى الضحايا.” وتولت هيئة الحقيقة والكرامة بمقتضى نظامها الداخلي تخصيص إحدى لجانها بمهمة ” حفظ الذاكرة الوطنية ” لكن يلاحظ هنا ان مجهود تلك اللجنة ومن خلفها كل الهيئة في المجال ظل محدودا يفتقر لمقاربة واضحة ذات أبعاد مؤسساتية
[2] يلحظ أن الهيئة اعتدت عند إحصاء الشكايات والضحايا معيار الضحية المباشرة وغير المباشرة. وعليه، في حال وفاة مسترابة تحت التعذيب، سجل عدد من أعضاء العائلة كضحايا غير مباشرين واحتسبت شكاياتهم كشكايات مستقلة ضمن المجموع العام للشكايات.
[3] يراجع مقال عفاف النحالي، ملفات المحاسبة القضائية: قراءة من الخارج، منشور في هذا العدد.
[4] في محاولة منها للتملص من ضغط الضحايا اصدرت هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 06-08-2018 بيانا يدعو من سمتهم أصحاب ملفات غير مؤيدة لتقديم إثباتاتهم ومؤيداتهم في أجل أقصاه 14-08-2018 لكي لا تكون مضطرة لحفظها.
“